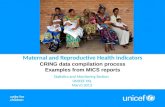Compilation of the research reports finmal 0
-
Upload
issam-bencheikh -
Category
Law
-
view
71 -
download
16
Transcript of Compilation of the research reports finmal 0
1 جتـميع التقارير الواردة من مشاريع بحثيةمتعددة القطاعات يف جمال حقوق اإلنسان )2(
االفتتاحية
انطالقا من اإليمان بأهمية توفير المصادر والبحوث في مجال حقوق االنسان باللغة العربية، يسرني نيابة عن معهد راؤول والينبرغ راؤول والينبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، أن أقدم اإلصدار الثاني من الكتيب الذي يشمل تجميعا لخمسة
تقارير بحثية في مجال حقوق اإلنسان، نفذها باحثون من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
مع خالص تقديرنا لكل عضو من أعضاء الفرق البحثية الخمسة لجهودهم المبذولة وتفانيهم الذي مكننا من نشر هذا الكتيب.
كما يود المعهد أن يعبر عن امتنانه لكافة األفراد الذين قاموا بمراجعة وتدقيق النصوص األصلية، ووضع اللمسات النهائية على الكتيب.
وأود أن أشير إلى أن هذا المشروع وإنتاج هذا الكتيب لم يكن ممكنا بدون الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(، من خالل دعمها المالي للبرنامج اإلقليمي " إرساء دعائم المعرفة بحقوق اإلنسان ومصادرها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا".
نضع بين أيدكم هذا الكتيب، آملين االستفادة من المواد التي طرحت والتحليالت الواردة فيها.
ماري توما مديرة معهد راؤول والينبرغ
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
3 جتـميع التقارير الواردة من مشاريع بحثيةمتعددة القطاعات يف جمال حقوق اإلنسان )2(
املقــــدمة
ضمن البرنامج اإلقليمي لمعهد راؤول والينبرغ لحقوق اإلنسان والقانون االنساني " إرساء دعائم المعرفة بحقوق االنسان ومصادرها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" تم اإلعالن للعام الثاني على التوالي عن توفير منح بحثية في مجال حقوق
اإلنسان في شهر كانون ثاني، يناير 2012.
وقد قدمت خمس منح هدفت إلعداد وتقديم مشروع بحثي في مجال حقوق اإلنسان ذات األهمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
تألف كل فريق بحثي من ثالثة أشخاص، على األقل، ممثلين عن اثنين أو أكثر من القطاعات األربعة التالية:
الحكومية والمؤسسات اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسات الحكومية؛ غير المنظمات األكاديمية؛ والمؤسسات الجهات األخرى. وقد تميز الكتيب لهذا العام باحتوءه على ثالث تقارير مشتركة تغطي عددا من البلدان العربية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
تم تنفيذ المشاريع البحثية خالل ربيع وصيف العام 2012 ، وجرى عرض النتائج ومناقشتها خالل مؤتمر إقليمي عقد في عمان، األردن في أيلول/ سبتمبر 2012.
وتم إيراد التقارير البحثية في هذا الكتيب على الشكل التالي:
المشاركة السياسية للمرأة في الدول المغاربية مقترحات االنسان لحقوق الدولية الشرعة مع التوافق مدى الفلسطيني: الدستور مسودة في االنسان حقوق
للتطويرالمواطنة من منظورحقوق االنسان في مناهج التربية الوطنية في األقطار العربية.
دراسة حالة لكل من األردن; ومصر ; ولبنان.دراسة حول: جدلية حقوق االنسان في قانون االنتخاب اللبناني. دراسة حول وضع السياسات المتعلقة باإلعاقة ومدى االلتزام بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في
كل من: مصر؛ ولبنان؛ وتونس؛ واألردن.
5 جتـميع التقارير الواردة من مشاريع بحثيةمتعددة القطاعات يف جمال حقوق اإلنسان )2(
الئحة احملتويات
رقم الصفحة اسم البحث
7المشاركة السياسية للمرأة في الدول المغاربية
دة الدستور الفلسطيني: حقوق اإلنسان في مسومدى التوافق مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ومقترحات للتطوير
43
المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مناهج التربية الوطنية في األقطار العربية69دراسة حالة لكل من األردن؛ ومصر؛ ولبنان
دراسة حول:107جدلية حقوق اإلنسان في قانون االنتخاب اللبناني
دراسة حول:وضع السياسات المتعلقة باإلعاقة ومــدى االلتـــزام بتنفـــيذ
اتفاقيــــــة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة133
املشاركة السياسية للمرأةيف الدول املغاربية
دراسة حالة الجزائر؛ وتونس؛ والمغرب
رئيس الفريق البحثي د. بوحنية قوي – باحث في العلوم السياسية، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة
الجزائرأعضاء الفريق1 – عصام بن الشيخ – أستاذ مساعد 2 إسماعين لعبادي – أستاذ مساعد
مشاركات في البحث- لعبادي كريمة محامية، وعضو في منظمة العفو الدولية- بلبصير سناء ناشطة حقوقية
9 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
الئحة احملتويات
رقم الصفحة
11تمهيد
16المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: دراسة ألوضاع المرأة الجزائرية خالل نصف قرن: 1962 – 2012
16أ ــ الحقوق الدستورية والسياسية للمرأة الجزائريةب ـ التصويت النسوي في الجزائر بعد االستقالل:
18 مقارنة بين مرحلتي الواحدية والتعددية السياسيةج ــ اعتماد مقاربة الجندر ومنع التمييز ضد المرأة:
19 تجاوز التحفظات وتطوير الميكانيزمات التنفيذية لترقية أوضاع المرأة20د ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية
هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومراكز صنع القرار21 مسؤولية األحزاب في ضعف التمثيل النسوي، وعدم القدرة على تفعيل المواطنة والديمقراطية التشاركية
و ــ اإلصالحات االنتخابية نيسان/ أبريل 2011 وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس االنتخابية22 جدل تطبيق »الكوتا« في الجزائر على المستوى المحلي... اإلشكالية الديموغرافية والحسابات االنتخابية
المشاركة السياسية للمرأة المغربية دراسة ألوضاع المرأة المغربية خالل ستة عقود: 1956 - 2012
23
23أ ــ الحقوق الدستورية والسياسية للمرأة المغربيةب ــ التصويت النسوي في المغرب بعد االستقالل: 25 مقارنة بين مرحلتي الواحدية والتعددية السياسيةج ــ اعتماد مقاربة الجندر ومنع التمييز ضد المرأة:
تجاوز التحفظات وتطوير الميكانيزمات التنفيذية لترقية أوضاع المرأة المغربية25
د ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة المغربية دراسة للنظام االنتخابي، القدرة على التشريع البرلماني، التعويض على عدم المساواة بـ »الكوتا«.
26
هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة المغربية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومراكز صنع القرار مسؤولية األحزاب في ضعف التمثيل النسوي، وعدم القدرة على تفعيل المواطنة والديمقراطية التشاركية
26
27و ــ المشاركة السياسية للمرأة المغربية بعد اإلصالحات الملكية 2011
المشاركة السياسية للمرأة التونسية دراسة ألوضاع المرأة التونسية خالل ستة عقود: 1956 - 2012
28
أ ــ الحقوق الدستورية والسياسية للمرأة التونسيةب ــ التصويت النسوي في تونس بعد االستقالل:
مقارنة بين ممارسات مرحلة الواحدية »البورقيبية«، وإصالحات التعددية السياسية
2828
ج ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة التونسية دراسة للنظام االنتخابي، القدرة على التشريع البرلماني، التعويض على عدم المساواة بـ »الكوتا«.
28
د ــ المشاركة السياسية للمرأة التونسية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومركز صنع القرارمسؤولية األحزاب في ضعف التمثيل النسوي، وعدم القدرة على تفعيل المواطنة والديمقراطية التشاركية
28
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية10
هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة التونسية بعد ثورة يناير 2011هان على دولة »الحق والقانون«، وتعزيز الحريات... الر
30
32مستقبل النضال النسوي المغاربي في عهد الربيع العربي33مقارنة المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في الدول المغاربية الثالث
36الخاتمة38الملخص التنفيذي للدراسة
40المرفقات
11 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
متهيد
واالقتصادية السياسية التفاعالت من نسق ظل في عقود، ستة مدى على المغاربية للمرأة السياسية المشاركة تطورت واالجتماعية، التي فرضتها التحوالت السياسية الداخلية والخارجية التي عرفتها الدول المغاربية، فقد تطور النضال النسوي المغاربي على الصعيد الداخلي، في سياق مقتضيات وتبعات االنتقال الديمقراطي من حكم الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، وتأثر أيضا بتحول مفاهيم حقوق اإلنسان وتطبيقاتها على الصعيد الخارجي، بعد انتهاء الحرب الباردة، وولوج عصر العولمة، فأضحت قضايا المرأة المغاربية، محط اهتمام ومساءلة داخلية وخارجية، بل ومؤشرا للداللة على ديمقراطية وحكامة النظم الجنسين«، بين مبدأ »المساواة تحقيق المرأة، من خالل لترقية أوضاع الدولية بالجهود التحقت التي المغاربية، السياسية باعتبارها من أهم أسس احترام حقوق المرأة/ اإلنسان، وداللة على تغير السيطرة األبوية »البطريركية« التي فرضتها القوانين المجتمعية التقليدية، وأعراف ما أصطلح على تسميته بـ: »المجتمع الذكوري«1*، التي أثرت سلبيا في مستويات المشاركة
النسوية في المجال السياسي.
لقد ألزمت دول العالم نفسها ــ ومنها الدول المغاربية2 ــ بمقاصد مضامين االتفاقيات والعهود الدولية التي عنيت بقضايا المرأة وراهنت على رفع مستوى مشاركتها السياسية3*، فواكبت الدول المغاربية هذه االتفاقيات التي تطورت على مراحل عدة نحو المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز ضد المرأة، ثم القضاء على العنف الممارس ضدها. وكانت سياسة المراحل هذه تعتمد على مدى نجاح الصحوة في إعالء قيمة الفرد الذي تسلطت عليه الحكومات لعقود طويلة، فبعد مؤتمر فيينا لحقوق اإلنسان العام 1993 بدأ تطبيق حقوق اإلنسان يعرف وجها جديدا مبنيا على الصرامة والرقابة الدولية، فحقوق اإلنسان »المترابطة السياسات على النسوية والرقابة المساءلة مداخل أهم من واحدة للمرأة السياسية الحقوق جعلت للتجزئة«، القابلة وغير
والتشريعات والقوانين المحلية، باسم القانون الدولي.
يقول السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، حول أهمية تنفيذ الحكومات لتعهداتها بمراعاة »اعتماد مقاربة الجندر \وإدراج النوع االجتماعي« لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، خصوصا في مجاالت صوغ السياسات واتخاذ القرار:المرأة، وأقروا منهاج التمييز ضد أشكال كافة القضاء على اتفاقيات الذين وقعوا على أولئك للمساءلة لم يخضع »إذا
1* - نحو: »الرجال قوامون على النساء؛ والمرأة ناقصة عقل ودين؛ وخلقت المرأة من الضلع األعوج؛ وصوت المرأة عورة؛ والحزب نادي للرجال؛ ولعن هللا قوما ولوا أمرهم امراة؛ والمرأة عاطفية؛ والتصلح للقضاء؛ وعمل المرأة حرام؛ وجرائم الشرف تستر العيب والعار....«، ونحو
ذلك من األفكار األصولية الراديكالية المتشددة، واألعراف المجتمعية المغلوطة.
2 ــ حورية علمي مشيشي، مشروع تقوية القيادات النسائية ومشاركة النساء في الحياة السياسية ومسارات صنع القرار في: الجزائر؛ والمغرب؛ ـ 2011، بحوث عملية حول »المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي: دراسة تأليفية للتقارير الوطنية الثالثة«، تونس: وتونس 2008ـ
≥Http:∕∕www.Cawtar.Org≤ :مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، العدد: 23، )نيسان/ أبريل 2010(، الموقع
3 * - مر نضال المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق المرأة بثالث مراحل هي: مرحلة تحقيق المساواة بين الجنسين بين األعوام 1945 - 1966، ومرحلة إلغاء التمييز بين األعوام 1966 - 1993، ثم مرحلة مناهضة العنف بين األعوام 1993 -2000. وقد اعتبر ميثاق األمم المتحدة لسنة 1945 مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسيا، مؤكدا في توطئته »اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال«. أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948؛ فقد أعاد تأكيد أهمية المساواة بين الجنسين حين نص على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن دونما تمييز من أي نوع، وأكد أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات األساسية »يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق« كما جاء اعتراف االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952 للنساء »بحق التصويت في جميع االنتخابات وبأهلية االنتخاب في جميع الهيئات المنتخبة باالقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة وكل ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز«. كما تضمنت نصوص العهدين ) 1966 (على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقر الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينص على »أن الدول األطراف تتعهد بضمان مساواة الذكور باإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين«، أما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« لسنة 1979 فقد اعترفت بكافة الحقوق وليس بجزء منها، واعترفت بالحقوق السياسية والمدنية، واالجتماعية، والثقافية، ووسعت حقوق اإلنسان للمرأة انطالقا من الواقع التمييزي القائم ضدها، كما تدعو إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق المساواة في المجاالت كافة، وتحديد اإلجراءات الالزمة لذلك، وتدعو إلى اتخاذ التدابير المؤقتة »التمييز اإليجابي« »الكوتا«، وتفرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء. كما كان اإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي عقد في فيينا العام 1993 محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة؛ إذ يتوافر فيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق التي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال، وتبين أن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان، وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر، وشدد هذا المؤتمر على ضرورة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، وهو ما أكده اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 1993، تمهيدا لتحضير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة / بيجين 1995 الذي وضع األهداف واالستراتيجيات التي تضمنها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد في بيكين العام 1995، ثم مؤتمر بيكين +5 سنة 2000، قبل أن تطلق األمم المتحدة ما أصطلح على تسميته أهداف األلفية الجديدة Millenium Goals، الذي تضمن مبدأ تعزيز
المساواة بين الجنسين كهدف ثالث.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية12
عمل بيجين، ولم يترجموا هذه االلتزامات إلى أفعال، ولم يخضعوا للمساءلة إزاء أفعالهم...، فإن هذه النصوص ستفقد أمرا تكون أن يجب المساءلة فإن الجنسين، بين والمساواة المرأة حقوق تفعيل حقا يريد العالم كان وإذا مصداقيتها.
جوهريا«.4
السياسية، مشاركتها تطور أو تغير مدى ورصد المرأة تمكين لقياس خاصة مؤشرات المتحدة األمم هيئة وضعت وقد واالجتماعي السياسي التمكين مؤشرات أو للمرأة...«5، العائدة المنفعة مؤشر المراقبة، مؤشر األنشطة، »مؤشر نحو: واالقتصادي... فعلى الرغم من وضع تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفه أحد أهم أهداف األلفية من قبل األمم المتحدة، إال أن معظم هذه األهداف ووجهت بصعوبات جمة جعلت الباحثة األممية نائلة كبير تعتبر أن المؤشرات األممية المعتمدة في قياس تمكين المرأة، غير كافية وغير مستجيبة للجهود الدولية، لذلك اشترطت نائلة كبير أن تكون »المؤشرات التمكينية للمرأة«:
»مرئية، وقابلة للقياس والتحقق من قبل النساء«، خصوصا في المجال االقتصادي التنموي.6*
فتحت القوانين التي أقرتها الدول المغاربية في ظل دسترة الخيار الديمقراطي، فرصا وأبوابا للنضال النسوي الذي اكتسب شرعية وتنظيما أكثر مرونة من ذي قبل، إذ إن بإمكان المرأة أن تصل إلى تحقيق مكاسب انتخابية مطردة في ظل التعددية السياسية، التي أتاحت لها حرية االنتخاب والترشح والتعبير عن الرأي، والحق في التجمع واالنخراط في األحزاب والجمعيات التمييز التمويل للجمعيات النسوية. وبالرغم من كل ذلك، ما تزال المرأة المغاربية تشتكي من والنقابات، والحصول على الممارس ضدها في الحياة السياسية ألسباب عديدة، دستورية وقانونية وأخرى سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية تمنعها من الوصول إلى تمثيل سياسي واجتماعي واقتصادي عادل في مراكز صنع القرار، كما الحظ باحثو علم السياسية أن تطور الوضع السياسي للمرأة مرهون بعدة ظواهر سياسية أخرى على اتصال واضح بقضايا الديمقراطية، ومنها الفرضية العلمية القائلة إن: »إقدام حزب األغلبية على االلتزام بترشيح نسبة من النساء في قوائمه االنتخابية، يدفع األحزاب األخرى إلى تقليد حزب األغلبية في اعتماد نفس السياسة تجاه المرأة«، وهي فرضية علمية أثبت الواقع العلمي صحتها في حالة
الدول المغاربية، وسيجري اختبارها حتما في هذه الدراسة.
وبناء على ما تقدم، سيكون مناسبا طرح تساؤل مركزي يلخص المشكلة البحثية ومتغيراتها، تدعمه أسئلة فرعية مساعدة، مترابطة منطقيا ومنسجمة معرفيا، في تحليلها للظاهرة المدروسة ومتغيراتها، على النحو التالي:
إشكالية الدراسة:
كيف هي المشاركة السياسية للمرأة المغاربية، وما هي حصيلتها ومستوياتها؟، وهل كانت نتيجتها لترقية الوضع السياسي للمرأة؟، وهل كانت المشاركة النسوية نتيجة أم سببا لإلصالحات السياسية المعتمدة في دول المغرب العربي لترقية الوضع
السياسي للمرأة؟، وهل تتحمل األحزاب السياسية المسؤولية عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة المغاربية؟.
4 - النوع االجتماعي والمساءلة: من يتحمل المسؤولية أمام المرأة؟، تقرير تقدم نساء العالم UNIFEM( 2009/2008: صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، 2008-2009(، ص.03.
5 ــ دليل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي )UNIFEM اليونيفيم: صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، المكتب اإلقليمي للدول العربية، عمان، 2004(، ص. 36.
6*- هناك دراسات اقتصادية تبحث في التمكين االقتصادي للمرأة، لم تنكر أن المرأة مندمجة في المجاالت التنموية، لكنها أكدت أن اندمجها هو في غير مصلحتها، لذلك تقوم إشكاليتها على دراسة مدى نفاذ التمويالت والقروض إلى النساء؛ بهدف الحصول على الفرص االقتصادية التي تدعم القوة االقتصادية للنساء. وتراهن عملية »جندرة الميزانيات« ـ وهي طريقة جديدة للتأثير في عملية وضع الموازنة السنوية للدول ـ على تخفيض الفجوة والفوارق وعدم المساواة بين الجنسين، في أثناء إعداد الميزانيات العمومية باعتبارها وسيلة من وسائل التمكين االقتصادي للمرأة، فقد كانت هذه العمليات »غير محايدة بالنسبة لمراعاة الجنس«، لذلك توصل الباحثون إلى إمكانية إدراج احتياجات »النوع االجتماعي« عن طريق تصحيح المحلي، وتعد المستوى على التشاركي«، وخصوصا انطالقا من »المنطق النساء الميزانيات، وجعلها مراعية الحتياجات طرق إعداد ووضع الجزائر والمغرب من الدول التي تواكب هذا الطرح، إذ تدرج المملكة المغربية النوع االجتماعي في تقسيم قطاعي في كل موازنة سنوية عمال باستراتيجية وطنية لتمكين النساء، وترفع تقريرا سنويا للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص، في حين، تخصص الجزائر ميزانية وزارية تراعي إدراج النوع االجتماعي ــ ضمن صالحيات الوزارة المنتدبة المخولة برعاية شؤون المرأة واألسرة ـ .ويمكن تعريف »جندرة الميزانية« –إجرائيا- بأنها: »مسلسل يتخذ من خالله قرار »سياسة أو مخطط أو ميزانية أو برنامج أو مشروع بتحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي، يقوم بتنسيق السياسات والبرامج والميزانية، ويقيس االعتمادات المرصودة وأثرها في تحقيق اإلنصاف والمساواة بين الجنسين«. )يرجى مراجعة: الحسين إهناش، »تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع االجتماعي بالميزانية،« المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والشباب في التنمية العربية.. 22 ـ 24 آذار/ مارس
2010 القاهرة، الكويت: المعهد العربي للتخطيط، )آذار/ مارس 2010(، ص. 07.(.
13 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
أما األسئلة الفرعية المساعدة في هذه الدراسة، فستكون كما يلي:
هل كان ممكنا سلوك السلطة خيار تمكين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة، خارج أطر السياق الديمقراطي واعتماد الحريات قيم وإعمال تطبيق دون للمرأة، حقيقي تمكين يحدث أن يمكن وهل المغاربية؟، الدول في السياسية التعددية
الديمقراطية وحقوق اإلنسان؟.
هل تعتبر الحصص النسوية »الكوتا«7* أنسب الطرق لرفع نسب تمثيل المرأة، وزيادة مشاركتها السياسية بطريقة منصفة؟، وهل يمكن للنساء المغاربيات أن يتخلين عن االعتماد الكلي على آلية »الكوتا« في المستقبل على اعتبار أنها آلية تعويضية
إرضائية مؤقتة للمرأة؟
هل يمكن للمرأة المغاربية أن تنعم بتمثيل منصف لها، يجعلها تتمتع بحقوق الديمقراطية التشاركية والمواطنية الحقيقية، الكفيلة الدفاع عن النسوية وجهودها في دعم خيارات األغلبية في الحركات السياسية، وتطوير نضاالت برفع مستوى مشاركتها
الديمقراطية والمطالبة بالمزيد من الحريات؟.
وسيكون مناسبا أيضا اعتماد الفرضيات العلمية التالية لالقتراب من تحليل الظاهرة المدروسة:
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى: االنتقال الديمقراطي واعتماد التعددية السياسية، هو الدافع األساسي لسلوك السلطة خيار تمكين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة، وال يمكن أن يحدث تمكين حقيقي للمرأة، دون إعمال قيم الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
الفرضية الثانية: كلما ازداد ميل النظم السياسية إلى اعتماد الحصص النسوية »الكوتا« بوصفها أنسب الطرق لرفع نسب تمثيل المرأة، كانت المشاركة السياسية للمرأة أكثر ازديادا وتطورا.
الفرضية الثالثة: كلما ترسخت ثقافة الديمقراطية وممارساتها، وكان لها دور في دعم المواطنية والتشاركية في السلطة وطرق اإلدارة والحكم المحلي، كان ذلك دافعا في زيادة المشاركة السياسية للمرأة.
مجاالت الدراسة:
المجال الزماني: منذ استقالل الدول المغاربية الثالث: الجزائر؛ والمغرب؛ وتونس، إلى الوقت الراهن. »خالل فترة ستة عقود، للدول الثالث«.
المجال المكاني: منطقة شمال إفريقيا، وتحديدا الدول المغاربية الثالث: الجزائر؛ والمغرب؛ وتونس.
المجال الموضوعي: المشاركة السياسية للمرأة في منطقة المغرب العربي، ومسألة المساواة بين الجنسين، وإدراج مقاربة النوع االجتماعي في سياسات هذه الدول لتمكين المرأة.
أسباب اختيار الموضوع:
األسباب الذاتية:
ــ تعد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بالجزائر، مؤسسة أكاديمية تهتم بدراسات المرأة، وهي تمتلك مختبر أبحاث يخصص اهتماما تطبيقيا بدراسات المرأة والنوع االجتماعي، قام بإنشاء برنامجي ماجستير ودكتوراه في
موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغاربية.
7 *- نظام الكوتا: هو نظام خاص يتم فيه شكل من أشكال التدخل اإليجابي لزيادة حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعوق مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال، وتميل نظم التمثيل النسبي في الغالب إلى اإلسهام في رفع مستويات تمثيل المرأة، وانتخاب أعداد أكبر من النساء، وتحفيز األحزاب السياسية على ترشيح المزيد من النساء في قوائمها االنتخابية، لتنتج توازنا بين الجنسين، يزيد من حظوظ هذه األحزاب للفوز بعدد أكبر من المقاعد التمثيلية. فحسب اإلحصاءات العالمية لسنة 2004 حول النظم االنتخابية التي تتالءم مع الكوتا النسائية. )يرجى مراجعة: ستيال الرسرود، ريتا تافرون، التصميم من أجل المساواة: النظم االنتخابية ونظام الكوتا... الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة )تعريب: International Institut for Democracy and Electoral Assistance عماد يوسف(، )المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
. ≥Http:∕∕www.Quotaproject.org ≤ :كما يرجى االطالع على موقع الكوتا ،)IDEA، 2007طبق نظام »الكوتا« الحزبية في المغرب قبل تطبيقه في الجزائر، وأدى إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من نسبة 6 في المائة إلى نسبة 10.5 بالمائة
في تشريعات العام 2007، كما أدى إلى رفع نسبة تمثيل المرأة الجزائرية في البرلمان بنسبة تفوق 30 بالمائة بعد تشريعات 2012.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية14
ــ يعد أعضاء هذه الدراسة البحثية، باحثين في وحدة بحث تتدارس موضوع »الديمقراطية التشاركية في ظل اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية« المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بالجزائر منذ العام 2011، ويعد موضوع
المشاركة السياسية للمرأة المغاربية جزءا من اهتمامات هذه المجموعة البحثية.
ــ حصول أحد أعضاء الفرقة على منحة منظمة المرأة العربية للعام 2011 لتمويل البحوث والدراسات حول المرأة، وتعويل مختبر الكلية على التحضير الفتتاح وحدة بحث مستقبلية تدرس منهاجا خاصا بالمشاركة السياسية للمرأة على
مستوى الماجستير والدكتوراه.
األسباب الموضوعية:
ــ تطور االهتمام األكاديمي المحلي والدولي والعالمي بموضوع المرأة، وقضايا الجندر، وعالقتها بمقاربات التشاركية والتنمية.
ــ إدماج موضوع المرأة في اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، وتحول إدماج مقاربة النوع إلى أحد أبرز مؤشرات انفتاح النظام السياسية، وتخليها عن نزعتها التسلطية التي تهمش المرأة.
ــ تطور اعتماد أعلى مستويات صناعة القرار في الدول المغاربية على بحوث ودراسات المرأة، التي أضحت رافدا ومصدرا مهما لتحليل المعلومات ودراسة الظواهر المرتبطة بقضايا المرأة.
ــ الدور الكبير والمهم الذي لعبته المرأة في الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية، في ما أصطلح على تسميته بـ “الربيع العربي«، خصوصا تونس التي شهدت تحوال أثر في كل الحياة السياسية في البالد، وعلى رأسها قضايا المرأة.
أهمية الموضوع العلمية و العملية:
األهمية العلمية للموضوع:
ــ متابعة تطور تطبيق مقاربة الجندر، وإدراج النوع االجتماعي على المستويات التشريعية والسياسات العمومية وحتى على مستوى األحزاب السياسية، ودراسة مدى قدرة هذه المقاربة على تغيير الصور النمطية عن الدور السياسي للمرأة.
ـ استخدام المؤشرات العلمية التي وضعتها األمم المتحدة في محاولة لتكميم الظاهرة المدروسة، وإضفاء الطابع العلمي الذي يدعم القدرة البحثية على التوقع والتنبؤ بالظاهرة النسوية وتحوالتها المستقبلية الممكنة.
األهمية العملية للموضوع:
ــ مواكبة نتائج التحوالت السياسية في سياق الربيع العربي، بالدراسة والتحليل، على الوضع السياسي للمرأة المغاربية.
الدول النسوية في الحركات المرأة ونضاالت المغاربية على الدول السياسية واإلدارية في أثر اإلصالحات ــ دراسة المغاربية.
اإلطار النظري ومناهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على دراسة مفهوم »المشاركة السياسية للمرأة« بوصفه مفهوما نظريا مركزيا، لكن باستخدام مقاربة الجندر »النوع االجتماعي«، ونظرية الجنوسة/األنوثة: Feminism بوصفها نظرية مركزية لتفسير ظاهرة تخصيص السياسات والميزانيات والتشريعات والحصص االنتخابية النسوية The Quota على أساس النوع االجتماعيThe Gender ، كما تقوم الدراسة بتوظيف المقاربات كافة القريبة من الظاهرة المدروسة، وفي مقدمتها »مقاربة حقوق اإلنسان/مقاربة تمكين المرأة، اقتراب النوع االجتماعي والتنمية«؛ بهدف تفسير تحديات ورهانات تجاوز الفوارق الجندرية التي تحول دون ضمان التمكين السياسي األمثل للمرأة، بما يدعم حقوقها السياسية ويرفع مستوى مشاركتها السياسية أمام الرجل، من خالل ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق دون أي تمييز أو أية تحيزات جنسية. وتنطلق هذه النظرية من دراسة نظريتين اجتماعيتين مساعدتين هما: نظرية الدور االجتماعي؛ ونظرية الصراع، اللتان تدعمان عملية البحث في أسس بناء العالقة بين الجنسين داخل المجتمع من المنظور السوسيولوجي، باإلضافة إلى المفاهيم االقتصادية المفسرة لظاهرة »وضع الميزانية المراعية
لمتطلبات النوع«، لتسهيل معالجة أسباب تراجع المشاركة السياسية للمرأة.
15 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
تعتمد هذه الدراسة على مناهج عدة توازي الطرح النظري السابق، ومنها منهج التحليل الفئوي بوصفه منهجا مركزيا لدراسة النسوية في المجالين: االقتصادي؛ واالجتماعي، وتستخدم منهج دراسة الحالة والمنهج المقارن بوصفه منهجا المطالب مساعدا لدراسة الظاهرة النظرية في التجارب المغربية والجزائرية والتونسية، ومقارنتها، وتستخدم المنهج اإلحصائي بوصفه منهجا مساعدا في محاولة تكميم وإحصاء البيانات المتعلقة بالظاهرة المدروسة، والمقاربة االحتمالية بوصفها منهجا مساعدا
أيضا، لقراءة مشاهد وسيناريوهات تطور الظاهرة في المستقبالت الممكنة: المنظور؛ والقريب؛ والبعيد.
صعوبات الدراسة:
تكمن الصعوبة الرئيسية في إنجاز هذه العملية البحثية، في مدى القدرة على الوصول إلى المعلومات الرسمية، وضبط البيانات وتأكيد صحة اإلحصاءات التي تشخص مدى تطور أو تراجع نسب المشاركة السياسية للمرأة في الدول المغاربية. فعلى الرغم من توافر البيانات الرسمية في رصد نسبة مشاركة المرأة في الدول المغاربية في العملية االنتخابية على سبيل المثال، إال أن ظواهر عديدة ما تزال عصية على الرصد والتحليل، منها ظاهرة »عدم تصويت النساء على النساء«، وظاهرة »العزوف التصويتي للمرأة«، وذلك ألسباب عديدة منها، أن التصويت سري مباشر، ونسبي »كاكوفوني« زئبقي، خاضع لتحوالت
البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وحتى السيكولوجية لألفراد.
اإلطار المفاهيمي للدراسة:
يعرف الباحث المختار الهراس مفهوم »المشاركة السياسية« Participation Politique بأنها: »ما يقوم به المواطنون من أفعال ذات صلة بالترشح واالنتخاب التظاهر وكتابة وتقديم عرائض وبيانات سياسية«. لذلك يرى الهراس أن انتفاء بأنه: »التمثيل« مفهوم الهراس ويعرف االنتخابي...8، العزوف ممارسة أو والتهميش باإلقصاء يأتي السياسية المشاركة »الناتج عن االنتخاب، أحد أبرز مظاهر وأشكال المشاركة في المجتمعات الحديثة، الستحالة المشاركة الفعلية والمباشرة للجماهير في ممارسة الحكم وصنع واتخاذ القرارات السياسية«، يعرف الباحث محمد بنهالل مفهوم المشاركة السياسية، بأنه: »أنشطة إرادية يقوم بها المواطنون كأفراد، وتهدف إلى التأثير المباشر أو غير المباشر في االختيارات العمومية، على مختلف أصعدة ومستويات النشاط السياسي«9، وقسم المشاركة السياسية إلى نوعين: مشاركة النشطاء المنخرطين في العمل السياسي؛ وفئة المتتبعين لألحداث السياسية؛ بهدف تحقيق اختيار سياسي قبل إجراء عملية اختيار المترشح األفضل في العملية االنتخابية، وتكون المشاركة السياسية بهدف الحصول على الحق في التصويت واالختيار، والمساهمة في التغيير، ومقدمة لبداية تحضير المرأة نفسها لولوج عالم السياسة، عن طريق نشاطها داخل الجمعيات، وأدوارها من إطار األحزاب10*.
8 - المختار الهراس، المرأة وصنع القرار في المغرب،)تونس: مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، ط.1، 2008(، ص.48.
بيروت: مركز السياسية، للعلوم العربية المجلة التجاوز،« المعوقات وسبل بين المغرب: للمرأة في السياسية بنهالل، »المشاركة ــ محمد 9دراسات الوحدة العربية، ص. 126 ــ 138.
الذاتية، الحاجة من »النابعة« الداخلية المطالب بين وتأرجحه للمرأة«، السياسي »التمكين مفهوم استخدام خطورة إلى التنبيه وجب -*10والضغوط الخارجية التي تفرض اعتماد سياسات »تابعة« قد تكون في الكثير من األحيان مبهمة المصادر. فالتمكين السياسي يعني: »إزالة كافة االتجاهات والسلوكيات والعمليات النمطية في المجتمع والمؤسسات، التي تنمط النساء والفئات المهمشة، وتضعهم في مراتب أدنى، حيث أن التمكين عملية تتطلب تبني سياسات وإجراءات وقائية، بهدف التغلب على كافة أشكال عدم المساواة، وضمان الفرص المتكافئة لألفراد خصوصا في المشاركة السياسية«. وتصاغ السياسات التمكينية لمنع التفرقة على أساس النوع أو الجنس أو اللون أو الفكر.... وغيرها، وتسعى لزيادة فرص
الفرد في اختيار األفضل.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية16
املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية
دراسة ألوضاع المرأة الجزائرية خالل نصف قرن: 1962 – 2012
عرفت المرأة الجزائرية حق االنتخاب في ظل االحتالل الفرنسي العام 1958، وكانت من أولى النساء العرب حصوال على حق التصويت، كما شاركت في استفتاء تقرير المصير العام 1962، الذي وافق فيه غالبية الشعب الجزائري على مطلب نيل االستقالل، ولم تكن المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية مؤطرة داخل أحزاب حديثة، لكن جبهة التحرير الوطني، كان لها تأثير كبير في توجهات الناخبين عموما، والسلوك التصويتي للجزائريين في استفتاء االستقالل العام 1962، ومنهم النساء اللواتي شاركن بقوة في حرب التحرير بوصفهن مجاهدات. ونستطيع الحكم في هذا السياق التاريخي بأن التثقيف السياسي بالحقوق الوطنية كان يصل إلى الفئات النسوية في إطار وسياق المطالبة بالتحرر الوطني، وأن ذلك التثقيف كان له دور مهم في نقل المرأة الجزائرية إلى مرحلة جديدة من المدنية والحداثة السياسية »التقدمية«، نحو عهد »االنتماء للهوية الجزائرية المنفصلة عن االحتالل الفرنسي«، والمواطنية الجديدة لدولة االستقالل. كما سمح للمرأة بتشكيل »لجنة المرأة: سنة 1963 وهي جزء من هياكل ولجان المؤتمر التأسيسي »لالتحاد الوطني للنساء الجزائريات« العام 1966، وهو ما يؤكد وعي المرأة
الجزائرية برفض مسألة اختزال وجودها في التصويت فقط، دون السماح لها بالنشاط السياسي.
أ- الحقوق الدستورية والسياسية للمرأة الجزائرية:تعد القاعدة التشريعية األداة اإلصالحية األولى ألوضاع المرأة الجزائرية، التي راهنت على الوصول إلى مراكز صنع القرار، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، ويمكن االفتراض أن أي مساس أو تالعب بالنظام االنتخابي في الجزائر أو في بقية الدول المغاربية محل الدراسة، له تأثير سلبي على النضال النسوي وأهدافه، في االستفادة من الحريات الديمقراطية، في تطوير
المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة وعيها السياسي؛ واالقتصادي؛ واالجتماعي.
حقوق المرأة الجزائرية في التشريعات الوطنية: في الدستور:تنص المادة 29 من الدستور الجزائري الصادر العام 2008، على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه ال يمكن أن يتم التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي وضع آخر شخصي أو اجتماعي، إلقصاء أي مواطن أو منعه من الحصول على حقوقه11. كما تنص المادة 31 من الدستور على أن ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات هو هدف للمؤسسات الرسمية، التي تتولى إزالة أية عقبات تعوق تفتح شخصية اإلنسان،
وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية؛ واالقتصادية؛ واالجتماعية؛ والثقافية.12كما تنص المادة 31 مكرر من دستور 2008 على أن الدولة الجزائرية تتعهد بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة13، ويحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق المادة14، وظهرت هذه المادة على إثر أمرية رئاسية ألزم بها الرئيس بوتفليقة نفسه لرفع نسبة تمثيل المرأة المتدنية، فبرلمان 2007 المنتخب »الهيئة التشريعية« ال يتجاوز فيه التمثيل نسبة 7.7 بالمائة من عدد نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وهي واحدة من أضعف النسب في العالم، قبل أن تشهد الجزائر اعتماد نظام الكوتا سنة 2012، بنسبة تتراوح بين 30 و 50 بالمائة في القوائم االنتخابية، الذي سمح في برلمان 2012 بوصول 145 امرأة من بين 462 نائبا في البرلمان، وهي من أهم قرائن إصرار الرئيس بوتفليقة في توجهاته السياسية على محاسبة الحكومة حيال مدى التزامها بأوامره الرئاسية في تطبيق النصوص القانونية حول توسيع تمثيل المرأة
في المجالس المنتخبة.15
11 - المرأة الجزائرية.... واقع ومعطيات، الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، )د.ت(:≥http://ministere-famille.gov.dz≤
12 - المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات: 10 سنوات بعد بيجين )الجزائر، الوزارة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، 2006(، ص.07.
13 ــ تقرير حول الوضع اإلنساني للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي في الجزائر، برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة المتوسطية )2008 – 2011(، )االتحاد األوروبي بروكسل، أوروميد، تموز/ يوليو 2011(، ص. 22.
14 - دستور 2008 المعدل، تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.
15 - ملحق بيان السياسة العامة تشرين األول/ أكتوبر 2010، مصالح الوزير األول، )تشرين األول/ أكتوبر 2010(، ص. 21، الموقع:≥http://premier-ministre.gov.dz≤
17 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
وتنص المادة 51 على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهمات والوظائف في الدولة، دون أية قيود أو شروط، وقد جاء في الفصل الرابع الباب األول من الدستور على ضمان الحريات والحقوق السياسية لجميع المواطنين.16
في قانون االنتخاب: منحت الجزائر حق االنتخاب للمرأة العام 1962، وهو تعهد سياسي بأن السلطة لن تقوم بإقصاء النساء من العملية السياسية17*، فدخلت المرأة الجزائرية البرلمان في العام نفسه، كما تكفل المادة 50 من الدستور حق االنتخاب والترشح: »لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب«. وتضمن قوانين االنتخابات تمثيال متساويا وعادال للمرأة والرجل في المجالس المنتخبة، ضمن القانون العضوي رقم 17-91 المؤرخ في 14 تشرين األول/ أكتوبر 1991 المعدل والمتمم للقانون 13-89 المؤرخ في 07 آب/ أغسطس 1989 المتضمن قانون االنتخابات، الذي ينص على إلغاء االنتخاب بالنيابة عن طريق الوكالة، هذا القانون الذي سمح للمرأة بالتعبير عن اختياراتها وحريتها السياسية بحرية مطلقة18. فبحسب تحقيق أجرته الوزارة المنتدبة لألسرة وقضايا المرأة، فإن قرابة 60 بالمائة من النساء الجزائريات، صوتن بأنفسهن19. وقد دخلت مسألة التصويت بالوكالة، نيابة عن المرأة، ضمن التساؤالت األممية الموجهة للحكومة الجزائرية، في كونها نظاما
ينطلق من الهيمنة الذكورية ويكرسها، وفي اعتبار شرعيتها القانونية، ثغرة يجب أن تخضع للمراجعة والتعديل.20*
وقد حافظت القوانين التي تنظم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية على تطورها، دون تسجيل أية تراجعات، إذ تنص المادة 03 في القانون العضوي رقم 12 ـ 01 المؤرخ في 12 كانون الثاني/ يناير العام 2012 المتعلق بنظام االنتخابات، أنه يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم االقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حاالت فقدان األهلية المحددة في التشريع المعمول به، وتنص المادة 07 أنه يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم21. وهو المضمون نفسه لنص المادتين 05 و 09 في قانون االنتخاب رقم 97 ـ 07 المؤرخ في 06 آذار/ مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق
بقانون االنتخابات22. وقد التزمت الحكومة الجزائرية باإلجراءات التالية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية:
ــ إنشاء الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة العام 2002، والمجلس الوطني للمرأة العام 2006، وتطبيق المرسوم الرئاسي الصادر العام 2010، والخاص بإنشاء المركز الوطني للدراسات واإلعالم والتوثيق حول قضايا األسرة والمرأة
والطفولة، باإلضافة إلى منح الجمعيات النسوية حرية النشاط الجمعوي النسوي بناء على ما ورد في قانون الجمعيات.
وهي المرأة، أوضاع لترقية عمل وخطط استراتيجيات بإعداد المرأة، وقضايا باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة قامت ــ كاآلتي: االستراتيجية الوطنية إلدماج المرأة وترقيتها 2008 ـ 2013؛ والمخطط التنفيذي لالستراتيجية 2010 ـ 2014؛
واالستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2007 ـ 2012.
16 - سعاد بن جاب هللا، »مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية« في: المشاركة السياسية للمرأة العربية... تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة )دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا( )تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان، 2004(، ص. 103.
17* - رغم أن تأسيس الدولة الجزائرية المستقلة، قد عرف إقصاء لبعض التيارات السياسية المعارضة لنهج السلطة الحاكمة آنذاك، ويعني أن النساء المنضويات تحت هذه التيارات الحزبية المنشقة عن الحكم الحظر السياسي الذي مورس على قادة ومناضلي هذه الحركات، يشمل أيضا
األحادي السلطوي للنظام.
18 - المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات: 10 سنوات بعد بيجين، المرجع السابق، ص. 10.
19 - االستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة 2007-2011، أمان المرأة... استقرار لألسرة )الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة ≥http://ministere-famille.gov.dz≤ :)2006 ،وقضايا المرأة
20* - التصويت بالوكالة مسألة قانونية في الجزائر، لكنها نوقشت بوصفها مسألة مثيرة للجدل بالنسبة للمرأة لكونها مكرسة للسيطرة والهيمنة الذكورية على النساء، وقد استجابت الجزائر بعد انضمامها إلى مؤتمر بيكين 1995، بإلغاء التصويت بالوكالة بالنسبة للنساء العام1997، استجابة للمطالب الدولية، في الوقت الذي ما يزال هذا النظلم معموال به من الجنسين، في االنتخابات التي تعرف اقتراعا مباشرا، كما هو حال التصويت
داخل المجلس الشعبي الوالئي، ولم يرد منع نهائي لهذه الظاهرة إلى حد اآلن.
21 -القانون العضوي رقم 12 ـ 01 المؤرخ في 12 كانون الثاني/ يناير سنة 2012 المتعلق بنظام االنتخابات، الجزائر، بوابة الوزير األول:≥http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-01.pdf≤
22- وحيدة بورغدة، سمراء زيغم، سهيلة بلحميدي، وآخرون، المرأة في التشريع الوطني... مصنف 2009 )الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة، 2009(، ص .151.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية18
ــ إدماج مقاربة النوع االجتماعي »الجندر« في البرامج الوطنية كافة ، ويعني ذلك السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، في المجاالت: السياسية؛ واالقتصادية وتقليص الفوراق الجندرية والتقسيمات المبنية على أساس اتالفات النوع، خصوصا
التنموية؛ واإلدارية.
ــ تحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بالتنمية البشرية وحماية الفئات المحرومة، ووضع اآلليات والهياكل الضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، ورعاية المرأة الريفية، وتحسين الوضع المهني للنساء.
ب ــ التصويت النسوي في الجزائر بعد االستقالل: مقارنة بين مرحلتي الواحدية والتعددية السياسيةتمكنت 60 امرأة جزائرية من الوصول إلى المجالس الشعبية البلدية العام 1967، و 45 امرأة من الوصول إلى المجالس الشعبية الوالئية العام 1969، و10 نساء من الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني العام 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين23، وتم تعيين وزيرة واحدة في الحكومة الجزائرية بين األعوام 1962 – 1976، وتعيين 04 سفيرات، وعدد من رئيسات المحاكم...، وكانت جميع األرقام السابقة في ظل تجربة الحزب الواحد، لكن تحوالت ما بعد أحداث العام 1988، وهي تعد أهم المواعيد التاريخية التي تسببت في ازدياد المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، فقد تسببت في تطور نضال الحركات النسوية من خالل األحزاب والجمعيات، وزيادة نسب تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لكن بنسب ال تعتبر األعلى بالمقارنة مع المغرب وتونس »على المستوى اإلقليمي«24 . ولقد كان حضور المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني منذ العام 1976 ضئيال ومتراوحا بين 2 و8 بالمائة ضمن عتبتين ال تبارحهما ألعوام طويلة، تؤكدان، تنميط دور المرأة السياسي ومكانتها، في ذهنية صناع القرار من جهة، والناخبين من جهة أخرى. ويؤكد الجدول التالي بأن الجزائر تأخرت في اعتماد
»نظام الكوتا« إلى العام 2012، ألسباب واعتبارات عدة، أهمها األزمة السياسية واألمنية التي عرفتها البالد.
شاركت المرأة الجزائرية في بناء الدولة الجزائرية بعد االستقالل العام 1962، ومنذ أول يوم تقرر فيه اعتماد نمط اشتراكية الخزينة كانت فقد ،1965 بين األعوام 1962 – البالد الذي حكم بلة بن أحمد السابق الرئيس أقره الذي الذاتي التسيير العمومية للدولة بحاجة إلى تطوع المواطنين وكانت النساء في المقدمة، حين تقدمت عشرات النساء بجمع الحلي واألموال لدعم الحكومة وملء الخزينة الفارغة، وتحول الدور النضالي للمرأة إلى نمط جديد من النضال السياسي في ظل االستقالل، الذي خلص المرأة الجزائرية من تكريس الصورة النمطية لها بأنها امرأة تقليدية سجينة قيم المجتمع الجزائري “التقليدي”25. لكن، وبالرغم من هذا الموقف الوطني، كانت المرأة الجزائرية مثلها مثل الرجل، ضحية التسلط السياسي المفروض من قبل نظام الرئيس بن بلة، الذي فرض نمط الحكم األحادي تحت سيطرة الحزب الواحد “حزب جبهة التحرير الوطني”، وظلت مشاركة بعض النساء رمزية ال تتجاوز بعض الشخصيات النضالية النسوية من المجاهدات اللواتي شاركن في حرب التحرير على غرار السيدات: جميلة بوحيرد؛ وزهور لونيسي؛ وزهرة ظريف مثال. واستمر هذا الوضع على ما هو عليه في فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين الذي حكم البالد بين األعوام1965- 1978، ولم يتبلور النضال النسوي الجزائري تقريبا بطريقة علنية ومنظمة ويكفلها الدستور والقانون، سوى في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي دشن عهد االنفتاح السياسي الديمقراطي، العددي التمثيل إلى الرمزي، التمثيل النسوي من التمثيل ، واالنتقال في السياسية كافة التيارات للنظام على وأخذ نضال المرأة يتطور سريعا باتجاهين: األول مواكبة تطورات قضايا المرأة على الصعيد الدولي؛ والثاني على الصعيد المحلي الوطني. واستمر هذا النضال الطبيعي إلى أن شهدت الجزائر وضعا أزمويا كارثيا، بسبب ظهور ظاهرة اإلرهاب التي حصدت أعدادا كبيرة من النساء ضحايا اإلرهاب، واستمر النضال النسوي إلى أن توصلت المرأة في عهد الرئيس اليامين زروال إلى تحقيق مكسب المادة 31 مكرر من دستور 1996 الذي تعهدت فيه الدولة بترقية الوضع السياسي للمرأة، تمهيدا لنشأة وزارة منتدبة لشؤون المرأة تديرها وزيرة، منذ العام 2003، ثم إصدار قانون عضوي يوسع تمثيل المرأة عن طريق
آلية الحصص الحزبية النسوية “الكوتا”.
23 - حليمة لكحل، »دعم المشاركة السياسية للمرأة المغاربية« الندوة الخامسة حول: »دعم المشاركة السياسية للمرأة المغاربية )نواكشوط 21-22 شباط/ فبراير 2008(، ص.49.
المرأة، وقضايا باألسرة المكلفة المنتدبة الوزارة )الجزائر: للمرأة السياسي بالتمكين الخاصة المسحية الدراسة معتوق، فتيحة ــ 24د. ت(، ص. 07.
25 ــ يحيـى بوعزيز، المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية )الجزائر: دار الهدى، وزارة الثقافة: تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، ط.1، 2000، ط.2، 2007(، ص. 145.
19 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
الجدول رقم )1( تمثيل المرأة الجزائرية في البرلمان المنتخب منذ االستقالل
أما حضور المرأة على مستوى الغرفة العليا للبرلمان “مجلس األمة” منذ استحداث نظام الغرفتين بعد أزمة العام 1992، فهو ضئيل جدا، وربما كان سيكون معدوما لوال اعتماد الحركات النسوية على الثلث الرئاسي26، الذي أكد االلتزام الرئاسي بمنح تمثيل دائم للمرأة على مستوى هذه الغرفة العليا للبرلمان. ويتأكد من خالل مقارنة تطور المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بين العهدين: الواحدي؛ والتعددي، أن الوعي السياسي للمرأة كان مؤدلجا باأليديولوجيا االشتراكية، التي فرضت مقارنة تنموية تعتمد على النظرية الماركسية في التفكير السياسي واالقتصادي، وأن انتهاج هذا الخيار األيديولوجي األحادي جعل مشاركة المرأة محصورة ضمن حدود الطرح الرسمي. في حين جاءت التعددية السياسية بأطياف وشرائح وتيارات سياسية من كل
الجبهات: الدينية؛ والديمقراطية العلمانية؛ والقومية الوطنية....
ج ــ اعتماد مقاربة الجندر ومنع التمييز ضد المرأة: تجاوز التحفظات وتطوير الميكانيزمات التنفيذية
الجزائر دولة عضو في اتفاقية “ سيداو CEDAW “ القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، لكنها وقعت عليها العام 1996، في ظل تسجيل عدد من التحفظات27*، وقدمت الجزائر تقريرها األول عن تنفيذ االتفاقية لألمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 1999، وقدمت تقريرها الثاني في كانون الثاني/ يناير 2005. وتعترف الدساتير الجزائرية بأسبقية المعاهدات الدولية على القانون الوطني في حال المصادقة عليها، وتوضح ذلك: المادة 86 من دستور سنة 1976؛ والمادة 27 من دستور 1989؛ والمادة 28 من دستور سنة 1996. كما يحرص المجلس الدستوري على ضمان تطبيق الدستور واحترام االتفاقيات الدولية. ويعد المجلس الدستوري الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في دستورية القوانين الوطنية، وقد أنهى
26 ــ سعيد مقدم، المرجع السابق، ص. 48.
27* - تحفظت الجزائر على المواد التالية من اتفاقية » سيداو 1979«: المادة 2 التي تنص على اتخاذ تدابير إلنهاء التمييز؛ والمادة 15 ـ 4 المتعلقة بحرية الحركة واختيار محل اإلقامة؛ والمادة 16 المتعلقة بالمساواة في الزواج والطالق سوى في حال عدم تعارضها مع القانون الجزائري والسيما مع قانون األسرة. وبعد تعديل قانون الجنسية في العام 2005 رفعت الجزائر تحفظها على المادة 9 ـ 2 من االتفاقية، وبقيت التحفظات األخرى سارية. )يرجى مراجعة: الحبيب الحمدوني، حفيظة شقير، حقوق اإلنسان بين االعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية )القاهرة: مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان، العدد: 20، 2008(، ص. 100.(.
“ترقية مشاركة املرأة اجلزائر... الواقع واملأمول: يوم دراسي برملاني حول ترقية التمثيل السياسي للمرأة... بني املصدر: سعيد مقدم،
العدد: 07، البرملان، مع العالقات اجلزائر: وزارة الوسيط، “ مجلة للجيش، الوطني النادي اجلزائر: )2009/06/29(، والتطلعات، الواقع
الباحثني في إضافة نتائج العهدة االنتخابية التشريعية احلالية 2012 – 2017( للجدول. )2009(، ص. 51. )مع مالحظة تصرف
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية20
المجلس حالة التحفظ الجزائري على االتفاقيات الدولية بخصوص اعتمادها مسألة االنتخاب بالنيابة، وتم إلغاء العمل بنظام الوكالة بعدما أثار خالفا العام 1997 باعتباره أسلوبا استثنائيا28.
اللجنة تضع معايير أن المتحدة، التي تتولى اإلجابة عن تساؤالت لجنة المرأة في هيئة األمم اللجنة الرسمية ذكر أعضاء صارمة في االستماع إلى التقرير الجزائري حول الوضع السياسي للمرأة، الذي تقدمه الجزائر كل أربع سنوات في جنيف بمقر هيئة األمم المتحدة. ويرأس الوفد الجزائري السفير إدريس الجزائري، سفير الجزائر فى جنيف. وقد أكدت الجزائر أن خضوعها للمساءلة بخصوص تمكين المرأة –يتم في حضور ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري “الجمعيات”- هو التزام فرضه التحاقها باتفاقية “سيداو”، الذي نتج عنه رقابة دولية على مدى التزام الجزائر بتعميم إدراج النوع االجتماعي. وتجدر اإلشارة إلى أن عددا من الجمعيات النسوية الوطنية الجزائرية – منغلقة العضوية - ومراكز األبحاث المتخصصة في قضايا المرأة، تقوم بإعداد تقارير عن أوضاع المرأة الجزائرية، وتعميمها على المستوى الدولي، وهو ما يؤشر إلى بعض محاوالت “استقواء” هذه الجمعيات ومراكز األبحاث المتخصصة، بالمجتمع الدولي، ممثال في هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، لمساءلة الحكومة الجزائرية. ومن نماذج هذه الجمعيات جمعية “المرأة في اتصال” التي تمتلك إصدارات حول التمييز المستمر ضد المرأة الجزائرية، في مضامين القوانين الجزائرية كقانون األسرة مثال29، ودراسة مركز سيداف CIDDEF لإلعالم والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة30*، الذي نشر دراسة بعنوان: “نحو المساواة في الميراث بين الجنسين في الجزائر”31*، على الرغم من إدراك هذا المركز بأن الشريعة تعد أحد أهم مصادر التشريع في الدولة الجزائرية، يعنى رسمي مركز يفتتح أن وينتظر الجزائري32. المجتمع في المرأة حول محتدم لنقاش بابا سيفتح اإلصدار هذا وأن بالدراسات والتوثيق حول المرأة، بعد تأكيد قرار إنشائه بأمرية رئاسية صدرت رسميا في الجريدة الرسمية، غير أن مشكالت أكبر تسبق افتتاح هذا المركز منها، أن الوزارة المنتدبة المعنية بقضايا المرأة، لم تصبح بعد وزارة مستقلة كاملة الشخصية
القانونية أو المالية؛ بل تقع تحت الوصاية المالية لوزارة التضامن.
د ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية
عرفت التجربة التعددية في الجزائر انطالقة صعبة انتهت بعد إقرار دستور التعددية العام 1989 إلى انتخابات تشريعية، أدت إلى فوز اإلسالميين المتشددين من الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ العام1991 باالنتخابات التشريعية. وبسبب تهديد هذا الحزب للخيار الديمقراطي وتهديده بالتحول نحو نموذج لدولة الثيوقراطية الدينية، تم وقف المسار االنتخابي وتعطيل الدستور وحل المؤسسات، مقابل تشكيل مجلس أعلى للدولة. وكانت للمؤسسة العسكرية السلطة المطلقة للتشريع وسن القوانين لحكم البالد فراغ إلى سياسيا انتهت محتدمة، سياسية أزمة الجزائرية الدولة فواجهت الطوارئ، نظام في رسمي بشكل دخلت التي دستوري اقتضى المساءلة الدولية حول سبل العودة السريعة للمسار الدستوري، وأزمة اجتماعية وأمنية في الجهة المقابلة على إثر العنف المتبادل بين اإلسالميين والسلطة وانتشار ظاهرة اإلرهاب التي كانت فيها النساء أولى الضحايا لهذا الوضع إلى الجزائرية الدولة بالحرب األهلية. وبعد عودة الدولية عن وصفه الجهات تتوان لم الذي األزموي والنزاعي الخطير، المسار الدستوري بعد إقرار الرئيس اليامين زروال دستور 1996 التعددي الذي حافظ على الخيار الديمقراطي للبالد، عرفت البالد أول انتخابات تشريعية بعد األزمة، العام 1997، وكانت نتيجتها اعتالء حزب التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي” RND، سدة الحكم بوصفه أول قوة سياسية في البالد؛ تاله حزب جبهة التحرير الوطني “االفالن” FLN؛ وحركة المجتمع
28 - سعاد بن جاب هللا، المرجع السابق، ص159.
29 ــ قانون األسرة تمييز في نصه وروحه، )اليونيفم UNIFE:، الجزائر: جمعية المرأة في اتصال، 2008(.
/http://www.ciddef-dz.com :لإلعالم والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة CIDDEF 30* - مركز سيداف
31* - فالمجتمع الجزائري عندما يجد الحركات النسوية تطالب بتوحيد سن الرشد بين المرأة والرجل، أو التوزيع العادل للميراث بين الجنسين، أو تحريم تعدد زواج الرجل، أو إلغاء العصمة للرجل؛ ألنها سبب طرد النساء من البيوت وتشريدهن في الشوراع، وتكريس وفرض أحادية الزوجة La Monogamie....، وغيرها من المطالب التي تستهدف تطوير التشريعات بعيدا عن اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا من مصادر التشريع، فإنه سيخضع لتسييس ستتسبب فيه التيارات السياسية، التي ستختلف حتما حول هذا السجال الذي يعود باألصل إلى خيار فصل الدين عن الدولة »الالئكية السياسية«، نحو خيار الدولة المدنية العلمانية الحديثة، وسيجر إلى النقاش حول الشرعية الثورية التي تأسست عليها الدولة الجزائرية؛ ألن
بيان أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، كرس اعتبار الثورة إسالمية، وأن اإلسالم دين الدولة والمصدر األساسي للتشريع.
32 - نحو المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، )الجزائر، مركز سيداف CIDDEF لإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة، د.ت(.
21 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
اإلسالمي “حمس” HMS. وكان للنساء نصيب في هذه المؤسسة التي أضحت غرفة سفلى في التعديل الدستوري لسنة 1996، إذ تمكنت المرأة الجزائرية من ولوج المؤسسة التشريعية عبر آليات مختلفة عن االنتخاب االعتيادي للسلطة التشريعية، لدخول المؤسسة العليا للبرلمان، مجلس األمة الذي يتشكل ثلثاه من االنتخاب المباشر على مستوى المجالس الشعبية الوالئية، ويتم
تعيين ثلثه المتبقي من قبل رئيس الجمهورية في ما يعرف بـ “الثالث الرئاسي”.
النساء السياسية، ومنح بالمشاركة المواطنين السلطوية إلقناع لكن، وبالرغم من كل ما سبق ذكره من الجهود والرهانات الفرصة لتمثيل المجتمع النسوي الذي يتجاوز 18 مليون امرأة، خرج على الجزائريين تقرير مهم و”مدهش” في آن واحد، أصدرته مؤسسة سبر اآلراء العربية )استطالعات الرأي العام العربية(: المقياس العربي “Arab Barometer” هذا العام 2012، عن مركز الدراسات االجتماعية بجامعة ميتشيغان األمريكية، الذي قدم مؤشرات تعد األقرب إلى الواقع الجزائري، وخصوصا تلك التي بحثت عن السلوك التصويتي المنتظر من الناخب الجزائري في ضوء نسب مخيفة من تزايد “الالثقة السياسية” في الحكومة33، وتقول بيانات االستطالع إن: 62% من الفئة المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء الحكومة، و46.9% ال يجدون أي مضايقات في نقد أداء الحكومة، و36% يرون أن الديمقراطية وسيلة يمكنها أن تفرض تغييرا حكوميا، الفساد اإلداري؛ واالرتفاع الفقر هي أن أسباب بالمساواة مع غيرهم من الجزائريين، و71.3% يرون و75.5% يشعرون المستمر لألسعار؛ وازدياد البطالة. و50% ليست لديهم ثقة في البرلمان، و60% يصرون على أن تكون النصوص القانونية مستوحاة من الشريعة اإلسالمية، و40% يرفضون القروض البنكية، و65% يرون أن الوضع االقتصادي سيـىء، و 55 % للوزراء34. وتبين القراءة األولية لهذا االستطالع المهم بأن الصور للجمهورية أو رئيسا يرفضون أن تكون امراة رئيسا النمطية حول المرأة ما تزال مترسبة ومكرسة، لكنها لم تكن اطالقا سببا في الرفض المطلق للوجود النسوي في البرلمان ما
دامت الديمقراطية الطريق األكثر تفضيال في صنع التغيير بالنسبة للجزائريين.
أما بخصوص النظام االنتخابي والقدرة على التشريع البرلماني، فالمرأة الجزائرية ضعيفة جدا في هذا المجال، فهي لم تستطع أن تؤكد وجود تالعب انتخابي يتسبب في إقصائها في العملية االنتخابية لصالح الرجل. ومن جهة أخرى، لم يفد وجود المرأة في البرلمان في جعلها تطور النضال النسوي من الناحية الموضوعية، والسبب يعود في كون المرأة سجينة سيطرة أحزاب
األغلبية على البرلمان أوال، ثم سجينة حزبها السياسي الذي يمنعها من بلورة أية مشاريع قوانين لصالح المرأة.
هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومراكز صنع القرار
العام قانون األسرة الجزائري زبيير عروس - بظهور الباحث الجمعيات – حسب الجزائرية في المرأة ارتبطت مشاركة 1984 على إثر صدور قانون عن المجلس الشعبي الوطني35. وقد تحول قانون األسرة إلى نقطة ارتكاز لنشاط الحركات CRASC الجمعوية النسوية في الجزائر. ونقل الدكتور عروس عن دراسة الباحثة بمركز الدراسات األنتروبولجية كراسكبوهران، السيدة مليكة رمعون، الدراسة الموسومة بـ: “الجمعيات النسائية من أجل حقوق المرأة” المعدة العام 1999، التي ورد فيها أن الحركات النسوية كانت على عالقة عضوية بالحزب الواحد، حزب جبهة التحرير الوطني األفالن FLN، وأنها لم تكن تتمتع باالستقاللية، “فاالتحاد الوطني للنساء الجزائري” كان جزءا من جهاز السلطة، فبدأت محاوالت تجمع نسائي بين األعوام 1984 – 1988، تنادي بتوسيع مجال النضال النسوي ليشمل نساء من خارج السلطة، ورموزها النسوية المعتادة، إلى أن جاءت أحداث 05 تشرين األول/ أكتوبر 1988 التي تسببت في انتقال الجزائر نحو التعددية السياسية، بعد إقرار دستور 1989 التعددي، الذي سمح بالمشاركة السياسية للنساء الجزائريات في األحزاب والجمعيات دون تدخل السلطة في فرض انتماءاتهن السياسية، فكانت الجزائريات أمام اختبار انتخابي فاق قدراتهن السياسية؛ ألن الدولة الجزائرية كانت قد دخلت في أزمة أمنية على إثر وقف المسار االنتخابي، لكن النساء كن أكثر ضحايا األزمة الدموية التي عرفتها البالد في ما
33 - حميد يس، محمد شراق، عثمان لحياني، »في سبر لآلراء أجرته مؤسسة آراب باروميتر: السياسة خارج اهتمامات الجزائريين، والجزائريون يرفضون أن تترأسهم امرأة،« الجزائر، يومية الخبر، العدد: 6597، )الثالثاء 17 كانون الثاني/ يناير 2012(، ص. 12 – 13.
Démocratie, Gouvernement, Religion, Partis, Economie, Citoyenneté…. Ce Que Pensent Les« - 34.Algériens?;« ELWATAN ; Algérie, N: 6459 ; )Mardi, 17 Janvier 2012( ; p p . 2 ;3 ;4 ;5
35 - زبير عروس، »الخلفية التاريخية ونضال جمعيات الحركات النسوية من أجل التغيير في الجزائر،« الجزائر، مجلة مركز سيداف للدراسات، العدد: 24، )آذار/ مارس 2010(، ص. 37ــ 51.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية22
أصطلح على تسميته بـ “العشرية السوداء”، فقتلت بين األعوام 1991 – 1994 ، حسب الدكتور زبير عروس، نحو 150 امرأة، معظمهن وجدن مغتصبات قبل القتل، كما هي عادة كل النزاعات في مثل هذه الحروب األهلية المحتدمة، بين موجتي العنف اإلسالموي؛ والعنف الرسمي المضاد. وكان أكبر انتقاد من قبل األمم المتحدة للجزائر. وبالرغم من بعض السقطات والتراجعات المسجلة على صعيد النضال النسوي، فقد زاد النضال النسوي تنظيما وشراسة، حين وصلت رسالة من الحركات النسوية إلى رئيس الجمهورية العام 1996 تطالبه بانضمام الجزائر إلى “اتفاقية سيداو”، واإللغاء الكلي لقانون األسرة وتعديل
مضامينه الجوهرية36.
لكن، تبقى مسألة النشاط النسوي داخل األحزاب من أهم عوائق وصول المرأة الجزائرية إلى مراكز صنع القرار، فالحزب “ناد رجالي” ال تستطيع المرأة أن تحضر جميع جلساته، كما تفعل في الجمعيات، خصوصا الجمعيات منغلقة العضوية، وتتحمل األحزاب جزءا كبيرا من مسؤولية تراجع تطور الوضع السياسي للمرأة الجزائرية التي لم تمنح لها فرص الترشيح الحزبي،
كما يؤمل من هذه األحزاب التي استغلت األصوات النسائية، وكذا األسماء النسوية، لكن، لتزيين ذيل القائمة الحزبي.
السياسية التعددية في عهد الجزائر في النسوية الجمعوية الحركات نشاط في أثرت التي التالية الظواهر ويمكن رصد :2012 - 1989
ــ دورها اإليجابي في توعية المرأة بالقوانين التي تعيق تطورها، وتنظيم المطالب بتحقيق “مواطنة المرأة”.
ــ ضغطها المستمر نحو مراجعة قانون األسرة، والمطالبة برفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واستخدام الضغوط الدولية للتأثير في السلطة، بعد تأكيد احتكار السلطة التنفيذية للتشريع، وعدم مصداقية المؤسسة التشريعية، وهي دالالت واضحة على
القدرة النسوية على التحكم وتوظيف القيم العالمية في الرسالة النسوية المحلية.
للتشريع، ومعاداتها لألصولية الدينية، إلى درجة اقترابها من التيارات ــ دعوتها إلى التخلي عن الشريعة بوصفها مصدرا العلمانية االستئصالية المتطرفة ضد اإلسالميين، ودخولها بهذه المطالب عبر بوابة دعم حقوق النساء ضحايا العنف اإلسالموي
واإلرهاب.
ــ عدم سماحها للجمعيات النسوية اإلسالمية الطابع باالنضمام إلى جهودها السياسية والجمعوية نحو المطالبة بالدولة المدنية العلمانية، ورفض بعضها لسياسة قانون الرحمة سنة 1995؛ والوئام المدني سنة 2000؛ والمصالحة الوطنية سنة 2005.
ــ تركيز الحركات النسوية على المطالبة بتطبيق وتعميم سياسة التمييز اإليجابي، و”الكوتا”، للتعجيل بتحقيق مطالب المساواة بين الجنسين.
و ــ اإلصالحات االنتخابية نيسان/ أبريل 2011 وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس االنتخابية
جدل تطبيق “الكوتا” في الجزائر على المستوى المحلي... اإلشكالية الديموغرافية والحسابات االنتخابية
قام الرئيس بوتفليقة بإعالن إلغاء حالة الطوارئ في البالد، قبل أن يعلن عن حزمة من اإلصالحات السياسية في نيسان/ أبريل 2011، في سياق حراك داخلي بدأ في سياق موجة احتجاجية شبابية اندلعت في شهر كانون الثاني / يناير 2011، وانتهت إلى تسريع تطبيق اإلصالحات المتأخرة في البالد، ويأتي من بينها قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، عن طريق استخدم آلية نظام الحصص النسوية “الكوتا”، بنسب تتراوح بين 30 و 50 بالمائة في القوائم االنتخابية، واعتبار هذا اإلجراء ركنا أساسيا في فلسفة النظام حول “اإلصالح الذي تشرف عليه مؤسسة الرئاسة”37. واستند هذا القانون إلى المادة 31 مكرر في دستور 1996، لتأكيد دستورية اإلجراء. وهذا ما يدل على أن األمرية الرئاسية التي واصلت تطبيق هذه المادة، مستمرة في دعم مطالب الحركات النسوية باعتماد نظام “الكوتا” في الجزائر38، كما أن اعتماد آلية “الكوتا” في الجزائر عن طريق
36 - المرجع السابق نفسه، ص. 46.
37 - قانون عضوي رقم 12-03 يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجزائر، الجريدة الرسمية، موقع بوابة الوزير األول:
≥http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/reformes/loiorg12-03.pdf≤
38 - خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: رسالة الرئيس بوتفليقة إلى النساء الجزائريات: المرأة في الجزائر تحمل رسالة البناء وتتحمل مسؤولية القيادة، الجزائر، يومية الشعب، العدد: 15131، )االثنين 08 آذار/ مارس 2010(، ص. 06.
23 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
اإلصالحات، هو نتيجة إيجابية للتحوالت السياسية التي تعرفها الجزائر39، وقد حددت وزارة الداخلية كيفيات اعتماد “الكوتا النسوية” واإلشكاليات الحسابية الخاصة بالتمثيل الديموغرافي40.
وتجدر اإلشارة إلى أن ما الحظه باحثو علم السياسية بأن تطور الوضع السياسي للمرأة مرهون بعدة ظواهر سياسية أخرى على اتصال واضح بقضايا الديمقراطية وأداء األحزاب، ومنها الفرضية العلمية القائلة إن: “إقدام حزب األغلبية على االلتزام بترشيح نسبة من النساء في قوائمه االنتخابية، يدفع األحزاب األخرى إلى تقليد حزب األغلبية في اعتماد نفس السياسة تجاه المرأة”، هو فرضية علمية صحيحة أثبت الواقع صحتها، ففي الجزائر كان القتناع حزب األغلبية حزب جبهة التحرير الوطني “األفالن” FLN باعتماد “الكوتا” ، تأثير واضح في اقتناع بقية األحزاب بهذا الرهان، الذي انتهى إلى تمكين المرأة الجزائرية من الوصول إلى البرلمان بنسبة تتجاوز 31 بالمائة، أصبحت بحلول العام 2012 األعلى عربيا، وفي المرتبة 25 عالميا، بوصول 145 امرأة من بين 462 مقعدا في البرلمان، 68 مقعدا لصالح جبهة التحرير الوطني وحده، “وهو حزب
األغلبية في تشريعيات 2012” األخيرة. 41*
املشاركة السياسية للمرأة املغربية
دراسة ألوضاع المرأة المغربية خالل ستة عقود: 1956 - 2012
بدأت المرأة المغربية نضالها النسوي بعد االستقالل للرد على سلوك السلطة المتمثل بالنهج اإلقصائي ضد النساء، ثم تطور نضالها لتغيير الصورة النمطية التي كرستها االستحقاقات االنتخابية التي أجريت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما تم التعامل معها بوصفها “وعاء انتخابيا” ال يتجاوز في قيمته “التصويت دون الترشح”، والترشح الرمزي بدل الكمي، وانتقلت بعدها إلى النضال السياسي في ظل االعتماد الرسمي للتعددية السياسية، لتقاوم مشكالت من نوع جديد، تتعلق بالنضال داخل األحزاب والفوز بمعركة استحقاق الترشح. وألن هذه المسألة لم تكن ممكنة في ظل التنافس الندي بين المراة والرجل، اتفقت األحزاب السياسية في تشريعيات سنة 2007 على تخصيص “كوتا” من القائمة الحزبية لتصبح حصة نسوية تضمن 30 مقعدا للمرأة في البرلمان. وكانت النتيجة 10 بالمائة، ثم رفع الحصة إلى 60 مقعدا في تشريعيات تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 التي رفعت تمثيل المرأة إلى 60 مقعدا ونسبة 15 بالمائة من النساء البرلمانيات. وما زالت المرأة المغربية تناضل في سبيل رفع نسب تمثيلها وصوال إلى المناصفة التي تعبر عن توازن التمثيل مع المعطيات الديموغرافية للبالد، ومراعاة المساواة بين الجنسين حتى في ظل المطالبة بالحريات الديمقراطية. ويذكر الباحث السياسي المغربي محمد بنهالل أن معطيين اثنين كان لهما دور في ازدياد المشاركة السياسية وتطورها للمرأة المغربية: أوال، تطبيق نظام التصويت بالالئحة النسبي؛
والثاني، اعتماد حصة “كوتا نسوية”/ حزبية.
أ ــ الحقوق الدستورية و السياسية للمرأة المغربية:
المرأة المغربية في الدستور: أقر الدستور المغربي في الفصل الثامن المراجع سنة 1996، وبعبارات واضحة وصريحة، و لسنوات: 1962 المغربية الدساتير في الحق هذا أن ورد بعد السياسية، الحقوق في والرجل المرأة بين المساواة على 1970 و 1972 و 1992 في الفصل الثامن منها. كما يقر الدستور المغربي في الفصل الخامس منذ سنة 1962 مساواة االجتماع؛ والتعبير؛ وحرية الرأي في حرية الحق المواطنين لجميع التاسع الفصل القانون، ويضمن أمام المغاربة جميع
39 ــ »المرأة الجزائرية والربيع العربي،« موقع ربيع المرأة العربية:http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D≤
≥8%A6%D8%B1&oldid=1500
40 ـ »الكيفيات التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد في االنتخابات التشريعية ليوم 10 ايار/ مايو 2012،« موفع وزارة الداخلية الجزائرية:
≥http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=126&s=38≤
41* - تم تسجيل صعود امرأتين على رأس حزبين جديدين في الجزائر، بعد أن اختزل هذا النشاط في رئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون، إذ تم اعتماد حركة الشبيبة الديمقراطية وهي تنطوي تحت لواء »ليبراليون أحرار« بقيادة السيدة شلبية محجوبي، و»حزب العدل والبيان« بقيادة
السيدة نعيمة صالحي.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية24
غم من هذه الترسانة القانونية التي تضمن الحقوق وتأسيس الجمعيات؛ واالنخراط في النقابات واألحزاب السياسية42. وعلى الرالدستورية للمرأة المغربية، تؤكد الباحثة المغربية رقية المصدق، أن المرأة المغربية تعرضت إلقصاء سلطوي لمنعها من دخول الحياة السياسية43، إضافة إلى اختزال دورها في التصويت فقط، دون السماح لها بالنشاط السياسي على المستويات كافة
من القواعد الحزبية والجمعيات، إلى مراكز صنع القرار على رأس السلطة.
في قانون الحريات العامة: صدر بالمملكة المغربية القانون رقم: 1.73.283 بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 1973، المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، لكن القانون يستخدم لفظة شخص للداللة على المرأة والرجل، وال يشير إلى أي تمييز واضح، والمرأة
المغربية تتمتع بحرية إنشاء الجمعيات واالنخراط فيها، والنضال من أجل تحقيق طموحاتها وأهدافها.44
في مدونة االنتخابات: تندرج مدونة االنتخابات ضمن اإلصالحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 1996، التي ينظمها القانون رقم: 97.83 الصادر بتاريخ 02 نيسان/ أبريل 1997.
ونصت هذه المدونة في الفصل الثالث منها على هوية الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في االنتخابات، وهم “المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 20 سنة شمسية كاملة في تاريخ االقتراع، وغير الموجودين في إحدى حاالت فقدان األهلية االنتخابية المنصوص عليها قانونا”، وتنص المدونة صراحة على المساواة بين المواطنين: ذكورا؛ وإناثا، ضمن شروط األهلية المحددة سابقا45. كما تنص مدونة االنتخابات في المادة 41 على تساوي المواطنين المغاربة: إناثا؛ وذكورا، على حق الترشيح في التالية: “ناخبا مغربي الجنسية، بالغا من العمر 23 سنة. وقد عدلت المادة 41 بتخفيضها سن االنتخابات، ضمن الشروط الترشيح إلى 21 سنة فيما بعد46 .مع العلم أن الباب األول من المدونة المادة الثانية، ذكر أن المرأة “ناخبة” مثلها مثل الرجل،
وال يوجد أي مانع يفقدها صفة الترشيح لالنتخابات كالرجل.47
وبالرغم من منح مدونة االنتخابات الحق للمرأة المغربية في االنتخاب والترشيح، إال أن الجمعيات النسائية المغربية طالبت بمراجعة مدونة االنتخابات وإدخال تعديالت واقتراحات عليها لخلق ظروف إيجابية تسمح بتمكين المرأة المغاربية من ممارسة جميع حقوقها السياسية، إذ ما زالت المرأة المغربية غير محمية قانونا من الممارسات الذكورية تجاه منعها أو التأثير في رغبتها في التصويت أو الترشيح. ثم رفعت الجمعيات النسائية المغربية سقف مطالبها لتطالب بتبني قوانين انتخابية منصفة للمرأة، وضمان وضع لوائح الترشيح في إطار “الكوتا” التي تحدد حصصا للمرأة، بنسبة ال تقل عن 20 بالمائة في المرحلة األولى التي تسبق المطالبة بالمناصفة مستقبال، إضافة إلى العمل في النظام االنتخابي بالالئحة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وكانت أربع جمعيات بدأت هذه الحركة المطلبية العام 1996، قبل أن يلتف حولها أكثر من 20 تنظيما غير حكومي العام 2001، أفضى إلى إصدار مذكرة العشرين التي تطالب بمراجعة القانون االنتخابي، لدفع الحكومة ومجلس النواب واألحزاب السياسية إلى تبني قوانين منصفة وعادلة تمنح المرأة فرصا تضمن مشاركتها الحقيقية في الحياة السياسية48. وتعتمد كل من الدول التالية: الجزائر؛ والمغرب؛ وتونس في نظمها االنتخابية المعتمدة في تنظيم االنتخابات التشريعية على المستوى الوطني،
على نظام القائمة النسبية الذي يتواءم وسياسات تمكين المرأة باستخدام استراتيجيات التمييز اإليجابي.
42 - دامية بن خويا، »واقع المشاركة السياسية للمرأة المغربية،« في: المشاركة السياسية للمرأة العربية... تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة )دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا( )تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان، 2004(، ص.426.
43 - رقية المصدق، المرأة والسياسة... التمثيل السياسي للمرأة في المغرب )دار توبقال للنشر، ط.1، 1990(، ص. 17 – 18.
44- دامية بن خويا، المرجع السابق ، ص.427.
45 - دامية بن خويا، المرجع السابق ص.430.
يونيو الرباط، )19 حزيران/ الديمقراطيين، لكل يونيو 2009،« حركة لـ 12 الجماعية االنتخابات النساء في تمثيلية »دراسة حول - 462009(، ص.04.
47 - دامية بن خويا، المرجع السابق، ص.431.
48 - المرجع السابق، ص.432.
25 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
ب ـ التصويت النسوي في المغرب بعد االستقالل: مقارنة بين مرحلتي الواحدية والتعددية السياسية
قامت النساء المغربيات بالتصويت في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد نيل المغرب استقالله عن االحتالل الفرنسي العام 1956، فآنذاك سمح للمرأة بالتصويت والترشح لالنتخاب حسب نص الدستور المغربي، كما شاركت المرأة المغربية في االستحقاق التشريعي ليوم 17 أيار/ مايو العام 1963، وكانت نسبة تمثيل المرأة ال تتجاوز امرأة وحيدة من العام 1963 إلى العام 197949، ورأت الحركات النسوية المغربية أن مشاركة المرأة اختزلت في التصويت، واعتبارها ناخبة بعد االستقالل.
النواب امرأتان في مجلس البرلمانين )وهي بالمائة من مجموع العام 1977 )0.6( انتخابات النساء في نسبة تتجاوز لم العام 1993، إذ سجلت المرأة النسبة نفسها 0.6 بالمائة، بعد تسجيلها نسبة 0 وامرأتان في مجلس المستشارين(، وكذلك بالمائة العام 1984. وبقيت وضعية المرأة المغربية على هذا الضعف إلى ما بعد انعقاد مؤتمر بيجين العام 1995 الذي كان له دور مهم في دفع عجلة خطط ترقية وضع المرأة المغربية. وبعد انتخابات أيلول/ سبتمبر 2002، وصلت 35 امرأة إلى مجلس النواب لترتفع نسبة المشاركة إلى 10.9 بالمائة، وانتقل المغرب إلى المرتبة الثانية عربيا بعد تونس، واحتل المرتبة62 عالميا بعد أن صنف في المرتبة 121، بسبب هذه النتائج الالفتة. ويعود الفضل في هذه النتائج للتعديالت التي طرأت على نصوص القانون التنظيمي الخاصة بمجلس النواب، وكان قد دعا لها المجلس الدستوري في حزيران/ يونيو 2002. وتتلخص في التالي: “اعتماد االقتراع النسبي بالالئحة الوطنية بحيث يتم انتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر االنتخابية المحلية و30 عضوا على الصعيد الوطني”، واالنتقال من نظام االقتراع الفردي إلى نظام االقتراع بالالئحة.50 ونتيجة لهذا التعديل، اتفقت األحزاب المغربية فيما بينها على تخصيص لوائحها الوطنية للنساء لضمان وصول 30 امرأة لمجلس النواب، وتقدم كل حزب بلوائح وطنية تضم 30 اسما للنساء فقط، وأفضت العملية في النهاية إلى تخصيص 10 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة، وهو ما منح المرأة المغربية 30 مقعدا نسائيا في برلمان تشريعيات 2007، إضافة إلى المقاعد الخمسة المتبقية، التي جاءت عن طريق الترشيح في اللوائح اإلقليمية لتحقق نسبة 10.9 بالمائة51. واعتبرت الباحثة دامية بنخويا أن هذه المنحة الحزبية ر مذكرة العشرين، المطالبة بمراجعة القوانين االنتخابية، وتبني نظام اقتراع مستحقة للمرأة المغربية التي كانت المبادرة عبعادل ال يقصي النساء من خالل التخلي عن نظام االقتراع األحادي اإلسمي. وبهذا تكون المرأة المغربية قد نجحت في رهانها بضمان مكانة مستحقة داخل األحزاب السياسية، التي عملت بمبدأ “الكوتا” على تخصيص نسب تمثيل للمرأة تراوحت بين 10 و20 بالمائة. ونجحت المرأة المغربية في تخطي النظام االنتخابي السابق الذي كان يجعل الصراع يشتد داخل األحزاب
للوصول إلى رأس الالئحة، وهو سبب تهميش المرأة ووضعها في ذيل القائمة االنتخابية.
ج ــ اعتماد مقاربة الجندر ومنع التمييز ضد المرأة: النوع والمشاركة السياسية
تجاوز التحفظات وتطوير الميكانيزمات التنفيذية لترقية أوضاع المرأة المغربية
صدقت المملكة المغربية على اتفاقية “سيداو” العام 1993، لكن مع بعض التحفظات على المادة 16 المتعلقة بالمساواة في الزواج والطالق، والفقرة الثانية من المادة 09،الخاصة بنقل الجنسية إلى األبناء، بدعوى تعارضها مع الشريعة اإلسالمية المصدر األساسي للتشريع المغربي. لكن الحكومة المغربية أعلنت في الثامن من نيسان/ أبريل العام 2011، رفعها لتحفظاتها كافة على االتفاقية، ويدخل ذلك في إطار الموازنة بين سيطرة اإلسالميين على السلطة وخشية النظام السياسي في أن يؤدي وصولهم للحكم إلى سياسة راديكالية قد تتسبب في انسحاب المغرب من االتفاقية52. وقد قدم المغرب تقريره األول عن اتفاقية
49 - محمد بنهالل، »المشاركة السياسية للمرأة في المغرب: بين المعوقات وسبل التجاوز،« المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص. 130.
50 - عصام بن الشيخ، المرجع السابق، ص.277.
51 - عبد القادر لشقر، »االنتخابات التشريعية المغربية لسنة 2007: أية مكانة للمرأة في المجالس المنتخبة؟،« المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص. 144 ــ 168.
52 - »المرأة المغربية والربيع العربي، » موقع ربيع المرأة العربية:85%D8%BA%D8%B1%D%84%D9%http://arabwomenspring.fidh.net/index.php?title=%D8%A7%D9≤
≥8%A8&oldid=640
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية26
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، في كانون الثاني/ يناير 200553، وقد اعتبرت الباحثة المغربية دامية بنخويا أنه ما زال يعتري هذه المصادقة وهذا االنضمام نقص؛ ألنها لم تكن مرفقة بإجراءات لضمان تفعيل هذه المواثيق الدولية على مستوى الدستور أو القوانين المغربية األخرى، إضافة إلى تحفظات المملكة المغربية بخصوص هذه االتفاقيات نفسها، كما أن الدستور المغربي ال ينص صراحة على أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي، إضافة إلى عدم مالءمة القوانين الوطنية لمقتضيات هذه االتفاقيات، إذ ال يجري تفعيل القوانين الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين، وال يعطي الدستور األولوية للقانون الدولي بخصوص مكافحة التمييز ضد النساء. ويقتضي األمر خلق انسجام بين القانون الدولي
والوطني لحل هذه المسألة القانونية.54
د ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة المغربية
الحظ الباحث المغربي مختار الهراس أن النساء المغربيات ما زلن مقصيات ومبعدات في ظل هيمنة الرجل على مراكز صنع القرار ونفوذه السياسي؛ واالقتصادي؛ واإلداري؛ والعسكري. فقد شهدت برلمانات: )1963، 1970، 1977، 1984( غيابا واضحا لتمثيل المرأة المغربية، وصوال إلى برلمان 1997 الذي منح المرأة مقعدين. وتعود أسباب ضعف المشاركة النسوية
إلى قلة وجود النساء داخل األحزاب؛ وتطبيق االقتراع األحادي، الذي تم تغييره في ما بعد إلى نظام االقتراع بالالئحة.
ويلخص الهراس األسباب السياسية التي تتسبب في محدودية المشاركة النسوية55 في ما يلي:
ــ انعدام الديمقراطية داخل األحزاب السياسية.
ــ اإلقصاء والتهميش الذي يطال المرأة ويمنعها من الوصول إلى مراكز القرار.
ــ ازدواجية الخطاب الحزبي الذكوري، وعدم توافق مواعيد عمل الحزب مع الظروف الشخصية واالجتماعية للمرأة.
ــ ضعف االقتناع بالقضية النسوية لدى األحزاب، وضعف انسجام النساء داخل الحزب الواحد.
ــ اعتبار القضية النسوية شأنا خاصا بالنساء ال يقبل التدخل الذكوري أحيانا، واعتبار القضية النسوية قضية موسمية تطرح لفترات قصيرة ثم يتم طيها.
ــ غياب آليات االستقطاب وإدماج النساء في الحياة الحزبية.
ــ الظلم الذي يتسبب في ترتيب النساء داخل اللوائح االنتخابية.
ــ ترشيح النساء في أحزاب ضعيفة ودوائر انتخابية تفتقر لإلشعاع الحزبي.
ــ تأثير الثراء المادي على نوعية الترشح في بعض األحزاب التي تتأثر بالواقع االجتماعي.
ويبدو أن القضية النسوية لم تغب عن االهتمام الملكي، كما هو ظاهر دائما في الخطاب الدياغوجي الملكي اإلصالحي، ومن العاهل المغربي، وتدعى “تمكين” التي تقدمت بها األميرة مريم شقيقة المبادرة المرأة، الملكي بقضايا بين نماذج االهتمام Tamkine )2008- 2011( في 30 تشرين األول/ أكتوبر العام 2008؛ بهدف مناهضة العنف المبني على أساس النوع االجتماعي ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتطبيق ميزانيات تراعي مطالب المرأة وتستجيب لمقتضيات مقاربة
النوع االجتماعي للمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما.
هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة المغربية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومراكز صنع القرارحدد الباحث المغربي محمد بنهالل أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة المغربية، في ثالثة أسباب رئيسية: أسباب سوسيو ثقافية، تتمثل في تنميط صورة المرأة Stéréotypes، ومحاولة تكريس األنماط التقليدية في األدوار المجتمعية بين المرأة
53- التقرير الوطني وضعية المرأة بالمغرب... عشر سنوات بعد مؤتمر بيجين )الرباط، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، نيسان/ أبريل 2004(، ص. 23.
54 ـ تقرير حول الوضع اإلنساني للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي في المغرب، برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين في المنطقة المتوسطية )2008 – 2011(، )االتحاد األوروبي بروكسل، أوروميد، تموز/ يوليو 2011(، ص. 38.
55 - المرجع نفسه، ص.26.
27 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
والرجل، وتكريسها؛ وأسباب تتعلق بطبيعة المرأة نفسها وظاهرة “المقاومات الثقافية” التي تكرسها األحزاب في أن الحزب قلما يعترف بحصوله على “التزكية الندرة للمرأة في االستشارات الوطنية”، إضافة إلى التفسير الخاطئ لرأي الدين اإلسالمي حول المرأة، والدور السياسي للمرأة في المجتمع...؛ وأسباب تتعلق بالطبيعة السوسيواقتصادية للمرأة، وتتمثل في انتشار األمية في أوساط النساء، وافتقاد المرأة للخبرة السياسية، والتكوين السياسي الحزبي، وعدم امتالكها الوقت لممارسة العمل
الحزبي56، إذ تحول الحزب إلى “ناد رجالي”، ما يدفع المرأة إلى البحث عن البديل الجمعوي.
النسوية للظاهرة الحزبي التجاهل المدني، جعل المجتمع المغربية تجربة جمعوية. وفي إطار تشكيالت المرأة لقد راكمت غير قابل لالستمرارية57، كما أنه يبشر بقدرة المرأة على نقل تجربتها في الجمعيات إلى الظاهرة الحزبية. وينص الفصل التاسع من الدستور المغربي، على أنه يحق للمغاربة تأسيس جمعيات والحرية في االنخراط ألية منظمة نقابية أو سياسية. واعتمد المغرب في شهر تشرين األول/ أكتوبر 2011 بعد اإلصالح الدستوري– في سياق تحوالت الربيع العربي ــ قانونين أساسيين لتنظيم التمثيل السياسي للمرأة: األول هو القانون رقم 27 ـ 11 المتعلق بمجلس النواب الذي يخصص حصة من 60 مقعدا للنساء من أصل 395 مقعدا؛ أي أنه يحقق نسبة تمثيل نسوي تقدر بـ: 15% استمرارا في تطبيق سياسة التمييز اإليجابي “الكوتا الحزبية”.. وقد تم تسجيل نسبة سوى 4% من الترشيحات النسائية خالل االنتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 من أصل 1521 قائمة محلية، ولم يكن هناك سوى 57 امرأة على رأس القوائم.58 أما القانون الثاني؛ فهو القانون رقم 29 ـ 11، المتعلق باألحزاب السياسية، وقد جاء في نص المادة 26 منه، أن كل حزب سياسي أن يعمل لبلوغ نسبة الثلث للمشاركة النسائية في هيئاته القيادية، ويشجع هذا القانون على مشاركة النساء، لكنه ال يلزم األحزاب السياسية
بوضع حصص59.
و ــ المشاركة السياسية للمرأة المغربية بعد اإلصالحات الملكية 2011
وجدت المملكة المغربية نفسها متأثرة بتحوالت سياق الربيع العربي، فآثر ملك البالد العاهل محمد السادس، تقديم إصالحات دستورية تاريخية تنازل فيها عن جزء من صالحياته للوزير األول، الذي أصبح يختار من األغلبية الفائزة بالبرلمان، وشكلت تلك االلتزامات الملكية سببا في احتدام المنافسة االنتخابية التي أفضت إلى فوز حزب العدالة والتنمية اإلسالمي، بقيادة السيد التناقضات التحول جملة من هذا الملك، وشكل قبل الحكومة، من على رأس أوال نصب وزيرا الذي بنكيران، اإلله عبد بخصوص قضايا المرأة، فمن جهة، تم إدراج زيادة الحصص النسوية في أحزاب لتمكين النساء من الحصول على 60 مقعدا مضمونا في البرلمان بدل 30 السابقة وفقا لنظام “الكوتا” المعمول به منذ العام 2002، لزيادة التمثيل النسوي وضمان انتقاله
من نسبة 10.8 بالمائة، إلى 15 بالمائة60*، وفقا لسياسة “التمييز اإليجابي” لصالح المرأة.
56 - بنهالل، المرجع السابق، ص. 134 – 135.
57 ــ محمد فاضل الكراعي، »المسألة النسائية في المغرب: تحديات الدينامية االجتماعية ومحدودية الرهانات السياسية،« المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص. 95 ــ 107.
58 - »المرأة المغربية والربيع العربي،« موقع ربيع المرأة العربية، المرجع السابق.
59 - المرجع السابق.
60 * - بخصوص تمثيل المرأة المغربية في مجلس المستشارين، توجد 06 نساء أعضاء في مجلس المستشارين المؤلف من 270 مقعدا؛ أي %2.2 من األعضاء. األمر الذي يشكل زيادة من 3 مقاعد مقارنة بالعام 2006.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية28
املشاركة السياسية للمرأة التونسية
دراسة ألوضاع المرأة التونسية خالل ستة عقود: 1956 – 2012
تتمتع المرأة التونسية بحقوق راسخة نجمت عن نضال طويل قامت به الحركة النسوية التونسية قبل االنتقال إلى الديمقراطية تم التي واإلمكانيات الحقوق كم ومستوياتها في حصيلتها تساوي تكن لم السياسية مشاركتها أن غير تونس، في وبعدها أهدافها تنظيم على وقدرة وعيا، العربيات النساء أكثر من كونها في التونسية، المرأة نالتها التي واالستثنائية تحصيلها،
االجتماعية والسياسية ضمن األطر الحزبية والمجتمعية المتاحة..
أ ـ الحقوق الدستورية والسياسية للمرأة التونسية:المرأة التونسية في التشريعات الوطنية: في الدستور: وضعت تونس دستورها العام 1959 الذي تم تعديله مرات عدة في السادس؛ الفصالن: العام 2002. ويتناول األعوام: 1957؛ 1976؛ 1981؛ 1988؛ 1990؛ 1997؛1999 ، وآخرها والسابع من الدستور التونسي الحقوق والحريات في تونس، وينصان على مبدأ المواطنة والمساواة، فكل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما ورد في الفصل الخامس، أن الدولة التونسية تضمن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان. كما أشار الفصل الثامن من دستور 1959 إلى مساهمة األحزاب في تأطير المواطنين لتنمية مشاركتهم السياسية، على أسس ديمقراطية،
تحترم سيادة الشعب؛ وقيم الجمهورية؛ وحقوق اإلنسان والمبادئ التي تحكم األحوال الشخصية.61
لت في المجلة االنتخابية: لم ترد حقوق المرأة التونسية بالوضوح الكافي في الدستور، كما في المجلة االنتخابية، التي فصحق المرأة في االنتخاب والترشح. أما حرية تكوين الجمعيات؛ فهي مكفولة دستوريا في الفصل الثامن؛ والقانون رقم 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959، المنقح في القانون رقم 90 المؤرخ في 02 آب/ أغسطس 1988؛
والقانون رقم 25 المؤرخ في 02 نيسان/ أبريل 1992.
ب ــ التصويت النسوي في تونس بعد االستقالل: مقارنة بين ممارسات مرحلة الواحدية “البورقيبية”، وإصالحات التعددية السياسية
تميزت المرحلة البورقيبية بطغيان الفكر السياسي الواحدي البورقيبي، والرمزية الكبيرة لسيدة تونس األولى السيدة وسيلة ، حرم رئيس الجمهورية، التي كان لها دور مؤثر في قيادة البالد، ومن أعلى المستويات، خصوصا الحكومة، فالسيدة بورقيبة كان لها دور مهم في التأثير في قرارات الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مع ذلك، خدمت السياسات المائلة إلى نمط الحياة الغربية التي كان يفضلها الرئيس بورقيبة، نضال الحركات النسوية، التي ساعدها هذا النهج “الحداثي”، في هيكلة النضال النسوي؛ وتنظيمه؛ وترسيخه. بعد رحيل الرئيس بورقيبة على إثر انقالب أبيض قام به وزير الداخلية زين العابدين بن علي في 07 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987، قامت سيدة تونس األولى ليلى بن علي، بترؤس النضال النسوي للمرأة التونسية ودعمه، حتى أصبح خطاب الحركات النسوية التونسية يحظى بتوجيه رئاسي من أعلى المستويات، خصوصا بعد تولي السيدة بن علي، تمثيل تونس في المنظمات الدولية في مجال قضايا المرأة، وعلى رأسها التمثيل التونسي في منظمة المرأة العربية التي ترأستها
السيدة بن علي، وكانت مكلفة فيها بتمثيل المرأة العربية في ما بعد.
ج ــ المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة التونسيةشهدت تونس العام 1956 إقصاء للنساء من العملية االنتخابية، إذ حصرت صفة الناخب في الذكور، ضمن الشروط التالية: )فوق سن 21 سنة، يحسن القراءة والكتابة(، واستبعدت النساء من الترشح؛ ألنهن ال يحزن باألساس على صفة ناخب62.
61 - سعيد مقدم، »ترقية مشاركة المرأة الجزائر... الواقع والمأمول: يوم دراسي برلماني حول ترقية التمثيل السياسي للمرأة... بين الواقع والتطلعات، الجزائر: )2009/06/29(، النادي الوطني للجيش،« مجلة الوسيط، الجزائر: وزارة العالقات مع البرلمان، العدد: 07، )2009(، ص. 38.
62- سناء بن عاشور، »مشاركة المرأة التونسية في الحقل السياسي،« في: المشاركة السياسية للمرأة العربية... تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة )دراسات ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا( )تونس: المعهد العربي لحقوق اإلنسان، 2004(، ص.108.
29 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
ثم استدرك هذا التمييز في 14 آذار/ مارس العام 1957 بأمر خاص باالنتخابات البلدية، لتشارك المرأة للمرة األولى في االنتخابات البلدية، ثم صدر النص الدستوري لسنة 1959، الذي حدد في فصله العشرين الشروط العامة الناخب: )الجنسية تونسية من 05 أعوام على األقل، يبلغ 20 سنة كاملة(، لكن، بقي اللبس حول جنس الناخب، إلى أن صدرت المجلة االنتخابية، التي وضحت في الفصل الثاني منها رفع اللبس الدستوري لمعنى كلمة “مواطن”، بأنه يعني “ضمان حق االنتخاب لجميع
التونسيين والتونسيات”. وعلى هذا األساس شاركت المرأة التونسية في االنتخابات البلدية؛ والتشريعية؛ والرئاسية.63
د ــ المشاركة السياسية للمرأة التونسية في األحزاب؛ والجمعيات؛ ومراكز صنع القرار
قدرت نسبة المشاركة النسائية في تونس العام 1989 بـ: 13 بالمائة، وارتفعت إلى نسبة 30 بالمائة العام 1994، مع ذلك، سجل عدد من الممارسات التمييزية ضد المرأة في العملية االنتخابية. ولوحظ االزدياد المستمر للعنصر النسوي في صفوف الحزب الحاكم )التجمع الدستوري الديمقراطي(، مقابل التراجع النسبي ألعدادهن في صفوف أحزاب المعارضة، ما يعني أن رؤية الحزب الحاكم كانت مسيطرة على ذهنية الناخب، وأن أحزاب المعارضة قد أخفقت في استقطاب العنصر النسوي
أكثر من الحزب الحاكم.
حق المرأة التونسية في الترشح للمجالس االنتخابية التشريعية: الترشح لعضوية المجالس االنتخابية التشريعية حق مضمون للمرأة التونسية كما الرجل، لكن بعد تحقيق الشروط التالية التي ذكرها الفصل 21 من الدستور، المواد التي تنص على أن الترشح لعضوية مجلس النواب هو حق مكفول لكل ناخب تونسي األبوين، يبلغ على األقل 23 سنة كاملة يوم الترشح، دون
تمييز بين الجنسين. وقد وصلت المرأة التونسية إلى نسبة 11.53 بالمائة في مجلس النواب، وكانت األعلى عربيا.
الجدول رقم )2( يبين عدد النساء التونسيات في مجالس النواب المنتخبة منذ األعوام 1959ـ 1999، ونسبتهن إلى العدد اإلجمالي
وفي ما يتعلق بالترشح للمجالس البلدية في تونس؛ فقد ضبط قانون االنتخابات شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي في الترشح، في الراغبون البلدية، بدائرة الناخبون البلدي بالمجلس “ينتخب بصفة عضو االنتخابية: المجلة الفصل 112 من المؤهلون التونسيين والتونسيات” آنفا هم “جميع العمر 23 سنة على األقل(، و”الناخبون” كما جرى ذكرهم البالغون من
بتحقيقهم لشروط الترشح المحددة في المجلة االنتخابية.
الجدول رقم )3( يبين عدد النساء التونسيات في المجالس البلدية المنتخبة منذ األعوام 1959ـ 1995
63 - المرجع السابق، ص.108.
املصدر: فتيحة السعيدي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة، 2001.
املصدر: فتيحة السعيدي، مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة، 2001
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية30
مشاركة المرأة التونسية في الحكومة والوظائف العليا:
أنشأت تونس العام 1983 وزارة لألسرة والنهوض بالمرأة، وسبق إنشاء هذه الوزارة تأسيس المنظمة الوطنية للمرأة التونسية بوجود وزيرة مناصب التونسية المرأة تقلدت كما الحاكم. الدستوري للحزب ووظيفيا تابعة عضويا وهي ،1956 العام وزيرتين: إحداهما على رأس وزارة شؤون المرأة واألسرة؛ والثانية على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى تعيين كاتبة دولة لدى وزير التجهيز واإلسكان. مع ذلك، يمثل الحضور النسائي في الحكومة ما نسبته 9.25 بالمائة، )وزيرتان
من مجموع 29 وزيرا، و 03 كاتبات دولة من مجموع 25 كاتبا(.
هان على دولة “الحق والقانون”. هـ ــ المشاركة السياسية للمرأة التونسية بعد ثورة يناير 2011: الراتجهت إرادة التونسيين والتونسيات بعد نجاح ثورة 14 يناير 2011، نحو التوافق على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، سريا، حرا ومباشرا، في قطيعة نهائية مع ممارسات وسياسات النظام التونسي السابق المبنية على االستبداد الديمقراطية؛ أساسها مشروعية إرساء إلى الهادفة التونسي، الشباب ثورة لمبادئ ووفاء التونسي، الشعب إرادة وتغييب والحرية؛ والمساواة، وانطالقا من إرادة انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبالد. ووفقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2011، المؤرخ في 10 أيار/ مايو 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. كانت الترشحات تقدم على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين الرجال والنساء. وال تقبل القائمة التي ال تحترم هذا المبدأ إال في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر64. وتنافس على مقاعد المجلس الوطني التأسيسي المقدرة بـ: 217 مقعدا، 1529 قائمة مترشحة، في 27 دائرة انتخابية، وقد احتكر الرجال رئاسة القوائم المترشحة بنسبة 93% ، مقابل 7% نساء، وكان أكبر تمثيل للمرأة في رؤساء القوائم المترشحة بدائرة تونس1،
إذ تمثل النساء 20% من رؤساء القوائم المترشحة.
الجدول رقم )4( يبين عدد النواب، ونسبتهم، حسب الجنس
ا
الجدول رقم )5( يبين عدد النواب، ونسبتهم، حسب الكتل والجنس
64 ـ يرجى مراجعة: الفصل السادس عشر 16 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أيار/ مايو 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
31 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
إن النسبة التي حققتها المرأة بوجودها في المجلس الوطني التأسيسي التي بلغت 28.57 %، كان باإلمكان تحقيق نتيجة أحسن منها لو لم يحتكر الرجال رئاسة القوائم االنتخابية المترشحة بنسبة 93 %، لكن المالحظ أن وجود المرأة كان حاضرا في كل الدوائر االنتخابية داخل الجمهورية التونسية، بمعدل يتراوح بين مقعد واحد وأربعة مقاعد في كل دائرة انتخابية، وهو مؤشر يعكس اإلرادة القوية التي تتمتع بها المرأة التونسية، وقدرتها على فرض وجودها في مؤسسة منتخبة للمرة األولى بطريقة حرة ونزيهة، ستكون مصدرا لكل السلطات الفرعية المنشأة. وما ينبغي الوقوف عنده أيضا، أن حضور المرأة لم يقتصر على الوجود فقط تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي، وإنما أيضا بالتغلغل في اللجان المنبثقة عنه وتركيبة مكتب المجلس ، ليكون دورها فعاال ال حضورا شكليا، إذ تم تنصيب 4 أربع نساء في مكتب المجلس التأسيسي منهن نائبة رئيس المجلس، أما عن
اللجان، فيمكن تقسيمها إلى لجان تأسيسية ولجان تشريعية:
أوال : اللجان التأسيسية: انبثقت عن المجلس الوطني التأسيسي التونسي، 6 ست لجان تأسيسية مهمة، متعلقة بموضوعات أساسية مصيرية وبناءة، فرضت المرأة تنصيبها فيها بكل جدارة، بنسب متفاوتة شملت كل هذه اللجان، وهو أمر لم يتحقق من قبل، ويشكل نقلة نوعية في التعامل مع المرأة التونسية سياسيا، لكن دون أن تتحصل أي امرأة على رئاسة إحدى هذه اللجان.
ففي لجنة التوطئة والمبادئ األساسية وتعديل الدستور: بلغ عدد التمثيل النسوي 9 تسعة أعضاء من أصل 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن نائبة رئيس اللجنة، والمقررة المساعد األول.
لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية: بلغ عدد التمثيل النسوي 5 خمس نساء من أصل 23 ثالثة وعشرين عضوا.
لجنة الحقوق والحريات، 7 سبع نساء من أصل 22 اثنين وعشرين عضوا.
لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعالقات بينهما: بلغ عدد التمثيل النسوي 7 سبع نساء من أصل 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن مقررة اللجنة، والمقررة المساعد الثاني.
لجنة القضاء العدلي واإلداري والمالي والدستوري: بلغ عدد التمثيل النسوي 7 سبع نساء من أصل 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن نائبة رئيس اللجنة، ومقررة اللجنة.
لجنة الهيئات الدستورية: بلغ عدد التمثيل النسوي 6 ست نساء من أصل 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن المقررة المساعد الثاني.
ثانيا : اللجان التشريعية: على عكس اللجان التأسيسية، فإن الدور التشريعي للمرأة بدا واضحا في اللجان التشريعية، ليس بالوجود فقط في هذه اللجان، وإنما برئاسة لجنتين مهمتين هما: لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية؛ ولجنة التشريع العام، هذا فضال عن وجود المرأة في أغلبية اللجان سواء، بوصفها نائبة لرئيس اللجنة؛ أو مقررة للجنة؛ أو المقررة المساعدة.
لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية: بلغ عدد التمثيل النسوي 7 سبع نساء من جملة 21 واحد وعشرين عضوا، منهن رئيسة اللجنة ونائبتها، والمقررة المساعد األول.
لجنة البنية األساسية والبيئة: بلغ عدد التمثيل النسوي 9 تسع نساء من جملة 20 عشرين عضوا، منهن مقررة اللجنة؛ والمقررة المساعد األول؛ والمقررة المساعد الثاني.
لجنة التشريع العام: بلغ عدد التمثيل النسوي 7 سبع نساء من جملة 20 عشرين عضوا، منهن رئيسة اللجنة ونائبتها؛ ومقررة اللجنة؛ والمقررة المساعد األول.
لجنة الشؤون االجتماعية: بلغ عدد التمثيل النسوي 9 تسع نساء من جملة 21 واحد وعشرين عضوا، منهن مقررة اللجنة.
لجنة الشؤون التربوية: بلغ عدد التمثيل النسوي 8 ثماني نساء من جملة 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن مقررة اللجنة؛ والمقررة المساعد األول.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية32
لجنة الطاقة والقطاعات اإلنتاجية: بلغ عدد التمثيل النسوي 3 ثالث نساء من جملة 19 تسعة عشر عضوا .
لجنة القطاعات الخدماتية: بلغ عدد التمثيل النسوي 6 ست نساء من جملة 19 تسعة عشر عضوا .
لجنة المالية والتخطيط والتنمية: بلغ عدد التمثيل النسوي 4 أربع نساء من جملة 21 واحد وعشرين عضوا، منهن مقررة اللجنة.
ثالثا: اللجان الخاصة: انبثقت عن المجلس الوطني التأسيسي لجان خاصة، تهتم بمسائل ظرفية مهمة، كان كذلك فيها وجود للعنصر النسوي، وقد استطاعت المرأة التونسية أن تتقلد فيها أدوارا قيادية .
لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد: بلغ عدد التمثيل النسوي 8 ثماني نساء من جملة 21 واحد وعشرين عضوا.
لجنة شهداء وجرحى الثورة، وتفعيل العفو التشريعي العام: بلغ عدد التمثيل النسوي 4 أربع نساء من جملة 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن رئيسة اللجنة.
اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي والحصانة: بلغ عدد التمثيل النسوي 8 ثماني نساء من جملة 22 اثنين وعشرين عضوا، منهن نائبة رئيس اللجنة؛ والمقررة المساعد الثاني.
أما في ما يتعلق بالحكومة، وجهاز السلطة التنفيذية؛ فالتشكيلة التي أعلن عنها وتزاول مهماتها، جاءت تشكيلة رجالية بامتياز، إذ لم تشتمل األسماء إال على 4 أربع نساء فقط، منهن وزيرتان: وزيرة شؤون المرأة؛ ووزيرة البيئة، وكاتبتان للدولة: كاتبة
دولة لدى وزير تكنولوجيا االتصاالت؛ وكاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة.
مستقبل النضال النسوي املغاربي يف عهد الربيع العربيعرفت تونس تحوال كبيرا بعد ثورة 14 يناير 2011 على إثر االنهيار المفاجئ لنظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي لم يستطع مقاومة انتفاضة الشعب التونسي ضد الظلم و “الحقرة”. وكانت “ثورة الياسمين” في تونس، بداية العهد العربي للتغيير الشعبي السلمي، الذي كان له دور حاسم في انهيار رأس النظام المصري، الرئيس محمد حسني مبارك، في ما بعد. وبهذين البلدين المهمين في العالم العربي، بدأ الغليان الشعبي يتكرر في الجزائر والمغرب، في شكل تظاهرات سلمية، إذ تأسست في الجزائر التنسيقية الشعبية من أجل التغيير، وتأسست في المغرب حركة 20 فبراير، اللتان ضغطتا إلسقاط النظامين الحاكمين في البلدين. وكانت النتيجة إسراع السلطة في البلدين إلعالن مبادرات إصالحية لربح الوقت، تمنع من تحقيق هذا الهدف، وكانت المرأة ومشاركتها السياسية، قضية تطرح بقوة في هذا السياق التاريخي المهم، إضافة إلى الدور الحاسم الذي لعبته المرأة في كل من: تونس؛ والجزائر؛ والمغرب للمطالبة بالتغيير، وكذا التعويل الكبير على األصوات النسوية لبداية مسار
التغيير، ومراقبته، سعيا لنجاح الثورة في تونس، ونجاح اإلصالحات في الجزائر والمغرب.
في تونس، عرفت البالد انتفاضة نسوية شهر آب/ أغسطس 2012، على إثر طرح صيغة قانونية “اعتبرت رجعية” تحدد الشعبي حاليا، المقدم لالستفتاء التونسي الدستور مسودة الفصل 28 من إذ ورد في التونسية والرجل، المرأة بين العالقة واتهمت حركة النهضة التونسية التي تتولى قيادة الحكومة، وتترأس المجلس التأسيسي بأنها تقصد في صياغة المادة، تضمين “صيغة رجعية” معتمدة على نظرية تبعية وشراكة المرأة للرجل، وليس المساواة بين الجنسين التي يتوافق عليها المجتمع الدولي. وقياسا على ما سيحدث في تونس بعد االستفتاء الدستوري، سيحتدم الصراع في تونس في االنتخابات التشريعية المقبلة جال السياسي بين القوى السياسية، وستكون فيها قضايا المرأة في الواجهة، لكون حركة العام 2013، التي سيتطور فيها السالنهضة، متهمة بسعيها للسيطرة الكلية على النظام والسلطة، والتأثير بنهجها الديني على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية
في بلوغ درجة عالية من المساواة بين الجنسين على أرض الواقع.
33 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
في الجزائر، تعتزم الدولة الجزائرية تنظيم انتخابات المحليات نهاية العام 2013، وهي جولة ثانية تعتزم المرأة الجزائرية الفوز بها بعد تحقيق فوز تاريخي بأكثر من 140 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني “الغرفة السفلى للبرلمان”، بنسبة تفوق 30 بالمائة، جعلتها الدولة العربية األولى في التمثيل النسوي، بعد تطبيق القانون اإلصالحي الخاص بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس التمثيلية، ويتوقع أن تكون هنالك رئيسات بلديات في عدد كبير من البلديات التي يبلغ عددها 1540 بلدية في القطر الجزائري، وسيكون العام 2012 – 2013 حافال باإلنجازات التي سترفع من تحدي النضال النسوي الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، فالوزارة المنتدبة التي تقودها السيدة نوارة جعفر، تضغط بقوة لالنفصال بصفة استوزار كامل بعيدا عن الوصاية السياسية واإلدارية والمالية التي يفرضها االنتداب تحت وزارة مستقلة كما يحدث حاليا، كما سيجري افتتاح مركز وطني لألبحاث حول المرأة في مناسبة رئاسة الجزائر لمنظمة المرأة العربية 2012- 2013، كما سيجري طرح قضية “جندرة الميزانية” الوطنية لمنح فرصة لتمكين المرأة على مستوى كل قطاع وزاري، كما حدث في المغرب منذ العام2005 التي النسوية الحركات المزيد من بتأسيس الجديد الجمعيات قانون كما سيسمح العام 2013، إلى الجزائر في تأخر لكنه
ستضاف جهودها لحركات المجتمع المدني في ترقية أوضاع المرأة الجزائرية.
كما ستعرف الحالة المغربية تحوالت متتابعة، على إثر التغيير الذي عرفته السلطة بعد التمكين الملكي لحزب العدالة والتنمية بالتغيير. تطالب زالت ما التي فبراير، 20 لضغوط حركة تجنبا الحكومة، رئاسة من بنكيران اإلله عبد السيد ورئيسها وبخصوص قضايا المرأة، فقد أعلن قبيل تمكين حزب العدالة والتنمية ببضعة أيام رفع المملكة المغربية التحفظات كافة التي التمييز ضد المرأة، وستسعى الحركات سجلت على بعض مواد اتفاقية “ سيداو CEDAW”، للقضاء على كافة أشكال النسوية المغربية إلى إعادة طرح مشروعها لتحقيق المناصفة في التمثيل كما كانت تفعل دائما، وهي التي تسعى إلى تجاوز
نسبة 12 بالمائة من التمثيل على مستوى البرلمان.
مقارنة املشاركة السياسية للمرأة املغاربية يف الدول املغاربية الثالث
سنحاول في هذا المبحث أن نجمل نتائج مستويات المشاركة السياسية للمرأة في كل من: تونس؛ والجزائر؛ والمغرب منذ اعتماد الدول الثالث الخيار التعددي، الذي طبع النضال النسوي، وجعله أكثر مأسسة؛ وتنظيما؛ وتطورا:
أوال: على المستوى الدستوري والقانوني، ما زالت هنالك ثغرات كثيرة تخص الحقوق السياسية والدستورية للمرأة المغاربية، فالمرأة الجزائرية استفادت مؤخرا من قانون اإلصالحات الذي اعتمد نظام “الكوتا” بطريقة نسبية مثيرة للجدل، تعتمد معايير عديدة في ترشيح النساء، إذ ما زال هنالك تفعيل أو إعمال لمعيار خفض نسب التمثيل في المدن المحافظة أو تلك التي تسيطر عليها أعراف تقليدية على النساء، وهي ممارسة استثنائية غير مقنعة وتحتاج إلى تفسير. أما المرأة التونسية، فيبدو أنها قد فقدت بعض مكاسبها السياسية على إثر إعادة صياغة الدستور التونسي في مرحلة ما بعد الثورة “ما بعد بن علي”، وتحديدا الفصل 28 من مسودة الدستور الجديد المزمع طرحه على االستفتاء، فمقارنة مع السنوات األخيرة من حكم الرئيس بن علي كانت حرمه السيدة بن علي ترأس منظمة المرأة العربية، وكان رهان المرأة التونسية على حصد المزيد من المكاسب القانونية، ومع التركة التي خلفها حكم بورقيبة من النهج التغريبي الذي أثر في المرأة التونسية، وكذا أثر في الوجاهة الكبيرة لسيدة تونس األولى السيدة وسيلة بورقيبة، وبعدها السيدة ليلى بن علي التي عملت على توجيه الحركات النسوية في تونس، كان أمل األخيرة منصبا على استثمار هذا الظرف في الحصول على مكاسب سياسية مهمة تدعم خيار تمكين المرأة التونسية من الوصول إلى مراكز صنع القرار. وبالمقارنة مع المرأة المغربية، لم تستطع الحركات النسوية المغاربية استغالل المبادرات األميرية التي تقدم بها القصر الملكي، مثل مبادرة “الله مريم” الموسومة بـ:”تمكين” Tamkine، في حصد مكاسب تؤسس لمطلبية نسوية متجددة وهادفة، وما زال الجدل دائرا وسط الشارع المغربي حول موضوعات ذات أولوية، على عالقة بواقع المرأة المغربية وهمومها اليومية، مثل: قانون األسرة وما يجب أن يتضمنه من تعديالت تراعي حقوق المرأة المغربية، وتعالج قضايا حقوق الزوجات والنسوة القصر وجرائم الشرف... وغيرها من القضايا المهمة، التي لم تستطع األحزاب أن تفتحها
بشكل مستمر وشفاف أمام الرأي العام.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية34
ثانيا: على صعيد التمثيل النيابي، وفي دراسة تمثيل المرأة المغاربية خالل ربع قرن من التجربة الديمقراطية، تعد المرأة التونسية األعلى حصوال على تمثيل يساوي حجم نضالها الجمعوي والسياسي الحزبي المكثف بالمقارنة مع الجزائر والمغرب، وتحقيق مكاسب انتخابية مهمة، بالرغم من الجدل القائم حول عيوب العملية االنتخابية، والتالعب الذي ال يمكن تجنبه بسبب
طبيعة النظام االنتخابي المعتمد في الدول المغاربية.
الجدول رقم )6( أنواع األنظمة االنتخابية في الدول المغاربية- وفق المقاربات الدولية65
IDEA الدولية للدميقراطية واالنتخابات املصدر66: املؤسسة
ففي الحالة الجزائرية تأثرت المرأة الجزائرية بحالة الفراغ الدستوري الذي عرفته البالد عقب وقف المسار االنتخابي العام في حقبة السطح التي طفت على اإلرهابية الحركات النسوية من جانب الرموز من العديد استهداف إلى إضافة ،1991التسعينيات، التي يصطلح على تسميتها في الجزائر، بـ: “العشرية السوداء”، إضافة إلى تأخر منح المرأة الجزائرية البرلمانية فرص التمكين السياسي واالقتصادي والدعم الكافي للوصول إلى مراكز القرار بعد ولوجهن البرلمان، وتحديدا “االستوزار”، الذي يشبه تماما الحالة المغربية، فمعظم الوزيرات اللواتي يجري االستعانة بهن في الحكومة، هن مجرد ديكور يدخل ضمن شكليات الديمقراطية الصورية الخالصية، التي استخدمتها السلطة، باعتبارهن كاتبات لدى الدولة أو وزيرات منتدبات لدى وزارات أو هيئات رسمية عليا تمارس عليهن الوصاية السياسية والمالية، وتجعل من المرأة مجرد “مسؤولة تنفيذية” تحت قيادة الرجل. أما عن الحالة الجزائرية، التي حدث فيها تمثيل نوعي في اآلونة األخرة بنسبة تفوق 30 بالمائة، فهي ال تعني أن المراة الجزائرية قد استطاعت أن تتفوق على نظيرتها في تونس، التي تناضل اآلن نحو المطالبة بـ: “المناصفة في التمثيل البرلماني” الموازي للمناصفة الشعبية، وتحقيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين، ومراعاة احتياجات النوع االجتماعي، وهو ما
تطالب به أيضا الحركات النسوية في المغرب.
والبرلمان، البلديات، مستوى على والمغرب والجزائر؛ تونس؛ من: كل في المرأة تمثيل نسب يبين )7( رقم الجدول والحكومة قبل انتخابات العامين 2011 و 2012 في هذه الدول
65 ـ أندرو رينولدر؛ وبان ريلي؛ وأندرو ايليس، أشكال النظم االنتخابية.... دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات IDEA )تعريب: أيمن أيوب(، )المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات IDEA، 2007(، ص.155-154.
66 - عصام بن الشيخ، »تمكين المرأة المغاربية في ظل النظم االنتخابية المعتمدة: الفرص والقيود«، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، ) نيسان/ أبريل 2011(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص. 270.
، تعزيز القيادة النسائية ودعم مشاركة النساء في احلياة السياسية وفي مسارات اتخاذ القرار في كل من اجلزائر املصدر:ـ واملغرب وتونس للفترة 2008 - 2011، مركز كوثر للدراسات، تونس، ص.03.
35 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
ثالثا: على صعيد النشاط داخل األحزاب: ما زالت المرأة في كل من تونس؛ والجزائر؛ والمغرب، تعاني من اعتبار الحزب مجرد “ ناد رجالي” ال يمكن أن تتحرك فيه المرأة بحرية مطلقة كما الرجل. وبالرغم من وجود نسوة يقدن أحزابا في الجزائر
– عكس الحالتين التونسية والمغربية- منها ما هو عريق على غرار حزب العمال بقيادة السيدة لويزة حنون، وحزبين جديدين اعتمدا بعد اإلصالحات األخيرة في الجزائر بقيادة نساء، غير أن النشاط النسوي داخل األحزاب ما زال ضعيفا، فلوال أحزاب األغلبية التي هي نفسها مضطرة لترشيح النساء في القوائم الحزبية لربما لم تتمكن معظم النائبات اللواتي دخلن البرلمان من الوصول إلى مقاعدهن في البرلمان. إضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق بـ “عدم تصويت النساء للنساء” فالمرأة ال تصوت للمرأة في كل الحاالت المدروسة في: تونس؛ والجزائر؛ والمغرب، خصوصا في المناطق “غير الحضرية” أو المدن البعيدة عن
العواصم، أو في حالة المناطق التي تسيطر عليها الحركات واألحزاب الدينية المتشددة.
رابعا: المرأة المغاربية ومشكلة العزوف السياسي االنتخابي.
تعاني الدول المغاربية منذ العام 2007 من حالة عزوف سياسي وانتخابي تصويتي من جانب المواطنين الذين لم يعودوا يقبلون بنسب كبيرة على صناديق االقتراع، لإلدالء بأصواتهم. وتعد النساء أكثر الفئات التي تمارس هذا العزوف ألسباب عدة، يأتي في مقدمتها “عدم حصول التغيير” واليأس من حصوله، تليهما الظروف االجتماعية الضاغطة التي تزداد اشتدادا وتعقيدا، خصوصا في المواعيد االنتخابية، ناهيك عن ضعف أداء األحزاب وعجزها عن استقطاب الفئات النسوية في برامجها االنتخابية. كما يقابل ذلك عدم قدرة الجمعيات النسوية بأنواعها المختلفة على تعويض دور األحزاب في تأطير النساء وفتح مناقشات جادة حول المطالب النسوية العاجلة واآلجلة، ففي كل من المغرب والجزائر حدث عزوف انتخابي كبير وسط النساء في تشريعيات العام 2007، إضافة إلى تشريعيات 2011 و 2012 في كل من المغرب والجزائر على التوالي، إذ إن االقتراع بنسبة إجمالية لم يصل إلى تغطية رأي غالبية الهيئة الناخبة، أما في تونس، فلم يؤد انهيار نظام الرئيس بن علي إلى حث قطاع كبير من التونسيين الذين آثروا المكوث في بيوتهم على التصويت يوم االقتراع؛ نتيجة ضغط الهموم االجتماعية المتزايد
عليهم، جراء األزمة االقتصادية الوطنية، وانعكاساتها على الصعيد االجتماعي.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية36
اخلامتة
على اإلنسان حقوق مفاهيم الذي عرفته الكبير التطور من استفاد قد المغاربي النسوي النضال أن إلى الدراسة توصلت المستوى العالمي بعد مؤتمر فيينا العام 1993، وحقوق المرأة في مؤتمر بيكين العام 1995، التي تزامنت مع انتهاج النظم السياسية في تونس؛ والجزائر؛ والمغرب الخيار الديمقراطي، الذي سمح بحرية النشاط السياسي والجمعوي النسوي، فقد كانت أولى نتائج إقرار الخيار الديمقراطي تنظيم الحركات النسوية نفسها ورهانها على القنوات التشريعية لتغيير أوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية. فانتقلت المرأة في المغرب العربي من حالة اإلقصاء إلى حالة التصويت دون الترشح، ثم حالة الترشح النوعي والتمكين االختياري، إلى حالة المطالبة بالترشيح الكمي النوعي عن طريق آلية الحصص النسبية “الكوتا”
بأنواعها المختلفة الحزبية؛ والقانونية؛ والدستورية وغيرها.
وإجابة عن السؤال المركزي للدراسة، وهو اإلشكالية التي تبحث ظاهرة المشاركة السياسية للمرأة المغاربية، ومستوياتها، وارتباطها باإلصالحات السياسية المعتمدة في دول المغرب العربي، فقد توصلت الدراسة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة المغاربية، على ارتباط وثيق بالسياق العام لحالة الديمقراطية والحريات في هذه الدول، وأن ترقية الوضع السياسي للمرأة هو نتاج لقناعات النظم السياسية واألحزاب بدور المرأة في الحياة السياسية، إذ إن لإلصالحات السياسية المعتمدة في دول المغرب العربي دورا أساسيا في ترقية الوضع السياسي للمرأة، كما تؤدي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة، دورا مؤثرا في ترقية الوضع السياسي للمرأة المغاربية، خصوصا االتفاقيات والعهود الدولية التي عنيت بقضايا المرأة، وراهنت على رفع مستوى مشاركتها السياسية، فقد واكبت الدول المغاربية هذه االتفاقيات التي تطورت على مراحل عدة نحو المساواة
بين الجنسين؛ ومنع التمييز ضد المرأة؛ ثم القضاء على العنف الممارس ضدها.
بالرغم من ذلك، ما زالت المشاركة السياسية للمرأة المغاربية مرتهنة بتكريس ظواهر اجتماعية وثقافية سلبية أثرت بشكل كبير على الدور السياسي للمرأة، مثل ظواهر: “عدم تصويت النساء للنساء”؛ والعزوف النسوي عن التصويت؛ ومنع المرأة من االستوزار الكامل؛ ومنع المرأة من ولوج بعض قطاعات العمل القتصارها على الجنس الذكوري... وتقع المرأة ضحية هذه الممارسات التي تتطلب جهدا كبيرا لتفكيكها. أما من الناحية القانونية؛ فما زالت التحفظات التي سجلتها الدول العربية عموما، وكل من الجزئر؛ وتونس؛ والمغرب تحديدا، حول بعض مواد اتفاقية “ سيداو “CEDAW “، للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تقف عائقا أمام تطبيق المساواة بين الجنسين في هذه الدول، ناهيك عن إشكالية اعتماد أسبقية تطبيق القوانين الوطنية على القوانين الدولية، التي تعطل ـ إلى حد كبير ـ سير هذه االتفاقيات الدولية وفعاليتها، وتفقدها مضامينها
ومقاصدها الحقيقية، خصوصا وأن القضاء على التمييز ضد المرأة مرحلة أساسية للمطالبة بالمساواة بين الجنسين.
المساعد األول، إلى أن سلوك السلطة الفرعي البحث بخصوص السؤال للدراسة، فقد توصل الفرعية وإجابة عن األسئلة خيار تمكين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة، غير ممكن بدون سياق يحدث فيه انتقال ديمقراطي يؤكد اعتماد التعددية وحقوق الديمقراطية الحريات قيم إعمال دون للمرأة، حقيقي تمكين يحدث أن يمكن ال إذ المغاربية، الدول في السياسية اإلنسان، وهو ما يؤكد صحة الفرضية العلمية األولى للدراسة. أما السؤال الفرعي المساعد الثاني؛ فقد توصلت الدراسة إلى أن “الحصص النسوية/ الكوتا” هي أنسب الطرق لرفع نسب تمثيل المرأة، وزيادة مشاركتها السياسية بطريقة منصفة، لتحضير بيئة يصبح فيها التنافس الديمقراطي بين المرأة والرجل بدون الحصص النسوية ممكننا، إذ يمكن بعدها أن تتخلى المرأة عن االعتماد الكلي على آلية “الكوتا” في المستقبل، إذا حدث تمكين حقيقي للمرأة في هذه الدول، يجعلها قادرة على منافسة الرجل على قدم المساواة والندية والعدالة. وقد توصلت الدراسة بخصوص اإلجابة عن هذا السؤال الفرعي، إلى صحة الفرضية
العلمية الثانية أيضا.
أما السؤال الفرعي المساعد الثالث؛ فقد توصلت الدراسة إلى أن تطور المشاركة السياسية للمرأة المغاربية سيكون نتيجة حتمية في حال توافر سياق ديمقراطي حقيقي يجعل المرأة المغاربية تنعم بتمثيل منصف لها، ويمكنها من التمتع بحقوق الديمقراطية التشاركية والمواطنية الحقيقية، الكفيلة برفع مستوى مشاركتها السياسية، وتطوير نضاالت الحركات النسوية وجهودها في دعم خيارات األغلبية في الدفاع عن الديمقراطية والمطالبة بالمزيد من الحريات، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة أيضا.
37 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
وخلصت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها، أن المشاركة السياسة للمرأة المغاربية أضحت مرتبطة كما ونوعا، بمدى انفتاح السلطة على شرائح وحساسيات المجتمع كافة، ومدى تطور أداء األحزاب السياسية. وتأثرت النضاالت النسوية المغاربية باستمرار بحالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان، واألوضاع االجتماعية واالقتصادية وحتى الثقافية التي مرت بها المجتمعات المغاربية، التي لم تتجاوز تجربتها السياسية التعددية أكثر من ثالثة عقود، وكانت فيها المرأة جزءا من األغلبية التي لم تستطع
أن تعبر عن طموحاتها وآمالها.
ألى أن أهم نتيجة لتضمين قضايا المرأة في اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، وتوصلت الدراسة أيضا هي تحول إدماج مقاربة النوع إلى أحد أبرز المؤشرات المعاصرة للداللة على انفتاح النظم السياسية على مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة، وتخليها عن نزعتها التسلطية التي تهمش المرأة، لكنها ال يمكن أن تزيل اللبس حول حصول توظيف مسألة تمكين المرأة، ضمن جهود تأسيس “ديمقراطية الواجهة الشكلية الصورية”، إذ توجد النساء في المؤسسات الدستورية في البالد، لكن دون أي تأثير، خصوصا على مستوى المؤسسة التنفيذية، التي أثبتت انفصالها التام عن هموم المجتمع عموما، وهموم المرأة خصوصا، وتآكل شرعيتها السياسية والتاريخية. كما توصلت الدراسة إلى أن تطور اعتماد أعلى مستويات صناعة القرار على بحوث ودراسات المرأة، التي أضحت رافدا ومصدرا مهما لتحليل المعلومات ودراسة الظواهر المرتبطة المرأة في أدته الذي والمهم الكبير الدور بعد ومضامينيا، خصوصا تنظيميا يتطور النسوي النضال المرأة، جعل بقضايا الثورات التي شهدها العالم العربي والمغرب العربي تحديدا، في ما أصطلح على تسميته بـ “الربيع العربي”، الذي أكد أنه ال يمكن السماح باستخدام المطالبة بحقوق المرأة وسيلة لتجميل السياسات الصورية والشكلية للنظم السياسية التسلطية، كما أن شرعية االنتقال الديمقراطي، تجعل قضية المرأة غير قابلة للفصل والتجزئة، عن جميع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن العربي، الذي يأمل أن تنتهي تضحيات “الربيع العربي” إلى االنتقال من حالة “الوطنية الخيالية، إلى حالة المواطنية
الضرورية”، حيث يخدم المجتمع الدولة، والعكس صحيح بالضرورة أيضا.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية38
امللخص التنفيذي للدراسة
خاضت الحركات النسوية في: تونس؛ والمغرب؛ والجزائر نضاال طويال لترقية أوضاعها السياسية بعد تبني التعددية السياسية فيها، إذ أظهرت المرأة في هذه الدول رغبتها في مزاحمة الرجل ومنافسته على القيادة والمشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار، والمساهمة في بناء الديمقراطية الناشئة وترسيخها، بما يساعدها على حفظ حقوقها وزيادة نصيبها من منافع العملية السياسية. لذا، فإن سلوك السلطة خيار تمكين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة، غير ممكن بدون سياق يحدث فيه انتقال ديمقراطي يؤكد اعتماد التعددية السياسية في الدول المغاربية، حيث ال يمكن أن يحدث تمكين حقيقي للمرأة، دون إعمال قيم
الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وقد مكنت المشاركة السياسية للمرأة المغاربية ومساهمتها في عملية صنع القرار، خصوصا على مستوى الهيئة التشريعية، من ازدياد أداء المرأة البرلمانية وتطوره، التي تعول عليها الحركات النسوية القتراح مشاريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
غير أن هذه المشاركة ما زالت تصطدم بالعديد من المعوقات التي تمنع المرأة المغاربية من الوصول إلى تحقيق أهدافها.
وما زالت القواعد االجتماعية القائمة على الهيمنة الذكورية البطريركية الظالمة أو المعتقدات الدينية الخاطئة، تعرقل نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار، إذ تكمن الصعوبة الحقيقية في ذلك، في عدم انتشار ثقافة المساواة بين الجنسين، وطغيان والمتمسكة للتحول، الرافضة واالقتصادية والسياسية االجتماعية النظم المجتمعات عن توارثتها التي الجنسي التقسيم بنى بخصوصيتها المجتمعية. لذلك قام عدد من الدول المغاربية – شأنها شأن غيرها من دول العالم - باعتماد “نظام الكوتا” بوصفه حال استعجاليا لمسألة تضاؤل مشاركة المرأة المغاربية في الحياة السياسية، ويشكل هذا االعتماد اعترافا صريحا بأن تجاوز الفوارق الجندرية ليس ممكنا في حالة المنافسة الندية بين الجنسين، نتيجة تكريس الهيمنة الذكورية في المجتمعات المغاربية.تمثل القاعدة التشريعية األداة اإلصالحية األولى ألوضاع المرأة، واإلطار األهم لتمكين المرأة البرلمانية من الوصول إلى المكملة لها، “غير مراكز صنع القرار والتأثير فيها، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، وتعد الدساتير المغاربية والقوانين مكتملة”، وقابلة لإلصالح والتحسين والتطوير بما يحقق المساواة بين الجنسين، ويحقق تمثيال منصفا للمرأة في المؤسسات
الدستورية للبالد.
وتعد الجزائر؛ والمغرب؛ وتونس دوال عضوة في اتفاقية “سيداو CEDAW “ القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، وهي دول مشاركة في مؤتمر بيكين حول المرأة سنة 1995، غير أنها لم تحسم انخراطها الفعلي والنهائي في هذه الجهود؛ بسبب تحفظاتها التي لم تصل في النهاية إلى اإللغاء أو التعديل، بل إلى رفع كل دولة من هذه الدول، بعض تحفظاتها حسب التحوالت الدولية والضغوط الخارجية من جهة، ونتيجة لضغوط الجمعيات النسوية، التي تطالب بااللتزام التام
بتنفيذ المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق السياسية واالقتصادية للنساء.
أساسية نتيجة الحكومة، هو أو رئيس الدولة لمنصب رئيس لقبول نساء مترشحات المغاربية المجتمعات استعداد إن عدم للصورة النمطية التي كرستها السلطات في الدول المغاربية نفسها، حين ترفض منح المرأة استوزارا كامال، وجعلها تحت وصاية رجالية حتى في الهيئة التنفيذية. لذلك تتحمل السلطة جانبا من المسؤولية في كونها غير قادرة على االستثمار في نشر ثقافة التوافق بين الجنسين، وتذليل الفوارق الجندرية التي تحط من قيمة المرأة، خصوصا في مجتمعاتنا المغاربية، التي يحث دينها اإلسالمي على إعالء شأن المرأة وتكريمها من جهة، مقابل الحط من قيمتها ورفض ظهورها صانعة قرار أمام الرأي
العام من جهة أخرى.
انتقلت المرأة في تونس؛ والجزائر؛ والمغرب، من حالة اإلقصاء إلى حالة التصويت دون الترشح، ثم حالة الترشح النوعي والتمكين االختياري، إلى حالة المطالبة بالترشيح الكمي النوعي عن طريق آلية الحصص النسبية “الكوتا” بأنواعها المختلفة الحزبية والقانونية والدستورية وغيرها. لذلك توصلت الدراسة إلى أن “الحصص النسوية” آلية “الكوتا”، هي أنسب الطرق لرفع نسب تمثيل المرأة، وزيادة مشاركتها السياسية بطريقة منصفة، لتحضير بيئة يصبح فيها التنافس الديمقراطي بين المرأة والرجل بدون الحصص النسوية ممكنا، إذ يمكن بعدها أن تتخلى المرأة عن االعتماد الكلي على آلية “الكوتا” في المستقبل، إذا
حدث تمكين حقيقي للمرأة في هذه الدول، يجعلها قادرة على منافسة الرجل على قدم المساواة والندية والعدالة.
39 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
وتتمثل النتيجة األهم لتضمين قضايا المرأة في اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول المغاربية، في تحول إدماج مقاربة النوع إلى أحد أبرز المؤشرات المعاصرة للداللة على انفتاح النظم السياسية على جميع مكونات المجتمع وشرائحه وفئاته، وتخليها عن نزعتها التسلطية التي تهمش المرأة، لكنها ال يمكن أن تزيل اللبس حول حصول توظيف مسألة تمكين المرأة، البالد، لكن الدستورية في النساء في المؤسسات الواجهة الشكلية الصورية”، حيث توجد ضمن جهود تأسيس “ديمقراطية دون أي تأثير، خصوصا على مستوى المؤسسة التنفيذية، التي أثبتت انفصالها التام عن هموم المجتمع عموما، وهموم المرأة
خصوصا، وتآكل شرعيتها السياسية والتاريخية.
أن كما التسلطية، السياسية للنظم تجميلية أو ترقيعية عملية ليس للمرأة السياسي التمكين أن العربي”، “الربيع أكد لقد بها يتمتع أن يجب التي كافة الحقوق عن والتجزئة، للفصل قابلة غير المرأة قضية تجعل الديمقراطي، االنتقال شرعية المواطن العربي، الذي يأمل أن تنتهي تضحيات “الربيع العربي” إلى االنتقال من حالة “الوطنية الخيالية، إلى حالة المواطنية
الضرورية”، إذ يخدم المجتمع الدولة، والعكس صحيح بالضرورة أيضا.
املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية40
املرفقات
الدراسات السابقة:
السنوات في والمغاربية العربية المنطقة في النسوية السياسية المسألة عالجت التي المهمة واألكاديمية البحثية الدراسات األخيرة من العقد الماضي 2000 - 2010:
التنمية السياسية المحلية وعالقتها بأنظمة الباحثة “نعيمة سمينة”، الموسومة بـ: “دور المرأة المغاربية في أوال: دراسة الحكم... )نماذج مختارة: الجزائر، تونس، المغرب(”، والمنجزة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة المغاربية المرأة أن أوضاع إلى الدراسة ـ 2011(. وتوصلت الجامعي: )2010 الموسم الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة المغاربية اعتمدت الدول أن حكومات إنه رغم إذ المغاربية، الدول المحلية في المستويات المعتمدة في التنمية أنماط تتبع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة، إال أن رهان نجاحها على المستوى المحلي، يتوقف على مدى قدرة صناع القرار على
المستوى المحلي على إنجاح تمكين المرأة، خصوصا المرأة الريفية، التي لم تحصل على حقها في التنمية المحلية.
تانيا: دراسة الباحثة “شعبان نادية” الموسومة بـ: “موقع الحركة النسوية بين العالمين العربي والغربي”، الصادرة عن كلية العلوم السياسية واإلعالم بجامعة الجزائر العام 2008، التي توصلت بعد دراسة مقارنة للحركة النسوية في العالمين: العربي؛ البيئة االجتماعية والسياسية أهم متغير يتوقف عليه نمط العمل السياسي للحركات النسوية، وأعطت والغربي، إلى اعتبار بحثيا على الحركات النسوية العربية، مقابل نموذج الحركات النسوية في العراق والجزائر بوصفهما نموذجا الباحثة مثاال إنجلترا وفرنسا في الغرب. ورغم حداثة هذه الدراسة، إال أنها ركزت على الدور االجتماعي للحركات النسوية في النماذج المدروسة، وقد الحظت الباحثة قلة األبحاث المتخصصة في البحث عن الدور السياسي للمرأة في دول المغرب العربي، ودور
مقاربة الجندر في تحول الدور السياسي للمرأة المغاربية.
التحرير السياسي: حزب جبهة المجال الجزائرية في المرأة “مشاركة بـ: الموسومة الباحثة “جميلة خيذر” ثالثا: دراسة الوطني، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حركة حمس”، والصادرة العام 2003 بكلية العلوم االجتماعية في جامعة الجزائر، التي توصلت إلى اعتبار أن التدهور االجتماعي ألوضاع المرأة الجزائرية، أهم أسباب عدم نجاحها السياسي، خصوصا داخل األحزاب، مهما كان نوعها، وطنية قومية، أو إسالمية، أو ديمقراطية. لكن هذه الدراسة بقيت محصورة في نطاق المشكلة البحثية والعالقة السببية المحدودة بين دور الوضع االجتماعي في التأثير على الدور السياسي للمرأة الجزائرية،
ناهيك على اقتصارها على دراسة حالة مغاربية واحدة فقط.
رابعا: دراسة الباحث “محمد األمين لوعيل” الموسومة بـ: “المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري”، الصادرة بكلية الحقوق والعلوم اإلدارية جامعة الجزائر العام 2001، التي بحثت مسألة مكانة المرأة في قانون األسرة الجزائرية، ومدى تطابق القواعد القانونية الواردة في قانون األسرة مع الدستور من ناحية الحقوق و الواجبات، وهي زاوية بحث قانونية مفيدة في معرفة مدى تأثير الوضع القانوني للمرأة الجزائرية في نمط السياسات المتبعة من قبل الحكومة، اعتمادا على الدستور بوصفه وثيقة مرجعية، ودور االتفاقيات الدولية في وضع تحديات ورهانات فرضت تغيير القوانين الوطنية المتعلقة بالمرأة واألسرة والطفل، بالرغم من التحفظ الذي نجم عن محاولة تطوير قانون األسرة دون المساس بالقيم اإلسالمية التي تعد من
مصادر التشريع الجزائري.
خامسا: دراسة الباحث “محمد ترشين” الموسومة بـ: “التنشئة االجتماعية وبناء اتجاهات التحرر عند المرأة الجزائرية”، الصادرة بكلية العلوم االجتماعية في جامعة الجزائر العام 2007، التي بحثت أهم العوامل التي تدفع بالمرأة إلى تبني االتجاه المرأة، على اختيارها التي تحملها التنشئة االجتماعية واالتجاه اإليديولوجي والتصورات الدراسة بين التحرري، وربطت نماذج عن المرأة الغربية والعربية والجزائرية، وخلصت الدراسة إلى اعتبار التنشئة االجتماعية االتجاه التحرري، معطيا أهم عامل داخل في بناء اتجاه المرأة التحرري، إذ خلصت الدراسة في األخير إلى أن التنشئة االجتماعية تعد عامال مهما في
بناء اتجاه المرأة التحرري.
41 املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية
سادسا: دراسة الباحث “يوسف بن يزة”، الموسومة بـ: “التمكين السياسي للمرأة وأثره في تحقيق التنمية اإلنسانية في العالم العربي: دراسة في ضوء تقرير التنمية اإلنسانية العالمية 2003”، مذكرة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، الموسم الجامعي: )2009 ـ 2010(. ودرست هذه المذكرة مفاهيم تمكين المرأة ودورها في دعم التنمية، وتمتاز هذه الدراسة بالدقة والحداثة،
وقدرتها على تحليل أوضاع المرأة العربية في ضوء تقرير التنمية البشرية في العالم العربي.
دة الدستور الفلسطيني: حقوق اإلنسان يف مسو
مدى التوافق مع الشرعة الدولية حلقوق اإلنسانومقرتحات للتطوير
فريق البحث:
د. مصطفى مرعي )رئيسا(طارق عطيةنرمين صيام
تموز/ يوليو 2012
دة الدستور الفلسطيني44 حقوق اإلنسان يف مسو
فريق البحث
د. مصطفى مرعي، حائز على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ألستر بالمملكة المتحدة. وهو محام فلسطيني، مهتم بقضايا حقوق اإلنسان منذ أكثر من عقدين من الزمن ، عمل خاللهما في أعرق مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية، منها: مؤسسة الحق؛ والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم(. بدأ د. مرعي التدريس في جامعة بيرزيت - برتبة أستاذ مساعد غير متفرغ - منذ حوالي عشر سنوات، كما انخرط في مساندة القضاء من خالل نشاطات هادفة لتعزيز استقالله، كان آخرها مبادرة تعزيز استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية )كرامة( التي احتضنها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت خالل لم، آخرها دراسة صدرت في الفترة من العام 2007-2012. وله كتابات كثيرة تناولت حقوق اإلنسان في وقت الحرب والس
منتصف العام 2011 حول أفضل السبل لصياغة دستور ديمقراطي فلسطيني.
الباحث طارق عطية، درس حقوق اإلنسان في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وتولى، من خالل مبادرة تعزيز استقالل القضاء والكرامة اإلنسانية )كرامة(، متابعة الجوانب البحثية في عملية التدريب القضائي لدى المعهد القضائي الفلسطيني. منذ مطلع العام 2012، انضم للمعهد القضائي الفلسطيني، بوصفه متدربا ضمن أول دورة من برنامج دبلوم الدراسات القضائية، ومدته عامان.
الباحثة نرمين صيام، محامية ممارسة، وخريجة برنامج ماجستير الديمقراطية وحقوق اإلنسان في جامعة بيرزيت. وباحثة في قضايا المساواة والنوع االجتماعي.
45 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
الئحة احملتويات
47الملخص التنفيذي
48المقدمة
49المبحث األول: لماذا حقوق اإلنسان في الدستور؟
49أوال: محتوى الدستور عموماثانيا: الحاجة إلى شرعة وطنية لحقوق اإلنسان
49
51المبحث الثاني: هوية فلسطين في مسودة فلسطيندة دستور فلسطين 51أوال: تاريخ مسو
دة الدستور 51ثانيا: مكونات مسودة الدستور 52ثالثا: الدين وحقوق اإلنسان في مسو
53دولة دينية
دة الدستور )مع التركيز على حقوق الفئات المهمشة( 55المبحث الثالث: حماية حقوق اإلنسان في مسودة الدستور 55أوال: حقوق اإلنسان في مسو
دة الثالثة للدستور الفلسطيني 55ثانيا: الفئات المهمشة في المواثيق الدولية وفي المسو
59المبحث الرابع: الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان وآليات حمايتها
59أوال: الضمانات الدستورية عموما60)1( الضمانات الدستورية العامة
60)2( الضمانات الدستورية الخاصة
دة الدستور الفلسطيني. 60ثانيا: ضمانات حقوق اإلنسان في مسو60)1(: نظام الحكم
61)2(: االلتزام الدستوري بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية62)3(: دور السلطة التشريعية في ضمان احترام حقوق اإلنسان
62)4( تعديل الدستور63)5(: استقالل القضاء63)6(: ضمانات أخرى
64ثالثا: اآلليات الدستورية لحماية حقوق اإلنسان64)1(: الحماية القضائية65)2(: رقابة المؤسسات
)3(: تقديم العرائض والشكاوى66
67التوصيات
47 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
امللخص التنفيذي
هذه دراسة تتناول مسألة مكانة الدين في الدستور، وأثر المعادالت المختلفة المتبعة في هذا الخصوص في فرص تمتع الناس بحقوقهم في ظل هذه المعادالت.
دة الدستور الفلسطيني الثالثة تتبنى التوافق مع الدين بشكل انتقائي. فالدولة التي يرسم الدستور وخلصت الدراسة إلى أن مسومعالمها هي ديمقراطية علمانية، لكنها لم تغفل دور الدين بوصفه مكونا أساسيا من هوية الشعب الفلسطيني. لكن من الصعب دة ذات العالقة، إذا ما طمحت بعض الحركات اإلسالمية لصيغة أقرب لشعاراتها االنتخابية، التكهن بمصير نصوص المسو
قد تقودنا باتجاه الدولة الثيوقراطية.
دة الدستور الفلسطيني حازت على درجة وفي ما يختص بحقوق الفئات المهمشة، والنساء خصوصا، فمن المالحظ أن مسومتقدمة بين الدساتير العربية بمنحها حقوقا مهمة وأساسية للمرأة، وبخاصة منحها مساحة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية. دة من إجراءات إيجابية وخطوات هادفة للقضاء على التمييز بين الجنسين، إال أن هذه ومع اإلقرار بأهمية ما ورد في المسوالبنود تظل غير كافية، بل ال بد من إعادة صياغة حقوق المواطنين وواجباتهم بال تمييز، بحيث ال تكون أصال مرتبطة بالنوع
االجتماعي، سواء أكان ذكرا أم أنثى.
دة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطيني وآليات حمايتها وحول ضمانات حقوق اإلنسان الدستورية المنصوص عليها في المسووالحفاظ عليها، يتضح أن واضعي الدستور قد اجتهدوا في شموله على ضمانات دستورية مهمة، تعد – إذا ما تم تفعيلها على الوجه الصحيح واحترامها من سلطات الدولة- ضمانات أساسية لبناء دولة القانون المستندة إلى احترام حقوق اإلنسان وحرياته دة أخفقت في بعض الجزئيات، ومنها ما يتعلق بتحديد موقع معاهدات حقوق اإلنسان بالنسبة للقانون الداخلي؛ العامة. لكن المسو
وتعديل الدستور؛ واختصاصات المحكمة الدستورية.
دة الدستور الفلسطيني48 حقوق اإلنسان يف مسو
املقدمة
تأتي هذه الدراسة في وقت يزداد فيه الحراك الفلسطيني الهادف إلنهاء االنقسام الذي تبع انتخابات المجلس التشريعي العام تأتي بعد أكثر من عام على بدء ثورات في عدد من دول الجوار، كان في صلب مطالبها إجراء إصالحات 2006. كما دستورية؛ ورفض النتهاكات حقوق اإلنسان التي استمرت عقودا في بعض الحاالت. كل هذا يجعل من هذه الدراسة فرصة بحقوق المتعلقة الدولية المعايير االعتبار في يأخذ بشكل الفلسطيني، الدستور دة مسو لتطوير الرامية الجهود في لإلسهام
اإلنسان، والتجربة العربية الحديثة في هذا الخصوص.
قد نتفهم تركيز األحزاب والمجموعات واألطر السياسية في معرض بحث بنود الدستور وتطوير أحكامه على تلك الجوانب المتعلقة بتداول السلطة، وتوزيع السلطات وتقاسمها، ورقابة كل منها على سواها. ويشمل هذا توزيع الصالحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، وسلطة حل البرلمان، وسلطة التشريع في ظل وجود و/أو غياب البرلمان، وغيرها من الموضوعات التي كانت موضع خالف خالل الفترة الماضية. لكن اهتمام هذه الدراسة ينحصر في باب حقوق اإلنسان وحرياته. وتهدف أيضا دة األخيرة المتوافرة )الثالثة المنقحة( مع المعايير ذات العالقة في الشرعة الدولية لحقوق إلى فحص مدى توافق أحكام المسواإلنسان. وستتناول الدراسة ـ إلى جانب أوجه االختالف أو النقص ـ توصيات لسد الفجوات التي يمكن للجهات المختصة
النظر فيها ودراستها.
وألن حقوق اإلنسان كثيرة، وتتناول كل جوانب الحياة، فقد اخترنا التركيز على جوانب من باب حقوق اإلنسان والحريات أبرزتها الثورات في المحيط العربي، وظهر جليا أنها في صلب الحراك والمطالب الشعبية، أو ظهر أنها من القضايا الخالفية دة لمسألة الدين باعتباره جزءا من الهوية ومصدرا األساسية في مرحلة ما بعد الثورة. وتشمل هذه القضايا: معالجة المسوللتشريع؛ كما تشمل حماية األقليات، والفئات التي قد تكون بحاجة لحماية خاصة مثل: النساء؛ واألطفال؛ وذوي االحتياجات
الخاصة.
دة الدستور لآلليات التي تضمنها الدستور لمعالجة قضايا وخروقات حقوق اإلنسان، كما ستتناول الدراسة كيفية معالجة مسوخصوصا وأن ما يهم المواطن والوطن ـ في نهاية المطاف ـ ليس ورود نص على حقوق اإلنسان في الدستور فقط ؛ بل وجود آليات وسبل لتنفيذه وضمان احترامه. لهذا ستتناول الدراسة دور القضاء؛ والمحكمة الدستورية خصوصا؛ ودور الهيئة الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، بهدف الخلوص إلى مقترحات للتطوير تعزيزا لفرص احترام حقوق اإلنسان وحرياته عمال
وليس نصا فقط.
49 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
املبحث األول: ملاذا حقوق اإلنسان يف الدستور؟
أوال: محتوى الدستور عموما
الدستور هو القانون األساس واألعلى للدولة. ويرى بعضهم فيه وسيلة تربط الشعب في إقليم معين معا برابط قانوني.1 فمن خالل الدستور تتفق جماعة سكانية معينة على طريقها نحو المستقبل، وعلى هذا النحو يعد الدستور الموطن الطبيعي للعقد االجتماعي. ويرى بعضهم اآلخر فيه وسيلة أساسية لتقييد سلطة مؤسسات الدولة، من خالل ضمان حقوق مواطنيها.2 كما يرى
فريق آخر أن الدستور هو الوسيلة التي يقرر من خاللها شعب ما أن يحقق تنميته المستدامة.3التي الدستور والقضايا قائمة متفق عليها بشكل عام لمحتوى فإن هناك للدستور، المختلفة التعريفات النظر عن وبصرف
يعالجها، وهذه تشمل:
الهوية: فالدستور يحدد عادة اسم الدولة؛ وإقليمها؛ وعلمها؛ وطابعها؛ وعالقاتها مع الجوار. . 1 نوع الحكومة وطابعها: يبين الدستور أيديولوجية الدولة السائدة، كأن يقول إنها اشتراكية؛ أو ليبرالية؛ أو برلمانية؛ . 2
أو رئاسية... كما يحدد ـ في بعض األحيان ـ دين الدولة. ويتضمن كذلك بيان العالقة بين السلطات المحلية واإلقليمية، مثل: الفدرالية؛ واالتحاد ... وغيرهما.
الفصل بين السلطات: تتولى الدساتير عادة تحديد عالقة السلطات المختلفة: التنفيذية؛ والتشريعية؛ والقضائية، بعضها . 3مع بعض.
ضمانات حقوق اإلنسان واآلليات والضوابط ذات العالقة. . 4نظامها . 5 في الدولية االتفاقيات ومكانة األخرى؛ الدول مع العالقات أسس بيان الدساتير تتولى الدولية: العالقات
القانوني. شروط وضوابط وقف العمل بالدستور: تأتي هذه عادة في أحكام حالة الطوارىء. . 6
ثانيا: الحاجة إلى شرعة وطنية لحقوق اإلنسان للسلطة، بأهمية التناغم مع في ظل سهولة التواصل وثورة المعلومات، يزداد اإلقرار، حتى من أكثر أنظمة الحكم تركيزا التطلعات الشعبية، واالهتمام بالقبول واالنسجام مع اإلقليم والعالم، أو محاولة الوصول إلى ذلك. في هذا السياق، يمكن النظر للدستور بوصفه وسيلة يعرض الشعب من خاللها رؤيته لمستقبله؛ ووجهته؛ وأهدافه؛ وأدواته عبر وسائل أهمها الدستور. لهذا قد نرى أن الدستور يؤدي بالنسبة للشعب كمجموع ما تؤديه السيرة الذاتية للفرد. فيعرض الشعب من خالله ، وعبر مؤسساته
وممثليه، على المأل: هويته؛ ومكوناته؛ وتجربته؛ ومبتغاه؛ والطرق التي يتبعها للوصول إليها؛ وغير ذلك. أما في ما يتعلق بفلسطين، وشعبها الذي ما زال يناضل من أجل الحرية وتأسيس دولته، ولما يصل بعد مرحلة يعترف بها David Forsythe عدد كاف من الالعبين الكبار على مستوى السياسة الدولية، فربما يمكن اإلفادة مما قاله ديفيد فورسايثحول أهمية حقوق اإلنسان ودورها في الدستور. إذ يقول فورسايث إن "عوامل حقوق اإلنسان، الوطنية منها والدولية، يمكنها ـ في بعض األحيانـ التأثير في شرعية الحكم". ووفقا لفورسايث، فقد: "أصبحت حقوق اإلنسان جزءا من القانون والدبلوماسية
الدوليين، يعد االلتزام بها مصدرا دوليا للشرعية األخالقية".4
1 Donald L. Robinson, ”The Comparative Study of Constitutions: Suggestions for Organizing the In-quiry,“ Political Science and Politics 25, 2 )1992(: 272.
2 Vijayashri Sripati, ”Constitutional Politics in the Middle East - With Special Reference to Turkey, Iraq, Iran, and Afghanistan,“ Human Rights Quarterly 30, 4 )2008(: 1015.
3 Michael C. Davis, ”East Asia After the Crisis: Human Rights, Constitutionalism, and State Reform,“ Human Rights Quarterly 26, 1 )2004(: 126.
4 David P. Forsythe, Human rights and peace: international and national dimensions, Lincoln and Lon-don, University of Nebraska Press, 1993, pp 79-81, hereafter Forsythe )1993(.
دة الدستور الفلسطيني50 حقوق اإلنسان يف مسو
وال نقصد من خالل هذا القول إن الحاجة ألن يتضمن الدستور نصا على قضايا حقوق اإلنسان، تأتي من قبيل تلبية متطلبات الشرعية السياسية على المستوى الدولي فحسب. بل إن تبني "شرعة وطنية لحقوق اإلنسان" والنص عليها وعلى آليات تنفيذها في دساتير الدول، هما من نتاج التطورات في حقل حقوق اإلنسان التي شهدناها في العقود الماضية، بصرف النظر عن
الجوانب السياسية – الدبلوماسية.
ربما يحاجج بعض الناس بالقول؛ إنه ال يمكن فهم دواعي تضمين الدساتير أحكاما متعلقة بحقوق اإلنسان، بالنظر لمصادقة كثير من جوانبها عن حقوق في تكشف التي اإلنسان، بحقوق المتعلقة الدولية والمواثيق المعاهدات الدول على كثير من أصبحت في عداد العرف الدولي، ومن ثم تعد الدول جميعها ملزمة بها من دون الحاجة إلى نص. لكن الحقيقة المرة تبقى أن النص على الحقوق في المعاهدات الدولية قد ثبت أنه قاصر عن توفير الحماية المطلوبة لحقوق اإلنسان في الممارسة. وهناك إدراك أن األولوية في معالجة حقوق اإلنسان سواء من ناحية النصوص أو آليات التطبيق وضماناتها، يجب أن تكون للمحلية منها. لهذا تلجأ بعض الدول لعالج هذا الخلل من خالل تبني وثائق وطنية خاصة بحقوق اإلنسان، أو تضمين شرعة حقوق
اإلنسان الوطنية في الدساتير الوطنية وغيرها.
فحسب فيل ألستون Phil Alston، تتضمن ما نسبته 82% من الدساتير التي صدرت خالل األعوام من 1948-1788، وما نسبته 93% من الدساتير التي صدرت خالل األعوام من 1949-1975 نصوصا متعلقة بحقوق اإلنسان.5 ويشير هذا بوضوح إلى زيادة االهتمام بتضمين الدساتير الحديثة نصوصا تعالج حقوق اإلنسان صراحة، لدرجة أن أكثر من تسع دول من بين كل عشر دول تبنت خالل الفترة األخيرة دساتير عالجت في دستورها قضايا حقوق اإلنسان. ولم تكن الدول ذات الدساتير المكتوبة هي الوحيدة في هذا التوجه. بل إن دوال ال تتبنى دساتير مكتوبة، قامت بإصدار وثائق لحقوق اإلنسان. فقد تبنت المملكة المتحدة في العام 1998، تشريع حقوق اإلنسان، الذي عملت من خالله على تضمين االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان في قانونها الوطني.6 وفي هذا يقول ألستون:
"خالل العقد األخير وحده7 تبوأت شرعة حقوق اإلنسان أهمية كبيرة ومتجددة، في عدد كبير جدا في مختلف أرجاء المعمورة. بعضها صدر عن مجالس تأسيسية وآخر عن برلمانات منتخبة، أو ضمت للتشريع الوطني من خالل معاهدات دولية، أو أدخلها القضاء للتشريع. بهذا ازداد عدد حاالت تبني شرعة حقوق اإلنسان وأهميتها أيضا )من الناحية الرسمية على األقل(
بشكل ملحوظ." 8
وبالرغم من عدم وجود تعريف محدد لشرعة حقوق اإلنسان الوطنية، إال أن مكوناتها المعتادة تضم الحقوق األساسية التي ترد في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، ومنها: الحق في الحياة؛ ومنع التعذيب؛ وحظر االعتقال التعسفي؛ وحرمة الحياة الخاصة؛ وحرية المعتقد والتعبير والتملك والتجمع واالجتماع.9 وفي كل األحوال، فإن قائمة حقوق اإلنسان التي ال يجوز التحفظ عليها
non-derogable rights تشكل أساس أي وثيقة من هذا النوع، ويمكن الزيادة عليها حسب األحوال.10
5 Philip Alston, ‘A framework for the comparative analysis of bills of rights’, hereafter Alston, 2000, in Philip Alston, )ed.(, Protecting human rights through bills of rights, Oxford University Press, 2000, pp 1-14, at p 3, hereafter Alston )2000a(, citing Van Maarseveen and van der Tang, Written constitutions: a computerized comparative study, 1978, pp 191-195.
6 On this see Alston )2000(, Alston )2000a(, and James Young, ‘The politics of the Human Rights Act’, Journal of Law and Society, Vol. 26 )1(, 1999, pp 27-37, hereafter Young )1999(.
7 المترجم: يقصد قبل العام 2000.
.Alston )2000(, p 1 8
.Alston )2000(, p 2 9
.Alston )2000(, p 10. Footnote omitted 10
51 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
دة الدستور املبحث الثاين: هوية فلسطني يف مسو
دة دستور فلسطين أوال: تاريخ مسو
دة األخيرة لدستور فلسطين، ومن أين أتت، كونها تمثل حلقة من حلقات عدة في مسلسل طويل من نتناول هنا تاريخ المسودة لدستور الدولة الفلسطينية العتيدة. وكلنا أمل أن تؤدي هذه الجهود قريبا إلى إنجاز دستور لدولة عمليات هدفت لصياغة مسووآليات تساعد في إنصاف من يشتكون من انتهاك فلسطين، تكون ديمقراطية، تصان فيها الحقوق، ويوفر دستورها مناخا
حقوقهم والتعدي على كرامتهم.
دة الدستور يعود للعام 1988، حينما تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته في الجزائر إعالن االستقالل. فتاريخ مسوعندها شكلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لجنة لصياغة دستور لدولة فلسطين. 11 لكن ال أثر ألي نتاج لهذه اللجنة، وإن كان مجرد تشكيلها قد يعد مؤشرا على وعي القيادة الفلسطينية بالحاجة لدستور للدولة الفلسطينية حال تشكيلها. وقد بقي الحال هكذا، من دون حراك في ما يتعلق بالدستور، إلى ما بعد توقيع اتفاق إعالن المبادىء الفلسطيني - اإلسرائيلي العام 1993. فقد دات قررت منظمة التحرير الفلسطينية، بعد توقيع االتفاق، تشكيل لجنة مهمتها صياغة دستور لفلسطين. وكانت نتيجة المسوالمختلفة التي أنتجتها اللجنة نص القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني العام
1997، ودخل حيز النفاذ بعد توقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات عليه ونشره في العام 12.2002
دة دستور الدولة الفلسطينية، وحيث اتفق في إعالن المبادىء على انتهاء الفترة االنتقالية في العام 1999، بدأ التحضير لمسودة الثالثة )المنقحة( التي كان متوقعا أن تقام بنهاية المرحلة االنتقالية. 13 وأنتجت مسودات عدة من الدستور، كان آخرها المسوفي شهر أيار/ مايو من العام 14.2003 لكن األحداث التي شهدتها القضية والساحة الفلسطينية منذ ذلك الحين، لم تتح المزيد من التقدم في هذا المجال. وبقي الحال هكذا حتى العام 2011، حينما عاد اهتمام القيادة الفلسطينية بإنجاز دستور لفلسطين.15
دة الدستور ثانيا: مكونات مسو
دة الثالثة( ليوم الرابع من أيار/ مايو 2003، وهي نسخة منقحة ومختلفة دة الحالية لدستور فلسطين )المسماة المسو تعود المسودة الثالثة ينصرف دة الثالثة، صدرت في 36 آذار/ مارس 2003. لهذا فإن حديثنا عن المسو قليال عن أخرى مسماة أيضا المسو
لتلك الصادرة في 4 أيار/ مايو 2003، ما لم يشر السياق لغير ذلك.16
إلى العام 2003 يشير أوائل تباعا، وبفارق زمني بسيط خالل الفلسطيني الدستور دة مسو النسخ من إن ظهور كثير من دات المختلفة والفوارق دة. وتعكس المسو الضغوط السياسية التي عمل في ظلها الفريق الذي عهدت إليه مهمة وضع المسوالقانون األساس العام 2002، صدر الفلسطينية.17 ففي القيادة متنفذين في بين القضايا بينها االختالف حول بعض في ما
11 ـ عصام عابدين، سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2004، ص 6. يرجى مراجعة كذلك: عياد البطنيجي، الصعوبات التي تواجه وضع الدستور الفلسطيني، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 27، 2010، ص 111.
12 ـ عصام عابدين، المصدر السابق، ص 6.
13 ـ عصام عابدين، المصدر السابق، الصفحات من 8-6.
دات أنتجت الحقا لتشكيل لجنة الدستور في العام 1999، آخرها النسخة الثالثة المحدثة الصادرة في 4 أيار/ مايو 14 ـ كان هناك عدد من المسو2003، المنشورة من خالل الموقع: >http://tinyurl.com/mmari9< ، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/6.
http://< :15 ـ يرجى مراجعة: تعيين سليم الزعنون رئيسا للجنة الدستور وشعث نائبه، صحيفة الصباح، 2011/8/15، متوافر من خالل الرابطtinyurl.com/mmari47< ، آخر زيارة للموقع بتاريخ 2012/6/28. يرجى مراجعة كذلك: الزعنون يترأس اجتماعا لفريق لجنة الدستور
الفلسطيني برام هللا، متوافر من خالل الرابط http://tinyurl.com/mmari48، آخر زيارة للموقع بتاريخ 2012/6/28.
16 ـ يرجى مراجعة: http://tinyurl.com/mmari9، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/6.
دة الثالثة مع تعليقات ناثان براون، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تشرين دة دستور دولة فلسطين: المسو 17ـ ناثان براون، مسواألول/ أكتوبر 2003، الصفحات من 3-1.
دة الدستور الفلسطيني52 حقوق اإلنسان يف مسو
الفلسطيني، ما دفع البعض للدعوة للتركيز على تعديل بعض أحكامه، التي كانت أقرت من المجلس التشريعي العام 1997، دات لدستور دولة لم تكن ترى في األفق.18 وأسهمت في حينها جهود بدال من تشتيت الجهود من خالل العمل على تطوير مسوالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، خصوصا الرامية إلى إضعاف الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وتحييده، في إحياء النقاش دة الدستور في تلك حول الدستور أو على األقل التأثير في مجرياته ونتائجه، ما جعل كثيرين يشعرون أن عملية صياغة مسوالمرحلة حركتها عوامل وضغوط خارجية.19 ويظهر تأثير الضغوط الغربية بوضوح من خالل المواقف المتغيرة التي اتخذها
دتين: الثانية؛ والثالثة بالنسبة لصالحيات الرئيس ورئيس الوزراء.20 واضعو المسو
دة الدستور مختلفة تماما عن القانون األساسي النافذ في ذلك الوقت، من ناحية تعزيز صالحيات رئيس لهذا كله جاءت مسوالوزراء وإضعاف الرئيس، بل وصلت حد النص على تمكين مجلس الوزراء من التوصية بحل البرلمان، حال الضرورة.21 دة غنية بالحقوق والمساواة. فقد تميزت ومع هذا وجبت اإلشارة إلى أنه في ما يختص بحقوق اإلنسان وحرياته، جاءت المسودة الدستور بحظر التعذيب، وفتح المجال لتلقي ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التعويض، من بين أمور أخرى. وقد رأى مسو
البعض في هذا إشارة لرغبة واضعي الدستور في إنتاج نظام حكم ال مثيل له في المحيط العربي.22
دة الدستور ثالثا: الدين وحقوق اإلنسان في مسو
تشير الدساتير عادة إلى هوية الدولة صراحة أو ضمنا. فيمكن الوصول إلى هوية الدولة من خالل النصوص التي تتناول انتماءات الدولة اإلقليمية والقيم التي تنادي بها وتسعى إلى ترويجها واحترامها، أو التي تشكل مصدر إلهام أو التفاف جماهيري حولها. كما أن النص على دين الدولة، أو دين رئيسها، أو المرجع الديني المعتمد أو الرسمي، كلها مؤشرات على هوية الدولة. دة الدستور الثالثة المنقحة على مسائل ذات عالقة بهوية الدولة ودور الدين فيها في الباب األول )األسس العامة نصت مسو
للدولة(.
دة على أن " فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، نصت المادة الثانية من المسووالشعب الفلسطيني جزء من األمتين العربية واإلسالمية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه."
نصت المادة الخامسة على أن " اللغة العربية هي اللغة الرسمية واإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرساالت السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في
الحقوق والواجبات."
ونصت المادة السابعة على أن " مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع. وألتباع الرساالت السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب
الفلسطيني واستقالله."
فيها. الدين لمسألة دور الدستور دة مسو الدولة، وكيفية معالجة النصوص تطرح تساؤالت مهمة حول هوية هذه والسؤال الرئيس هنا هو: هل يؤسس النص المقترح لدولة دينية، وما هو أثر هذا النص، على حاله، في باب الحريات
والحقوق في الدستور؟
18ـ عصام عابدين، المصدر السابق، الصفحتان: 11-10.
19ـ ناثان براون، المصدر السابق، ص 112.
20ـ ناثان براون، المصدر السابق، الصفحات من 3-1.
دة األخيرة المؤرخة في 4 أيار/ دة المؤرخة 26 آذار/ مارس 2003 مع المسو دة الدستور. يرجى مقارنة النص في المسو 21ـ المادة 88 من مسومايو 2003.
22ـ ناثان براون، المصدر السابق، ص 14.
53 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
دولة دينية
في الدولة الدينية تكون إرادة الشعب، من خالل االنتخاب واالستفتاء أو من خالل أداء ممثليه المنتخبين، خاضعة وفي مرتبة دات سابقة وضعت فيها لجنة الدستور الشريعة أدنى العتبارات دينية منصوص عليها في الدستور. وهكذا كان الحال في مسودة الثالثة بأخرى اإلسالمية في مرتبة أعلى من أي مصدر آخر للتشريع. فمن خالل مقارنة النصوص ذات العالقة في المسودات سابقة، يرى عزيز كايد أن النص الحالي ألطف في المعالجة، لجهة اتخاذ مبادىء الشريعة مصدرا رئيسا، وليس في مسو
المصدر الرئيس للتشريع.23
ويشير كايد إلى انقسام كبير في صفوف الفلسطينيين في ما يختص بهذه المسألة، إذ تتراوح اآلراء بين النص ليس فقط على أن الشريعة هي المصدر األساس للتشريع، بل ووجوب أن تكون المصدر الوحيد له، في حين يرى آخرون، حتى من المتدينين، أن النص خال من الجدوى، وأن الشعب الفلسطيني بطبعه متدين، وأن النص الحالي كاف.24 ويرى آخرون أنه ال يوجد داع
للتطرق لهذه المسألة، فالمهم ماذا يقرره الشعب، من خالل ممثليه. 25
قام بدور الذي نبيل شعث، الدينية.26 لكن آخرين، ومنهم د. الجماعات الحالي محاولة السترضاء النص البعض في يرى دات المتداولة، يرون أن النص متوافق وميول الشارع الفلسطيني، مع إشارة إلى استطالعات للرأي مركزي في صياغة المسوتؤيد ما ذهبوا إليه.27 ويرى د. إبراهيم أبراش، وزير الثقافة الفلسطيني األسبق، أنه من الضروري عدم ارتكاب أخطاء وقعت فيها دول عربية وإسالمية مأزومة، واالنتباه لحقيقة أن النص على أن اإلسالم دين الدولة، وأن الشريعة مصدر أساس للتشريع، لم يؤد الدور المأمول في منع صراعات طائفية في دول عربية اتبعت هذا النهج. ولهذا يقترح أبراش تبني معادلة ال تضعنا في خانة الدولة الثيوقراطية، التي قد تضر بدال من أن تفيد، وفي الوقت نفسه ال تسقط الدين من مكونات هويتنا، بل تعطيه "بعدا تعدديا إنسانيا منفتحا". ومع ذلك يحذر أبراش من المغاالة في هذا األمر حتى ال يتم تقويض أسس الحكم الديمقراطي
في مرحلة ما بعد التحرر.28
واالختالف بشأن موقع الدين في الدولة ليس جديدا، فقد سبقنا إليه كثير. وتشير دراسات أجريت في الخصوص إلى زيادة في قبول الدين باعتباره عامال في الصياغة الدستورية ألنظمة الحكم على مستوى العالم، خصوصا في دول العالم النامي. فقد بحث
هرشل Hirschl في الموضوع، وصنف الدول حسب معالجتها لهذه المسألة إلى خمس مدارس هي:
الفصل التام، مثل: ) تركيا؛ وأثيوبيا بعد االنقالب ضد هيال سيالسي(. مؤسسة دينية ضعيفة، ضمن نظام يتبنى دينا رسميا بصالحيات رمزية مثل: ) المملكة المتحدة؛ والنرويج؛ وفنلندا(. القانون في معظمه علماني، مع نوع من االستقالل لألقليات الدينية مثل: )كينيا؛ والهند؛ ومناطق العام 1948(. القانون في معظمه ديني، مع اإلبقاء على جزئيات للقانون العلماني مثل: ) السعودية؛ واإلمارات العربية المتحدة(.
دة األولى )المؤرخة في العام 1999(، ومع هذا فلم نجد ما يؤيد هذا في 23ـ حسب عزيز كايد؛ فإن الشريعة كانت المصدر الرئيس في المسوwww.< دة األولى للدستور، المتوافرة من خالل موقع المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسحية النسخة المتوافرة مما يطلق عليه المسوpcpsr.org<. يرجى مراجعة كذلك: عزيز كايد، القضايا الخالفية في مشروع دستور الدولة الفلسطينية، المركز الفلسطيني للدراسات السياسية
والمسحية، نيسان/ أبريل 2004، ص 13.
24ـ عزيز كايد، المصدر السابق، الصفحات من 15-14.
Sami AlDeeb, ”Report on Palestinian Constitution,“ 2003. >sami-aldeeb.com/articles/view. 25.>php?id=8&action=arabic
يرجى مراجعة كذلك: عزيز كايد، المصدر السابق، ص 16.
Sami AlDeeb, ”Report on Palestinian Constitution,“ 2003. >sami-aldeeb.com/articles/view. 26 .>php?id=8&action=arabic
يرجى مراجعة كذلك: عزيز كايد، المصدر السابق، ص 16.
27 ـ وارد في عزيز كايد، المصدر السابق، الصفحة 17.
التالي: العامة لالستعالمات، متوافرة من خالل الرابط الهيئة العدد 25، رؤية، الفلسطيني، الدستور الهوية في مشروع ـ إبراهيم أبراش، 28>http://tinyurl.com/mmari45<، آخر زيارة بتاريخ 2012/6/28.
دة الدستور الفلسطيني54 حقوق اإلنسان يف مسو
الشريعة أحكام أن دستورها على ينص إذ أفغانستان، ( مثل: للقانون العامة والمبادئ الديني القانون خليط من اإلسالمية هي المطبقة، ومع هذا تتشكل المحكمة الدستورية من قضاة شرعيين وخبراء قانون، وينص دستورها أيضا
على حق المرأة في الترشح واالنتخاب(.29
دة دة الدستور الفلسطيني األخيرة تأتي في موقع متوسط. فمسو وإذا طبقنا هذا النموذج على الحالة الفلسطينية، نجد أن مسولقوى منصف تمثيل لغياب بالنظر لكن، المواطن.30 انتقائي، في بعض الدين بشكل التوافق مع تتبنى الفلسطيني الدستور دة الدستور الحالية، وبالنظر لتعاظم دور الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية ومنها دينية/إسالمية في عملية صياغة مسوفلسطين مؤخرا، فإنه ليس هناك تأكيد أن هذه المعادلة ستالقي الترحيب من هذه األوساط والحركات، إذ ربما تطمح بعض هذه الحركات في تبني صيغة أقرب لشعاراتها االنتخابية، من مثل “اإلسالم هو الحل”. عندها، قد نشهد تعديال وتغييرا للتوجهات
الحالية باتجاه الدولة الثيوقراطية، وفقا لنموذج هرشل.
وألن ما يهمنا ـ في نهاية المطاف ـ تأثير هذه المعادالت والتسويات والتفاهمات المجتمعية في فرص المواطنين في التمتع بحقوقهم بحرية ومساواة، والحفاظ على كرامتهم المتأصلة فيهم بوصفهم بشرا، فإننا نرى أنه من واجبنا العودة لهذا الموضوع
دة المتعلقة بحقوق اإلنسان في المبحثين اآلتيين: بعد أن نكون استعرضنا نصوص المسو
Ran Hirschl, ”The Theocratic Challenge to Constitution Drafting in Post-Conflict States,“ William and 29.Mary Law Review, 49 )2008(: 1179-1198
Ran Hirschl, ”The Theocratic Challenge to Constitution Drafting in Post-Conflict States,“ William and 30.Mary Law Review, 49 )2008(: 1179-1211
55 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
دة الدستور املبحث الثالث: حماية حقوق اإلنسان يف مسو)مع الرتكيز على حقوق الفئات املهمشة(
دة الدستور أوال: حقوق اإلنسان في مسو
و على ما دونه من التشريعات، كونه األداة األساسية التي تكفل الدولة من خاللها يتمتع الدستور بقيمة إلزامية عليا تجعله يسمإقرار حقوق األفراد وحرياتهم ، مراعية بذلك التوفيق بين االحتياجات المتعارضة بين الجماعات المختلفة، وباألخص األقليات والحريات األساسية الحقوق العديد من الثالثة الفلسطيني الدستور دة مسو أقرت وقد المجتمع.31 في المهمشة والجماعات الجماعية والفردية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، من حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية، التي وضعتها في دة مكانة متقدمة مقارنة بالحالة في ظل عدد من الدساتير العربية، وبخاصة بما يتعلق بحقوق المرأة. لكن يعيب هذه المسوعدم تطرقها بشكل كاف آلليات تكفل هذه الحقوق وتضمن ممارستها، وتزيل العوائق أمام الوصول إليها، وبخاصة للجماعات من وغيرهم الخاصة؛ االحتياجات وذوي والطفل؛ المرأة؛ مثل: المجتمع، في والمساندة للدعم بحاجة هي التي الضعيفة
الجماعات.
دة دستور تقر العديد من الحقوق األساسية التي تتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق يبرز هذا حقيقة أنه ال يكفي صياغة مسوز النص بآليات واقعية قابلة لالستخدام اإلنسان، دون أن تكون حساسة ومستجيبة للواقع المعيش والحتياجاته، ودون أن يعزتكفل المشاركة والتمتع بالحقوق والحريات لألفراد والجماعات. كما برزت بعض أوجه التناقض وعدم االنسجام في بعض دة، فهناك مواد تقر حقوقا للمرأة وتكفل مساواتها بالرجل، وتقر بشخصيتها القانونية المستقلة وتكفل مشاركتها مواد هذه المسودة الدستور أحكام تكفل للمرأة المساواة مع الرجل، وتقر بحقوقها السياسية، إذ ورد في المواد: )19 و22 و23( من مسو
االقتصادية؛ والسياسية؛ واالجتماعية؛ والثقافية، وتقر لها بذمتها المالية المستقلة وشخصيتها القانونية.
دة التي تقر بأن بالمقابل، هناك مواد تعيق كفالة مساواة المرأة بالرجل بالحقوق والواجبات، مثل المادة )7( من هذه المسومبادىء الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي للتشريع، ما يجعل تطبيق حقوق المرأة وواجباتها خاضعا ألحكام الشريعة اإلسالمية، على ما في هذا من ضيق األفق ونزعة نحو العمومية. وهذا من شأنه أن يجعل هذه المادة تقابل بالنقد من عدد دة في المادة )19( منها. فهذه المادة من الحركات النسوية؛ نظرا لتضاربها مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي أقرته المسوأنتقدت كونها تضع المرأة في إطار تتباين فيه حقوق الرجل والمرأة، بدل أن تكون متكافئة.32 كما اتسمت العديد من نصوص دة بالضعف وعدم الوضوح، القترانها بعبارات فضفاضة تحد من إلزاميتها وقوتها، مثل “وفقا للقانون” وعبارة “يحددها المسوالقانون”. وهذا ما قد يحد، في الواقع، من حرية ممارسة الحقوق وينتقص منها، وفقا لقيود القوانين التي قد تسن لتنظيمها الحقا. كما يرى بعض المحللين أن ربط الحقوق بالواجبات هو من المحاذير الخطيرة، وذلك على افتراض أن الحقوق والواجبات ال تتبع المرجع القانوني نفسه. فالحقوق أساسية أصيلة لبني البشر، يجب عدم مسها أو ربطها بأمور أخرى، وإال أصبحت
مشروطة بتنفيذ الواجبات.33
دة الثالثة للدستور الفلسطيني ثانيا: الفئات المهمشة في المواثيق الدولية وفي المسو
لما تحظى به حقوق اإلنسان من أهمية بالغة القيمة، فقد تم إصدار العديد من اإلعالنات والمواثيق الدولية باعتبارها نظرا سندا قانونيا لهذه الحقوق. فعلى الصعيد العالمي؛ برز اهتمام منظمة األمم المتحدة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، إذ بذلت جهود حثيثة وأعدت اتفاقيات مهمة في سبيل حماية حقوق اإلنسان ورعايتها. ولقد تكللت هذه الجهود في “اإلعالن العالمي
31ـ أحمد سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة، دار الشروق، 2000، ص 88.
دة الدستور الفلسطيني، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ، رام هللا، 2009، 32ـ مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، النساء ومسوص12- 13.
33ـ وليم نصار، الدستور الذي نريد لفلسطين، رام هللا، مواطن، 2004، ص 31.
دة الدستور الفلسطيني56 حقوق اإلنسان يف مسو
ين بحقوق اإلنسان” ليتكون بهذا ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان أو ما يسمى لحقوق اإلنسان” و”العهدين الخاصبـ”الئحة الحقوق الدولية”34.
كما أكد ميثاق األمم المتحدة على ضرورة احترام حقوق اإلنسان وحرياته، بدون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو أي نوع من أنواع التمييز، وذلك بموجب المادة )55( من هذا الميثاق. وشكل هذا االنطالقة القانونية العالمية
األولى لحقوق اإلنسان.
أهم من تبعت صدورها35 التي العامة والتوصيات المرأة” التمييز ضد أشكال جميع على “القضاء اتفاقية أعتبرت كما االتفاقيات التي سلطت الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، وجرمت العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، ورأت فيها كثير من الحركات النسوية في العالم والمؤسسات التنموية ركيزة قانونية دولية لحقوق المرأة، إذ استهلت ديباجتها بتأكيد نصوص ميثاق األمم المتحدة والعهدين الخاصين بحقوق اإلنسان، على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة دون أي تمييز. وفي هذه الديباجة تنظر هذه االتفاقية بعين القلق للعنف المتزايد ضد المرأة بالرغم من كل هذه الصكوك الدولية الملزمة.36 كما تشير الديباجة إلى إدراك واضعيها بأن إحداث تغيير في المعاملة الالإنسانية وغير العادلة للمرأة متوقف ـ بشكل كبير ـ على إحداث تغيير
في الدور التقليدي الموروث للرجل، وأيضا الدور التقليدي للمرأة في المجتمع.37
وأكدت هذه االتفاقية في المادة األولى منها بأن التمييز الذي تتناول عرضه في موادها هو التمييز ضد المرأة على أساس الجنس، وما ميز هذه االتفاقية إلزامها الدول على اتخاذ التدابير الالزمة الكفيلة بتغيير هذا التمييز الذي تعيشه المرأة، سواء الرجل، مع المساواة قدم على المرأة لحقوق القانونية الحماية “بفرض وإلزامها تشريعية، غير أو تشريعية تدابير باتخاذ أي عمل البلد، من في األخرى العامة والمؤسسات االختصاص ذات المحاكم للمرأة، عن طريق الفعالة الحماية وضمان تمييزي”.38 كما تطالب االتفاقية الدول بتغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة؛ بهدف تحقيق القضاء على
التحيزات والعادات العرفية.39
والجدير بالذكر أن هذه االتفاقية لم تركز على موضوع العنف ضد المرأة بشكل واضح في موادها، باستثناء ما ورد في المادة األولى منها التي تناولت تعريف التمييز، وأشارت إلى أنه يشمل العنف على أساس الجنس، كما أشارت إلى ضرورة االلتفات
إلى قضايا االتجار بالنساء والبغاء والقضاء عليها.
واستكماال لهذه االتفاقية؛ أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن القضاء على العنف ضد المرأة40، الذي أكدت بمقتضاه على أن العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال انتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية، كما اعتبرت العنف ضد المرأة
34ـ http://ar.wikipedia.org/wiki(/ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(.
35ـ مثل التوصية )19/24( التي تشدد على واجب الدول في إقرار »تشريعات تلغي فكرة الدفاع عن الشرف فيما يخص مهاجمة أو قتل أفراد األسرة من اإلناث«، وتقر بضرورة التمتع بالمبادئ والحقوق الواردة في اتفاقية »سيداو«، التي تنص على االلتزام الدولي بالقضاء على كافة
أشكال العنف ضد المرأة.
36ـ ما يدل على تزايد هذه الجرائم في العالم بشكل ملحوظ. إذ قد تكفي هذه المواثيق الدولية على المستوى النظري، ولكنها غير كافية على المستوى العملي التطبيقي.
37ـ مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، القدس، 2011، الصفحتان 226-225.
38ـ يرجى مراجعة البند ج من المادة 2 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. إذ عرف التمييز وفقا لهذه االتفاقية على أنه: »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها،
بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل«، كما ورد في المادة )2( منها.
39ـ وتدعو هذه االتفاقية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين المختلفة، مثل: التعليم؛ والسياسة؛ وسوق العمل؛ والصحة، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الرحل والمرأة في نواحي الحياة كافة، بما فيها المساواة في المسؤوليات واألدوار األسرية؛ والمساواة أمام القانون؛
والحق في التقاضي؛ وما يتبعه من حقوق ضرورية للمرأة، وبخاصة في المجتمعات التي ال تمنحها أهم حقوقها.
40ـ صدر هذا اإلعالن بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 104/48 كانون األول/ ديسمبر 1993.
57 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
مظهرا لعالقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، قادت إلى هيمنة الرجل على المرأة، وممارسته التمييز ضدها.41
وثقافية وراثية بعوامل المرهون المرأة مع التعامل طبيعة من ينبع العربية الدساتير في المرأة وضع أن المالحظ ومن كأي مواطن المجتمع ودور مشاركتها وحقوقها في المرأة تقدير دور تباين في مستويات إلى أدى ما واجتماعية مختلفة، عادي. ونرى بأن المشرع الفلسطيني في معظم وثائقه وأنظمته كان ساعيا إلقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتعميم دة الثالثة للدستور الفلسطيني لتشتمل على مساحة واسعة هذا المبدأ في الحقول والميادين كافة. وفي هذا الصدد؛ جاءت المسومن الحقوق والحريات التي تساوي بين الرجل والمرأة، وترفض التمييز بينهما ، ومن ثم تعكس صورة جيدة من الديمقراطية ومن مراعاتها لحقوق المواطنة، وعلى األقل بما يتماشى مع ما يقر من مبادئ مساواة في الدول الديمقراطية. ومن أهم المواد دة مقرة مبدأ المساواة أمام القانون بين الفلسطينيين، في هذا الخصوص المادة )19( التي توجت الباب الثاني42 من هذه المسوفهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، وبالواجبات العامة دون فرق أو تمييز فيما بينهم. وختم المشرع هذه المادة بجملة في غاية األهمية في هذا الصدد، وهي: )أن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما ورد في الدستور يعني الذكر أو األنثى(. وبالرغم من أن هذه الجملة تعد من منظور قواعد الصياغة القانونية تحصيال حاصال، إال أنها تعود وتؤكد مبدأ المساواة بين دة، بأن هذه المادة تضيف تميزا الرجل والمرأة في كل الحقوق األساسية.43 ويعتقد ناثان براون في تحليله لهذه المادة من المسودة الثالثة للدستور؛ كونها تضمنت ـ بشكل صريح وواضح ـ تأكيدا على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وعلى على المسو
مبادىء “جندرية”. وهذا ما تفتقده العديد من الدساتير العربية.44
دة على حظر حرمان أي شخص من حقوقه وحرياته األساسية أو أهليته القانونية ألسباب كما تؤكد المادة )20( من هذه المسوالقانونية شخصيتها على ترتكز مهمة اقتصادية حقوقا للمرأة لتحفظ فجاءت دة؛ المسو هذه من )22( المادة أما سياسية. المستقلة، وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها، ما يعني حريتها في إبرام العقود والتصرفات القانونية، والحفاظ على ملكيتها الخاصة. ومؤكدة على ضرورة تمتعها بالحقوق والحريات األساسية نفسها التي يتمتع بها الرجل، وبالمقابل يقع على كاهلها دة على حقوق المرأة المختلفة، إذ نصت على أن “ للمرأة الحق في الواجبات نفسها. كما أكدت المادة )23( من هذه المسوالمساهمة الفاعلة في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء األسرة والمجتمع، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في اإلرث الشرعي”. ويمكن القول؛ إن هذه المادة من أهم المواد الدستورية في فلسطين التي تمنح المرأة حقوقا واضحة
ودون ضاللة، التي تكاد تعد خطوة متميزة في تضمين حقوق المرأة األساسية.
وبتحليل هذه المواد؛ نرى بأنها قد أقرت حق أي شخص في التمتع بحقوقه سواء في اإلطار السياسي أو التشريعي، إال أنها لم تنص على سن قانون يكفل التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة، فال يكفي أن نكفل الحقوق دستوريا بقدر ما نكفل ضمان
التمتع بها، بتحديد آليات يتم من خاللها تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.45
أما حق تكوين األسرة وحق األمومة والطفولة، فهو ليس حقا فقط من الحقوق؛ بل هو واجب وطني على الدولة، وانسجاما مع دة الدستور حق األم في إعطاء أبنائها الجنسية أسوة باآلباء، دة على هذا األمر. وكفلت مسو ذلك أكدت المادة )48( من المسووهذا ضروري والزم بما نعيشه من خصوصية فلسطينية وظروف سياسية عصيبة تؤدي إلى تشتيت الفلسطيني وإبعاد األوالد
عن ذويهم46.
41ـ مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، القدس، 2011، الصفحات من 29-27.
42 ـ الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة.
دة الدستور الفلسطيني، العدالة والقانون، مركز مساواة، 2009، ص 83. 43 ـ أشرف صيام، موجبات تحضير مسو
دة دستور دولة فلسطين، رام هللا: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، دائرة السياسة والحكم، 2003. 44 ـ براون، ناثان، مسو
45 ـ عصام عابدين، سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام هللا، حزيران/ يونيو 2004، ص1.
دة. 46 ـ يرجى مراجعة: المادة 12 من المسو
دة الدستور الفلسطيني58 حقوق اإلنسان يف مسو
دة قد أقرت بعض المواد التي يشمل تطبيقها النساء، بشكل أساسي، مثل المواد: 23 و28 و60 التي إضافة إلى أن هذه المسويمكن أن تطبق على حاالت العنف األسري، إذ باإلمكان تطبيق “أمن األشخاص” على العنف األسري.47
يتبين مما سبق؛ إصرار المشرع الفلسطيني على إتباع نهج المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وذلك من خالل عدم اقتصار النص في بعض مواده على حقوق للرجل دون المرأة ، فهي بجانب الرجل تساهم بفعالية في بناء المجتمع في الميادين
كافة.
دة، فقد باإلضافة إلى التطرق لموضوعات تتعلق بالنوع االجتماعي أو بالمساواة بين الرجل والمرأة في بعض مواد المسودة فئات خاصة بالحماية والرعاية، مثل: العجزة؛ وأسر الشهداء؛ واألسرى؛ واأليتام؛ والجرحى والمتضررين من حددت المسوالنضال الوطني؛ وذوي االحتياجات الخاصة، على أن تكفل الدولة حمايتهم ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم في حدود إمكانياتها، ومنحهم األولوية في العمل، وذلك وفقا لضوابط القانون وأحكامه. وتعد هذه المواد كفيلة بإقرار حقوق هذه األقليات أو الفئات التي هي بحاجة إلى الرعاية والدمج بالمجتمع، إال أن هذه اإلجراءات والمواد القانونية هي غير كافية في ظل المعيقات التي تواجهها هذه الجماعات والتمييز الذي تعيشه على أرض الواقع. إذ ال بد من أن تدعم هذه المواد بآليات وسياسات واقعية تكفل
دة من حقوق لهذه الجماعات، وإزالة العوائق أمام وصولها إلى ممارسة حقوقها. تطبيق ما حملته مواد المسو
دة الدستور الفلسطيني موضوع الدراسة من وجهة نظر النوع االجتماعي - الذي يعد أحد األدوات ويرى بعض المحللين لمسوالمهمة للوصول إلى العدالة والمساواة في المجتمع- أنها ما زالت في المستوى األول من تحليل النوع االجتماعي، وهو مستوى حقوق النساء بمعزل عن العالقة بين البنى الكلية في المجتمع. ويظهر ذلك في نقاط عدة مهمة تشير إليها شهناز جبران، وهي:
لم يتم إشراك النساء في عملية الصياغة، وإن تم إلحاق القليل منهن بالعملية بعد ضغط الحركات النسوية.
هناك تناقض في بعض المواد بسبب انطالقها من رؤية مرتبطة بالنوع االجتماعي: رجال وامرأة. فعلى الدستور أن يقوم بإعادة تعريف أدوار وواجبات وحقوق المواطنين والمواطنات وإقرارها ، بحيث ال تكون مرتبطة بجنس المواطن بل بمواطنته، وذلك يعني منح المرأة الحقوق واالمتيازات والفرص المتاحة نفسها الممنوحة للرجل، ومنحها
كذلك الفرصة المتكافئة في الوصول إلى الموارد واإلمكانيات بالنظر إليها بوصفها مواطنة وليس باعتبارها امرأة.
هناك فصل واضح بين معالجة الدستور للحقوق في المجالين: العام؛ والخاص، ويبرز ذلك في عدم تدخله بمعالجة الحقوق في المجال الخاص، وبخاصة بما يتعلق بحقوق المرأة. 48
وتوصي جبران بضرورة كسر الحواجز، وإخراج المرأة من حيزها الخاص إلى العام؛ أي من بوتقة األسرة واإلطار الخاص الذي تعيش به إلى إطار المشاركة في الحيز العام: السياسي؛ واالقتصادي؛ والثقافي، ومنحها الفرص الكفيلة بضمان مشاركتها
في هذه الجوانب، حتى يكون الدستور أداة للتغيير نحو األفضل.49
دة الدستور الفلسطيني، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ، رام هللا، 47 ـ مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ، النساء ومسو2009، ص 13.
48 ـ شهناز جبران، الدستور الفلسطيني ومتطلبات التنمية البشرية، في النوع االجتماعي والدستور الفلسطيني، جامعة بيرزيت، 2004، الصفحتان .205-204
49 ـ شهناز جبران، المرجع السابق ، الصفحتان 205-204.
59 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
املبحث الرابع: الضمانات الدستورية حلقوق اإلنسان وآليات حمايتها
يدل تمتع اإلنسان بحقوقه األساسية وحرياته العامة على مدى رقي المجتمعات والشعوب، ويصعب حصر الوسائل التي تكفل حقوق اإلنسان وتضمن حمايتها؛ ألن كل ما يساهم في كفالة الممارسة الفعلية والحقيقية لهذه الحقوق يعد واحدا من ضماناتها.50 ولعل الضمانات الدستورية هي أحد أهم ضمانات حقوق اإلنسان ، كونها تؤسس لما عداها من ضمانات. لذلك تحرص الدول على تكريس مبادئ حقوق اإلنسان في دساتيرها الوطنية. وتنبع أهمية هذا التكريس من كون الدستور هو التشريع األسمى في الدولة الذي يحدد أطرها العامة، مثل: نظام الحكم؛ وعالقة سلطات الدولة الثالث فيما بينها، ومع األفراد، باإلضافة إلى حقوق ن حقوق اإلنسان بالنص عليها دستوريا كذلك، كون التشريعات العادية اإلنسان؛ وحرياته العامة؛ وواجباته األساسية. وتحص
في الدولة ينبغي أن تراعي أحكام الدستور، وأن ال تنتقص من الحريات الواردة فيه، واال عدت غير دستورية.
ونظرا ألهمية النص على حقوق اإلنسان وآليات حماية هذه الحقوق وضمانات تطبيقها في الدستور، ينبغي أن تدخل هذه النصوص في تكوين الدساتير، وأن تكون على سلم أولوياتها. وقد أوردت العديد من الدساتير، ومنها العربية، ضمانات متنوعة لحماية حقوق اإلنسان، وإن كان ذلك بشكل متفاوت.51 ومما الشك فيه أن النصوص التي تكرس حقوق اإلنسان وتضمن عدم التعرض لها، تبقى ـ على الرغم من روعتها وتطورها ـ نصوصا جامدة ما لم يقترن سنها بتطبيقها. لكن هذا ال يعني عدم لنمو المجتمعات وتطورها، ذلك أن التطبيق السليم لحقوق اإلنسان، وتمكين النص عليها في الدساتير، وعدم تحديثها وفقا األفراد من ممارسة هذه الحقوق؛ يرتكز أساسا على النص عليها في الدستور والقانون، وذلك إيمانا من األفراد والسلطات
العامة بمبدأ سيادة القانون.
دة الدستور الفلسطيني- في هذا الجزء من الدراسة؛ سيتم التركيز على أهم الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان الواردة في مسوالمحور األول- وكون قيمة حقوق اإلنسان تقاس بمدى تمكن األفراد من ممارستها والتمتع بها فعليا؛ فإننا سنتناول اإلجراءات الدستورية الكفيلة بتطبيق هذه الضمانات، وتمكين األفراد من التمتع بحقوقهم - المحور الثاني- وكل ذلك بمقارنة هذه الضمانات
مع ما نصت عليه بعض دساتير الدول العربية.
أوال: الضمانات الدستورية عموما
يقصد بالضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان مجموعة من الوسائل واألدوات التي تمكن اإلنسان من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الوسائل والطرق القانونية التي تحمي هذه الحقوق من االنتهاك، وتختلف هذه الضمانات وتتنوع تبعا الختالف الدساتير وتنوعها. إال أن هنالك العديد من الضمانات التي عادة ما تنص عليها الدساتير الديمقراطية الحديثة. لذلك
دة الدستور الفلسطيني محل الدراسة من هذه الضمانات. سنعرض بإيجاز ألهم الضمانات؛ بهدف الوقوف على موقف مسويجسد الدستور مجموعة من القواعد التي تبين مصدر السلطة، وتنظم أعمالها وممارساتها، وإجراءات انتقالها، وكذلك تلك القواعد وتمتاز عرفية. كانت أم مدونة ومكتوبة أكانت الدولة، سواء في العامة اإلنسان وحرياته بحقوق المتعلقة القواعد الدستورية بالسمو على ما عداها من قوانين محلية مطبقة في الدولة. وهذا يعني أن أي قانون يخالف ما جاءت به قواعد الدستور، يعد قانونا غير دستوري، إضافة لما قد يلحق هذه القوانين من إلغاء حسب نظام الرقابة على دستورية القوانين المتبع. لذلك، من شأن النص في الدستور على ضمانات حقوق اإلنسان وآليات الرقابة عليها، أن يجعل من هذه الضمانات حامية
لحقوق اإلنسان إذا ما تم تطبيقها، لذا فقد أوردت الدساتير المختلفة مثل هذه الضمانات.
يمكن تقسيم الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان إلى ضمانات أساسية عامة، وتتمثل في: مبدأ الفصل بين السلطات؛ ومبدأ سيادة القانون، وضمانات دستورية خاصة تتمثل في: موقع االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان في منظومة
التشريع المحلي أو الوطني؛ والنصوص المتعلقة بتعديل النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته.
50 ـ أميرة خبابة، ضمانات حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2010. ص 69.
51 ـ فاتح عزام، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية )دراسة مقارنة(، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، ص .27
دة الدستور الفلسطيني60 حقوق اإلنسان يف مسو
)1(: الضمانات الدستورية العامة
وتتمثل هذه الضمانات في:
مبدأ الفصل بين السلطات: ترجع أهمية مبدأ الفصل بين السلطات كونه الوسيلة األنجع لمنع تركيز السلطات، بتوزيع سلطات الدولة بين التنفيذية؛ والتشريعية؛ والقضائية، وأن يتم تحديد العالقة بين هذه السلطات والدور المنوط بكل سلطة.52 لكن ينبغي أن ال يفهم هذا الفصل على أنه وسيلة للتنازع أو القطيعة بين السلطات؛ بل هو فصل مرن يضمن تعاون السلطات ومراقبتها لبعضها بعضا، وتفاهمها في إطار القانون، وقد أشارت معظم دساتير الدول إلى هذا المبدأ
صراحة أو ضمنا، وذلك عن طريق توزيع عمل السلطات في الدولة.
الجميع: التزام يعني المعاصرة، وهو الدول المستقرة في المبادئ القانون من يعد مبدأ سيادة القانون: مبدأ سيادة مؤسسات، وأفرادا، حكاما ومحكومين، بأحكام القانون باعتباره أساسا لمشروعية ما يؤدونه من أعمال. إال أن سيادة القانون ال تعني مجرد االلتزام بأحكامه ، ذلك أن القانون يجب أن يكفل حقوق اإلنسان للجميع . أما إذا كان القانون نفسه ال يأبه بحقوق اإلنسان؛ فإن الضمانات كافة تغدو دون فائدة، ومن ثم يصبح مبدأ سيادة القانون عديم الجدوى.53 لذلك دأبت الكثير من دساتير الدول على النص على مبدأ سيادة القانون بوصفه ضمانة دستورية مهمة من ضمانات
حقوق اإلنسان.
)2(: الضمانات الدستورية الخاصة
وتتمثل هذه الضمانات في:
للقوانين بالنسبة اإلنسان- بحقوق المتعلقة وبخاصة - الدولية االتفاقيات مكانة توضح التي الدستورية النصوص المحلية.
النصوص الموضحة آلليات تعديل نصوص حقوق اإلنسان الواردة في الدستور. إن مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في معظم الدساتير. ويسوغ ذلك على أساس أن الدستور يجب أن يواكب مقتضيات التطور االجتماعي، وتطورها من جميع الحياة تغير أن إلى الفقه ويذهب المجتمع. في السائد الحكم لنظام الواقعية الصورة وتكوين يعد لذلك، تتغير وال تتطور.54 ثابتة ال السياسية؛ واالقتصادية؛ واالجتماعية؛ ال ينسجمان مع نصوص النواحي:
النص على ذلك في الدستور من الضمانات الدستورية المهمة الحترام حقوق اإلنسان.
دة الدستور الفلسطيني ثانيا: ضمانات حقوق اإلنسان في مسو
دة الدستور الفلسطيني. سنركز في هذا المحور على أهم الضمانات الدستورية الواردة في مسو
)1(: نظام الحكم
ذات سيادة، دولة مستقلة فلسطين الدستور،” دة مسو المادة)1( من إذ نصت نظام جمهوري، فلسطين هو في الحكم نظام نظامها جمهوري....”. ويقوم النظام السياسي في فلسطين على مبادئ الديمقراطية، وذلك باختيار الشعب نوابه وممثليه في دة الدستور على البرلمان، ويضمن نظام الحكم هذا، التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. وقد نصت المادة )8( من مسوأن: “النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين الوطنية السيادة مبادئ األحزاب وتلتزم القانون. أساس على لنشاطها وممارستها األحزاب تكوين ومنها حرية وحرياتهم
والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عمال بالدستور”.
52 ـ أميرة خبابة، ضمانات حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، ط1، دار الفكر والقانون، مصر، 2010، ص 93.
53 ـ أميرة خبابة، ضمانات حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص 82.
54 ـ أميرة خبابة، ضمانات، حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص 112.
61 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
تشكل الديمقراطية ضمانة مهمة من ضمانات حقوق اإلنسان، إذ تتيح ألفراد المجتمع ولألحزاب السياسية مراقبة مدى احترام حقوق اإلنسان وقدرة المواطنين على ممارستها، ففي ظل نظام حكم ديمقراطي تتورع السلطات التنفيذية عن تجاوز القوانين، وبخاصة الدستور؛ ألنها تكون خاضعة لمراقبة ومساءلة تامة من قبل الشعب الذي يمتلك معاقبة السلطات في حال تعديها على
حقوق اإلنسان عن طريق صناديق االقتراع.
كما يشكل مبدأ سيادة القانون ركيزة أساسية وإحدى ضمانات حقوق اإلنسان المهمة، إذ يخضع الجميع: أفرادا؛ ومؤسسات لحكم القانون، ويتم وفقا لذلك محاسبة كل من يتجاوز القانون أو يتعرض ألي حق من حقوق اإلنسان الواردة في الدستوروالقانون، إلى بطالن أي تصرف تجريه اإلدارة. وقد نصت العديد من والخروج على مبدأ سيادة القانون أو المشروعية يؤدي حتما الدساتير على مبدأ سيادة القانون، كما هو الحال في المادتين )64-65( من الدستور المصري للعام 1971 والمادة )57( من دة الدستور الفلسطيني التي جاء فيها: الدستور الجزائري للعام 1989، كما ورد النص على هذا المبدأ في المادة )9( من مسو“مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات واألجهزة والهيئات والمؤسسات واألشخاص
للقانون”.
)2(: االلتزام الدستوري بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية55
العالمي لحقوق اإلنسان؛ والعهد مثل: اإلعالن ، المتعلقة بحقوق اإلنسان الدولية باالتفاقيات والمعاهدات الدولة التزام يعد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وغيرها من المعاهدات الخاصة بالمرأة والطفل والمعوقين، والكثير من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. ويعد التزام الدولة هذا، واحدا من ضمانات حقوق اإلنسان المهمة، إذ يتيح هذا االلتزام من قبل الدولة لألفراد التمتع بالحقوق الواردة في هذه اإلعالنات والمعاهدات، ويمنع التشريعات الوطنية من مصادرة أي من الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات واإلعالنات الدولية، كما يتيح هذا االلتزام لألفراد االستفادة من اآلليات الدولية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان، وتمكين األفراد من ممارسة
هذه الحقوق، وبخاصة إذا ما فشلت اآلليات الوطنية في تحقيق هذا الهدف.
لحل تدين اإلرهاب واالحتالل والعدوان، وتدعو للسالم، الدستور: “فلسطين دولة محبة دة مسو المادة )3( من وقد نصت أن دة على المسو المادة )18( من المتحدة”. كما نصت السلمية، وتلتزم بميثاق األمم الدولية واإلقليمية بالطرق المشكالت “تلتزم دولة فلسطين باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وتسعى لالنضمام إلى المواثيق والعهود الدولية األخرى التي تحمي
حقوق اإلنسان”.
دة الدستور، تضمن احترام حقوق اإلنسان ، وتلزم الدولة على االنضمام وهذه من الضمانات المهمة التي وردت في مسوإلى المعاهدات الدولية الخاصة بكل مجاالت حقوق اإلنسان، وعلى تعديل تشريعاتها الداخلية لتتواءم مع االتفاقيات الدولية دة الدستور عبارة “دون تحفظ” ذلك أن الخاصة بحقوق اإلنسان. وحبذا لو أضاف المشرع إلى نص المادة )18( من مسوالعديد من الدول تعمل عادة على إدراج مجموعة من التحفظات على بنود االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ما يفرغ
هذه االتفاقيات من مضمونها.
دة الدستور صالحية إبرام المعاهدات الدولية للحكومة، فاألصل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وقد أسندت مسومن الوزراء عقد المعاهدات الدولية، على أن يتم اطالع رئيس الدولة على سير المفاوضات، وأن يقترن عقد المعاهدات بموافقة
مجلس الوزراء وتصديق الرئيس،56 لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. أما المعاهدات التي تحمل خزينة الدولة
دة مشروع 55 ـ للمزيد، يرجى مراجعة: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ورشة عمل بعنوان: المعاهدات والمواثيق الدولية في مسوالدستور الفلسطيني المقترح، رام هللا، 2000/12/24.
دة الدستور الفلسطيني على أن: »يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد 56 ـ نصت المادة )123( من مسوالمعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس،
طبقا ألحكام المادة )79( من هذا الدستور«.
دة الدستور الفلسطيني62 حقوق اإلنسان يف مسو
نفقات غير تلك المنصوص عليها في الموازنة العامة أو تحمل المواطنين التزامات خالفا لما هو وارد في القوانين السارية؛ فإنها تستوجب عرضها على المجلس النيابي قبل نفاذها.57
تذهب بعض الداخلي58،إذ القانون النظام في الدولية المعاهدات تحديد مكانة العربية في الدول تباينت مواقف دساتير وقد و على القانون الداخلي، كما هو الحال بالنسبة للدستور الدساتير إلى النص على أن المعاهدات التي تنضم إليها الدولة تسمالجزائري للعام 1989 والدستور المغربي، في حين تساوي دساتير دول أخرى بين المعاهدات والقانون الداخلي، كما هو الحال بالنسبة للدستور المصري للعام 1971 والكويتي للعام 1962، ويذهب اتجاه آخر من الدساتير إلى النص على احترام المعاهدات الدولية دون أن يبين مكانة هذه المعاهدات، كما هو الحال بالنسبة للدستور األردني للعام 1958 والدستور العراقي
للعام 2005.
دة الدستور لم تحدد مكانة المعاهدات الدولية التي تنضم اليها الدولة أو تصادق عليها في النظام وتجدر اإلشارة إلى أن مسودة قيمة هذه المعاهدات بالنسبة للتشريعات الوطنية.59 حبذا لو تم تالفي هذا النقص بالنص القانوني المحلي، ولم تحدد المسوعلى أن المعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها أو االنضمام إليها تصبح في مكانة أعلى من التشريعات العادية، وذلك حتى يمكن االستفادة من هذه المعاهدات في تعديل القوانين المحلية المتعارضة معها، وحتى ال يكون هناك تجاوز لهذه االتفاقيات أو االلتفات عليها عن طريق سن التشريعات المحلية. وفي هذه الحالة قد يفيد، من قبيل حفظ التوازن بين السلطتين: التنفيذية؛
والتشريعية، النص على عدم نفاذ التصديق على االتفاقيات الدولية دون صدورها بقانون عن الهيئة التشريعية المنتخبة.
)3(: دور السلطة التشريعية في ضمان احترام حقوق اإلنسان
تؤدي السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، دورا مهما في ضمان احترام حقوق اإلنسان وعدم التعرض لها بأي شكل من األشكال، فالسلطة التشريعية تقوم من جهة بسن تشريعات ضمن السقف الذي يحدده الدستور، بما في ذلك سقف الحقوق المكفولة وفقا ألحكامه، وهي بهذا مؤتمنة على مراعاة أن ال تتعارض التشريعات التي تسنها مع هذه الحقوق، ومع تلك الواردة في المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتم المصادقة عليها حسب األصول. ومن جهة أخرى تراقب السلطة التشريعية مدى التزام السلطة التنفيذية باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها. وقد ورد النص على الدور الرقابي للسلطة التشريعية في المادة )65( دة الدستور، التي جاء فيها: “يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر السياسات العامة للدولة والموازنة العامة من مسوالتي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور”. كما نصت المادة )82( على أنه: “للمجلس النيابي أن يكون لجانا خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام دة الدستور كل عضو من أعضاء مجلس النواب متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع لمراقبته....”. كما منحت مسوالحق في توجيه األسئلة لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء )المادة 84( ومنحتهم أيضا حق توجيه االستجواب لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم )المادة 85( ويحق لعشرة من أعضاء مجلس النواب توجيه اللوم
لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء، والتقدم بطلب لسحب الثقة )المادة 86(.
دة الدستور لمجلس النواب الحق في المصادقة على التعيينات في بعض المناصب العليا في الدولة، إضافة إلى ذلك منحت مسوكما هو الحال بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القضاء األعلى )المادة 161( وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية )المادة 178(.
)4( تعديل الدستورفي هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى أحكام تعديل المواد الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته العامة، إذ تذهب بعض
دة الدستور الفلسطيني على أن: »يقر مجلسي الوزراء االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها أعضاء الحكومة 57 ـ تنص المادة )79( من مسوبموجب الصالحيات المفوضين بها، ويلزم لسريانها تصديق رئيس الدولة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية أما االتفاقيات والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة أو تحمل المواطنين أو الدولة التزامات خالفا للقوانين السارية فتستوجب أيضا موافقة أغلبية مجموع لقيام توطئة أراضيها، أو سالمة الدولة باستقالل يترتب عليها مساس التي المعاهدات النيابي المجلس ويناقش النيابي إلنفاذها المجلس أعضاء
الحكومة بطرحها على االستفتاء الشعبي العام، ويلزم لنفاذها موافقة اغلبية المشاركين في هذا االستفتاء«.
58 ـ غسان الجندي، قانون المعاهدات الدولية، ، عمان، األردن، 1988، ص170.
59 ـ عصام عابدين، سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام هللا، حزيران/ يونيو 2004، ص4.
63 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
الدساتير إلى تحريم تعديل نصوص الدستور المتعلقة بحقوق اإلنسان تحريما مطلقا، كما هو الحال بالنسبة للدستور الجزائري للعام 1989 وبخاصة المادة )164( منه، والدستور البحريني للعام 1973 في المادة )104/ج(. وتذهب دساتير دول أخرى إلى جواز تعديل النصوص المتعلقة بحقوق اإلنسان إذا كان في هذا التعديل زيادة في ضمان احترام حقوق اإلنسان وحسن
تطبيقها، كما هو الحال في الدستور الكويتي للعام 1962 وبخاصة المادة )175( منه.60
دة الدستور الفلسطيني؛ فقد نصت على آلية تعديل الدستور في المادة )186( التي جاء فيها: أما مسو
“لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثلث أعضاء المجلس النيابي طلب إجراء تعديل في الدستور وذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو اكثر فيه. وفي جميع األحوال يلزم إلقرار مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ثلثي مجموع أعضاء يناقش الدستور قبل مضي سنة ميالدية على هذا الرفض. النيابي، فإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المجلس المجلس النيابي خالل ستين يوما من الموافقة على طلب التعديل، المادة أو المواد المراد إجراء التعديل فيها، فإذا وافق عليها التعديل طرح يقرر أن أعضائه، مجموع وبأغلبية أيضا، النيابي وللمجلس مقبوال، التعديل اعتبر أعضائه مجموع ثلثي لالستفتاء الشعبي العام إلقراره. فإذا وافق أغلبية المشاركين في االستفتاء على التعديل، اعتبر نافذا من تاريخ إعالن نتيجة
االستفتاء.”
ولم تحظر هذه المادة إجراء تعديالت على المواد الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وحبذا لو نص الدستور على هذا الحظر، سوى من خالل اشتراط نفاذ أي تعديل بموافقة الشعب من خالل استفتاء عام.
)5(: استقالل القضاء
تؤدي السلطة القضائية المستقلة دورا مهما في ضمان احترام حقوق اإلنسان وعدم االعتداء عليها. ونظرا لألهمية التي تحتلها السلطة القضائية، فقد وضعت األمم المتحدة مبادئ لضمان استقالل القضاء، أقرتها الجمعية العمومية العام 1985 وطلبت من
الدول األعضاء إدخال هذه المبادئ في تشريعاتها الوطنية إذا لم تكن مدرجة فيها.61
وال يكفي أن تكون السلطة القضائية مستقلة بوصفها سلطة؛ بل ينبغي أن يكون القضاة مستقلين بوصفهم أفرادا، وأن يتمتعوا باستقالل ذاتي ليتمكنوا من االضطالع بالدور المهم المنوط بهم؛ وهو ضمان احترام حقوق اإلنسان. وقد نصت المادة )11( دة الدستور على استقالل السلطة القضائية، إذ جاء فيها: “استقالل القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق من مسووالحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء”. كما نصت المادة )159( على أن: “السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة االختصاص األصيل بالوظيفة
القضائية،...”. كذلك نصت المادة )168( على أن:
“القضاة مستقلون وال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون شروط انتهاء مهامهم ومساءلتهم التأديبية أمام المجلس األعلى للقضاء في األحوال التي يحددها القانون، دون اإلخالل باستقالليتهم في أداء أعمالهم. وال يجوز ألي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ األحكام القضائية. ويعتبر التدخل في سير العدالة أو تعطيل
تنفيذ األحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم”.
)6(: ضمانات أخرى
دة الدستور الفلسطيني التي تكفل احترام حقوق اإلنسان ومراعاتها، عدم جواز من بين الضمانات الوارد النص عليها في مسوفرض القيود على الحقوق والحريات األساسية في أثناء حالة الطوارئ، إذ نصت المادة )130( على أنه:
“ال يجوز في أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية، إال بالقدر الضروري للمحافظة على السالمة العامة للبالد. وتخضع جميع القرارات واألعمال التي يتخذها مجلس الوزراء أثناء حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية. وتشرع
المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام”.
60 ـ أميرة خبابة، ضمانات حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص 112.
61 ـ عيسى بيرم، الحريات العامة وحقوق اإلنسان بين النص والواقع، ص 206.
دة الدستور الفلسطيني64 حقوق اإلنسان يف مسو
ويالحظ من هذا النص أن مشروع الدستور قد أورد استثناء خطيرا على هذه الضمانة، إذ أتاح للسلطات فرض القيود على الحقوق والحريات العامة بالقدر الضروري للمحافظة على السالمة العامة. وقد يكون في ترك تقدير ما هو ضروري من متطلبات ضمان السالمة العامة للسلطة التنفيذية، أمر خطير ومنفذ واسع يسمح لها باالعتداء على حقوق اإلنسان تحت غطائه.
لكن ما يخفف من وطأة هذا أن النص أخضع جميع أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها للرقابة القضائية.
دة الدستور الفلسطيني إلزام جهاز الشرطة بضرورة االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، إذ كذلك مما يميز مسونصت المادة )154( من مشروع الدستور على أن: “الشرطة هيئة مدنية،....، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور”. إن هذه الضمانة من أهم الضمانات الدستورية كونها تستهدف الجهاز التنفيذي األكثر قربا واحتكاكا باألفراد. ولتعزيز هذه الضمانة ينبغي العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان في
أجهزة الدولة بعامة وفي جهاز الشرطة بخاصة، وكل ذلك امتثاال لنص الدستور.
ثالثا: اآلليات الدستورية لحماية حقوق اإلنسان
إن تعزيز حقوق اإلنسان وحياته العامة يستلزم بالضرورة وجود آليات وطنية داخل كل دولة، قادرة على حماية هذه الحقوق وكفالة االحترام الواجب لها. وتزداد أهمية هذه اآلليات في ضوء اإلدراك أن توافر نظام قوي لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني هو أكثر فاعلية من االعتماد على أنظمة الحماية الدولية وآلياتها، على أهمية األخيرة.62 ومن بين اآلليات
التي نظمها مشروع الدستور اآللية القضائية، باإلضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان.
)1(: الحماية القضائية
تؤدي المحاكم، على اختالف أنواعها ودرجاتها، دورا مهما في حماية حقوق اإلنسان ومنع االعتداء عليها، وقد كان للمحاكم في فلسطين دور بارز في هذا المجال، إذ صدرت العديد من األحكام القضائية التي تحمي حقوق اإلنسان بعامة، والسيما حقوق
المعوقين63؛ والحق في حرية التعبير والرأي؛ ومنع االعتقال السياسي64.
وتساهم المحكمة الدستورية ـ بشكل رئيسي ـ في حماية حقوق اإلنسان، وذلك بالنظر لطبيعة المهمات الموكولة إليها، التي من أهمها مراقبة دستورية القوانين. لذلك فقد نصت العديد من دساتير الدول العربية على إنشاء محكمة عليا أو محكمة دستورية تراقب مدى دستورية تصرفات اإلدارة، ومن هذه الدساتير: الدستور المصري للعام 1971؛ ودستور دولة اإلمارات العربية
المتحدة للعام 1971؛ والدستور اليمني للعام 199465.
وقد حرص مشروع الدستور الفلسطيني على النص على إنشاء محكمة دستورية، ونظم أحكامها في المواد من )184-178( إذ نصت المادة )178( منه على أن: “تنشأ بموجب الدستور، محكمة دستورية تمارس اختصاصها باستقاللية لحماية الشرعية
62 ـ رجا بهلول، مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري، دار الشروق، عمان، 2005، ص 93.
63 ـ يرجى مراجعة: قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 56 لسنة 2005.
64 ـ يرجى مراجعة: قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 104 لسنة 2008، وقرارها رقم 119 لسنة 2005.
65 ـ فاتح عزام، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص67.
65 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
دة الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية التي تنظر في عمل مؤسسات الدولة،...”. وقد حددت المادة )182(66 من مسوفي الطلبات المرفوعة إليها بناء على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم االستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب العام. وهذا يعني أن المادة السابقة أسقطت حق األفراد في الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية )الدعوى األصلية(، في حال تعرض حقوقهم الدستورية لالنتهاك67، لذلك ينبغي العمل على تعديل النص المذكور والسماح لألفراد بالطعن أمام المحكمة الدستورية مباشرة بعدم دستورية القوانين أو األنظمة المخالفة للدستور. ولكي تؤدي المحكمة الدستورية دورها على أكمل وجه، ينبغي أن تكون
على درجة عالية من االستقالل تسمح لها بمراقبة كل من السلطتين: التنفيذية؛ والتشريعية68.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تنفيذ أحكام المحاكم واجب دستوري، وأن االمتناع عن تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، دة الدستور الفلسطيني اعتبرت االعتداء على حقوق اإلنسان دة الدستور. كما أن مسو وعلى ذلك نصت المادة )11( من مسووالمساس بها جريمة ال تسقط بالتقادم، إذ نصت المادة )58( على أن “كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة األساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن الدولة تعويضا عادال
لمن وقع عليه الضرر”.
)2(: رقابة المؤسسات
تنشىء بعض الدول أجهزة أو مؤسسات متخصصة؛ بهدف مراقبة ومتابعة مدى تمتع المواطنين بحقوق اإلنسان، وتتنوع أشكال هذه األجهزة؛ ففي المغرب مثال هنالك وزارة خاصة تعنى بحقوق اإلنسان، وأحيانا تنشأ إدارات لهذا الغرض، كما هو الحال بإدارة حقوق اإلنسان الملحقة بوزارة الخارجية المصرية69، وقد يتم إنشاء مؤسسة خاصة لمراقبة حقوق اإلنسان. واتبع دة على إنشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان.70 فقد نصت دة الدستور الفلسطيني النمط األخير، إذ نصت المسو واضعوا مسوالمادة )59( على أن: “تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعنى بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم،
وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء”.دة الدستور عبثا؛ بل إن الهدف من ذلك هو ضمان قدر من الرسمية ولم يأت النص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة في مسولهذه الهيئة يكفل التجاوب معها من أجهزة الدولة المشتكى ضدها ، كما يشكل ذلك إشارات واضحة على مدى احترام الدستور لحقوق اإلنسان، وحرصه على ضمان تطبيقها.71 ويتضح من النص أنه أحال تنظيم تشكيل الهيئة؛ ومهماتها؛ واختصاصاتها؛
وآليات عملها إلى القانون.
دة الدستور على أن: »تفصل المحكمة الدستورية ،...، في المسائل التالية: 66 ـ نصت المادة )182( من مسو- دستورية القوانين قبل إصدارها، إذا رفع إليها الطلب خالل ثالثين يوما من إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.
- المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واألنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن مجلس الوزراء والتي لها قوة القانون.- تفسير نصوص الدستور في حال التنازع حول حقوق السلطات الثالثة وواجباتها واختصاصاتها، وفي حال التنازع في االختصاص بين رئيس
الدولة ورئيس مجلس الوزراء.- اإلشكاليات المتعلقة بدستورية برامج األحزاب والجمعيات السياسية وأنشطتها، وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه اإلجراءات
مع الدستور.الدستور أو مع إذا تعارض مع القانون أو بعض مواده، تنفيذها، وتقرير بطالن إليها وإجراءات الدولية واالنضمام المعاهدات - دستورية عقد
معاهدة دولية.- أية اختصاصات أخرى أسندت إليها في هذا الدستور.«
67 ـ عصام عابدين، سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني، المرجع السابق، ص 30.
68 ـ رجا بهلول، مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري، المرجع السابق، ص 40.
69 ـ أحمد الرشيدي، آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: نظام التقارير والشكاوى كمثال، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 3، بحث منشور على www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/instructors.../j34.doc :شبكة اإلنترنت، يرجى مراجعة
http://www.ichr.ps :70 ـ لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإلليكتروني للهيئة المستقلة على الرابط التالي
71 ـ مصطفى مرعي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في ضوء المعايير الدولية بشأن الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة التقارير القانونية )17(، رام هللا، 2000، ص 27.
دة الدستور الفلسطيني66 حقوق اإلنسان يف مسو
تمارس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 1993/9/30 العديد من المهمات واالختصاصات التي من أهمها:
متابعة الشكاوى الواردة إليها في ما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين من السلطة الوطنية الفلسطينية أو أحد أجهزتها األمنية أو أي مؤسسات عامة أخرى، وبخاصة االنتهاكات المتعلقة بالتعذيب والتوقيف خالفا ألحكام القانون والتمييز وغيرها.
النظر في مشروعات القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية وابداء الرأي فيها، ومراجعة القوانين واألنظمة السارية لضمان التزامها بمبادئ العدالة وحقوق اإلنسان، ومراقبة مؤسسات الدولة لضمان التزامها بتطبيق هذه التشريعات.
دة الدستور على أن “تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى “هيئة الرقابة كما نصت المادة )157( من مسوالعامة” وينظم القانون اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها. ويعين رئيس “هيئة الرقابة العامة” بقرار من رئيس الدولة، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس النيابي”. ويالحظ من خالل نص المادتين: )59( و )157( دة الدستور تنص على إنشاء هيئتين تقومان بدور الرقابة، ولكن ربما قصد واضعو المشروع أن تقوم األولى بمراقبة أن مسوحقوق اإلنسان وحرياته، وأن تقوم الثانية بالرقابة على أعمال السلطات العامة في الدولة عموما. لكن ربما يجدر بالمشرع، الرقابة أن تكون مهمات أو يتم توضيح الصالحيات واالختصاصات أن لتداخل االختصاصات وتنازع الصالحيات، منعا
منوطة بهيئة واحدة72.
)3(: تقديم العرائض والشكاوى
دة الدستور الفلسطيني الحق للمواطنين بتقديم العرائض والشكاوى إلى السلطات العامة في حال تعرض حقوقهم أعطت مسوالعرائض وتقديم العامة السلطات مخاطبة في الحق مواطن “لكل أنه على دة المسو من )56( المادة نصت إذ لالنتهاك، والشكاوى كتابة وبتوقيعه”. ولم يحدد الدستور آلية معينة لتنظيم عملية تقديم الشكاوى والجهات المختصة بتلقيها ومتابعتها،
والنتائج المترتبة عليها.
72ـ عزيز كايد، القضايا الخالفية في مشروع دستور الدولة الفلسطينية، المركز الفلسطيني للدراسات المسحية والسياسية، رام هللا، 2004، ص 45.
67 دة الدستور الفلسطيني حقوق اإلنسان يف مسو
التوصيات
نورد في ما يلي موجزا ألهم التوصيات التي جرى التقديم لها في ثنايا هذه الدراسة، وهي:
إلى كونه وسيلة أساسية للتعبير عن . 1 دات الدستور، استنادا ضرورة إتباع طريقة تشاركية ديمقراطية لتطوير مسوإرادة الشعب في ما يختص بمستقبله، وأهدافه، ومؤسساته، وأنه ال بد من أن يكون تبني الدستور من خالل طريقة
ديمقراطية.
أهمية أن يعالج الدستور مكانة المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة أو تصادق عليها في النظام القانوني المحلي. . 2فحبذا لو يتم النص على أن تصبح المعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها أو االنضمام إليها في مكانة أعلى من التشريعات العادية، وذلك حتى يمكن االستفادة من هذه المعاهدات في تعديل القوانين المحلية المتعارضة معها، وحتى ال يكون هناك تجاوز لهذه االتفاقيات أو االلتفات عليها عن طريق سن التشريعات المحلية. وقد يفيد النص، من قبيل حفظ التوازن بين السلطتين: التنفيذية؛ والتشريعية، على عدم نفاذ التصديق على االتفاقيات الدولية دون صدورها
بقانون عن الهيئة التشريعية المنتخبة.
الحاجة إلى تعديل أحكام الدستور: لم يتم تقييد سلطة المجلس النيابي في ما يختص بتعديل أحكام الدستور المتعلقة . 3بحقوق اإلنسان. لهذا ربما من الجدير النص في الدستور على هذا الحظر، ما لم يقترن التعديل بموافقة الشعب من
خالل استفتاء عام.
لزوم العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان في أجهزة الدولة بعامة، وفي جهاز الشرطة بخاصة، كي تؤتي المادة . 4)154( من مشروع الدستور أكلها، التي تنص على أن: “الشرطة هيئة مدنية....، وتؤدي واجبها في الحدود التي
رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور”.
السماح لألفراد، وإلتمام الفائدة من النص على تأسيس المحكمة الدستورية، بالطعن أمامها مباشرة بعدم دستورية . 5القوانين أو األنظمة المخالفة للدستور. كما ينبغي أن تكون المحكمة على درجة عالية من االستقالل، ما يسمح لها
بمراقبة كل من السلطتين: التنفيذية؛ والتشريعية73.
التنبه للتداخل في االختصاص الذي قد يتسبب فيه غموض نص كل من المادتين: 59 و157 ، المتعلقتين بتأسيس . 6هيئات رقابية تتشابه فيها االختصاصات والصالحيات، ما يتطلب العمل على توضيح صالحيات واختصاصات كل
منها.
دة دستور وضعت لفلسطين في ظرف معين، ومن شبه المؤكد أنه . 7 أخيرا؛ فإن ما تم تناوله في هذه الدراسة يبقى مسودات غيرها قبل أن تكون الظروف مواتية لتبني دستور لدولة فلسطين. والمأمول أن يستغل سيكون هناك إنتاج لمسودة، لتكون جديرة باعتمادها دستورا متطورا يواكب متطلبات العصر، الوقت والجهد المتاح اآلن لتطوير هذه المسوويشكل لبنة أساسية على طريق بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، التي تراعى فيها الحقوق وتحترم فيها
الحريات.
73 ـ رجا بهلول، مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري، المرجع السابق، ص 40.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسانيف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
دراسة حالة لكل من األردن؛ ومصر؛ ولبنان
فريق البحثمحمد يعقوب - رئيس الفريق
الباحثونصدام أبو عزام منار زعيتر نجوى الشيخ
مساعدو البحث سمر الطراونة مريم نزال
معهد راؤول والينبرغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيضمن برنامج مشروع منح أبحاث حقوق اإلنسان للعام 2012
71 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
الئحة احملتويات
73الملخص التنفيذي للدراسة
75المقدمة
76هدف الدراسة وأهميتها
76مشكلة الدراسة وتساؤالتها
77منهجية الدراسة
78صدق أداة تحليل المضمون وثباتها
79صعوبات الدراسة
80التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة
82األدبيات السابقة
83اإلطار النظري للدراسة: العالقة بين المواطنة والتعليم والتغير االجتماعي في المجتمع
85نتائج الدراسة
91خالصة نتائج التحليل والتوصيات
94المراجع
97الملحق رقم )1( استمارة تحليل مضمون قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في المقررات الدراسية
101الملحق رقم )2( أسئلة مقابالت دراسة المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مقررات التربية الوطنية
Abstract Citizenship from the Perspective of Human Rights in the Curricula of National Education in Arab Countries: a case study each from Jordan, Egypt,
, Lebanon104
73 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
امللخص التنفيذي للدراسة
موضع العربية األقطار من عدد في والوطنية المدنية التربية مقررات واقع على الضوء تسليط إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة، وهي: األردن؛ ومصر؛ ولبنان، وقياس مدى تضمنها قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على تعزيز العملية الديمقراطية وبناء أنظمة حكم رشيدة لفترة ما بعد الربيع العربي أم ال، خصوصا أن عملية التربية الثقافة السائدة أو تغييرها عبر ما تقدمه من قيم ومعرفة تستهدف تمكين الطلبة من إنتاج والتعليم تشكل أحد وسائل إعادة
الخبرات التي تؤهلهم لالضطالع بمتطلبات الحياة، والقيام بالمهمات الموكولة إليهم في المجتمع.
النوعي الظاهري الدراسية من خالل الوصف المقررات الذي يقوم على تحليل المضمون الدراسة منهج تحليل واعتمدت للمناهج. كما اعتمدت على أداة المقابلة مع عدد من أصحاب العالقة والمصلحة في الدول الثالث؛ بهدف تفسير النتائج التي خلص إليها فريق البحث في تحليل المضمون، وبيان وجهات نظرهم في عوامل قوة وضعف المقررات الدراسية في تنشئة
الطلبة على قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان باالعتماد على خبراتهم وتصوراتهم المرتبطة بالمواطنة.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فوارق بين مقررات التربية الوطنية والمدنية في األقطار العربية الثالثة من ناحية كم ونوع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان وأسلوب عرضها. كما تبين من التحليل أن الحجم الكلي لقيم المواطنة ضئيل جدا، وال يتناسب مع الدور الذي يمكن أن تقوم به في عملية إكساب قيم الحداثة للطلبة، وتغيير األنماط الثقافية؛ واالجتماعية؛ منظور حقوق اإلنسان، المواطنة من قيم المتعلقة بغرس المادة إلى زيادة حجم ملحة السائدة، وأن هناك حاجة والسياسية
وخصوصا للفئات األكثر عرضة لالنتهاك، مثل: الطفل؛ والمرأة؛ والمعوقين؛ والعمالة المهاجرة؛ وغيرها.
وفي ضوء ما سبق؛ قدم فريق البحث عددا من التوصيات التي يؤمل أن تسهم في تطوير تعليم التربية الوطنية والمدنية، ليصبح الطالب قادرين على التعامل مع متطلبات المواطنة من منظور حقوق اإلنسان بشكل إيجابي وفاعل، بوصفها شرطا أساسيا لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي، وبحيث تستطيع هذه النظم التعليمية إنتاج جيل عربي جديد مستقل ومبدع ومستوعب للقيم
االجتماعية التي تزدهر في المجتمعات الديمقراطية.
75 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
املقدمة
مما ال شك فيه أن التغيير في أنماط السلوك اإلنساني يرتبط ـ بشكل وثيق ـ بالتغيير في أنساق القيم التي تعد من أهم محددات تشكيله، وهذا التغيير هو مطلب أساسي لبناء الدولة المعاصرة المرتكزة إلى قيم الحداثة، وأهمها: قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان. لذلك تشكل القيم المدخل الرئيس إلعادة بناء المجتمع وتوجيهه نحو غاياته المنشودة في الحرية؛ والعدالة؛ والمساواة؛ والتسامح؛ والتنمية. وفي هذا السياق تكفي نظرة متفحصة إلى واقع المجتمعات العربية للوصول إلى استنتاج عام حول مدى قدرة ثورات الربيع العربي في تحقيق األهداف المشار إليها آنفا، دون حدوث تغيير في أنساق القيم الناظمة لسلوك
األفراد عبر وسائل التربية والتنشئة المختلفة، السيما وأن غالبية هذه الوسائل تسعى إلى إعادة إنتاج القيم القائمة ذاتها.
إن تجربة الدولة العربية الحديثة خالل العقود الماضية، تشير إلى أنها لم تنجح في ترسيخ قيم الحداثة بشكل عام، وقيم المواطنة العربية الدولة على أطلقت العربية اإلنسانية التنمية تقارير إن حتى وشرعيتها، السلطة مصدر بوصفهما خاص، بشكل الحديثة اسم "دولة الثقب االسود"1 في تعبير صريح منها على حالة الفشل في بناء الدولة بمفهومها ووظيفتها الحديثين، وقد الليبرالية التقارير ذلك إلى أسباب متنوعة.2 ولما كانت قيم المواطنة ال تنفصل عن مرتكزات الفلسفة السياسية عزت هذه التي ربطتها بنظرية العقد االجتماعي ودور الدولة في حماية حقوق األفراد وحرياتهم وممتلكاتهم في إطار سيادة القانون، فإن أزمة المواطنة في الدولة العربية الحديثة زادت من حدة الظواهر االجتماعية –السياسية3 التي تشهدها، كما فاقم انتشار ظاهرة العولمة4 وما حملته من متغيرات علمية وتقنية، من حدة هذه األزمة؛ جراء التداعيات االجتماعية والثقافية التي أثرت
في أنماط الحياة؛ ووسائلها؛ ومتطلباتها.5
وفي هذا اإلطار؛ تشير تقارير التنمية اإلنسانية العربية إلى ارتباط أزمة المواطنة في الدولة العربية الحديثة بأساليب تنشئة المعاصر، بمفهومها المواطنة بناء تعيق التي واالجتماعية السياسية القيم إنتاج تعيد التي المعرفة نشر األفراد، وعمليات إذ تؤثر أساليب التسلط والحماية الزائدة بصورة سلبية في نمو االستقاللية والثقة بالنفس، عالوة على زيادة السلبية، وكبح مبادرات التساؤل؛ واالكتشاف؛ والفعل.6 كما تكرس المناهج التعليمية التي تضعها الدولة الخضوع؛ والطاعة؛ والتبعية؛ وال تشجع الفكر النقدي الحر الذي يحفز الطلبة على نقد المسلمات السياسية أو االجتماعية. 7 أي بمعنى آخر؛ تعيد المناهج التعليمية إنتاج القيم المجتمعية التي تعرف طبيعة األدوار االجتماعية المختلفة وتحددها بمجموعة المراكز التي يشغلها كل فرد، وتعلم
األدوار المناسبة لكل مركز.
1 ـ تشكل السلطة التنفيذية ثقبا أسود يحول المجال االجتماعي المحيط به إلى ساحة ال يتحرك فيها أي شيء، وال يفلت من أسارها شيء، للمزيد، يرجى مراجعة: تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2004، المرجع السابق، ص 120، ولالطالع على تشخيص تقارير التنمية اإلنسانية لواقع
األقطار العربية وافتقادها للحريات، يرجى النظر إلى الرابط التالي: http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx
2 ـ كان في مقدمتها طبيعة النشأة التاريخية للدولة العربية الحديثة وارتباطها بكنف الترتيبات االستعمارية، واستمرار حالة التبعية الخارجية وفقدان االستقالل بمفهومه الشامل، باإلضافة إلى غياب العقد االجتماعي وتهميش فكرة اإلرادة العامة الحرة ألعضاء المجتمع واستئثار القوى الحاكمة بالسلطة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة: تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي، عمان: المكتب اإلقليمي
لألمم المتحدة، 2005، ص 78-77.
3 ـ من أهم هذه الظواهر: عدم االستقرار؛ وانتشار العنف؛ والتطرف؛ والتمييز؛ والعنصرية، والفشل في خفض معدالت البطالة؛ والجهل؛ والفقر؛ وغياب سيادة القانون وغيرها.
له؛ أي أنها 4 ـ تعمل آليات العولمة المختلفة على ادماج العالم في بوتقة واحدة، وتكوين المواطن العالمي الذي يتخذ من كوكب األرض وطنا تتجاوز المستوى المحلي إلى العالمي، في حين لم تنجح الدولة العربية في تحقيق المواطنة على المستوى المحلي، األمر الذي يضاعف من حجم
مشكلة المواطنة وبنائها.
5 ـ الحبيب الجنحاني، المواطنة والحرية، ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية »المواطنة في الوطن العربي«، الرباط: منتدى الفكر العربي، 22-21 نيسان/ أبريل 2008 ، ص38-37.
6 ـ تقريرالتنمية اإلنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة، عمان: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2003، ص 53-51
7 ـ إبراهيم ناصر، المواطنة، عمان: دار مكتبة الرائد العلمية، 2002 ص 25-21.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان76 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
لذلك، قد ال تتمكن ثورات الربيع العربي من إحداث تحوالت سياسية واجتماعية تؤسس لديمقراطيات حديثة قائمة على احترام حقوق اإلنسان، طالما أن المجتمعات العربية نفسها ال تمتلك القيم الالزمة لقبول المواطنة وغرسها في النشء الجديد، السيما وأن التغيير في بنية الدولة وقوانينها الناظمة للحريات السياسية والحياة العامة، لن يؤتي ثماره في إحداث تغييرات جادة ودائمة ما لم يرافقه تغيير في النظام التعليمي الذي يعيد إنتاج قيم االستبداد التي تشكل القاعدة الفكرية الندثار العمل الديموقراطي، أو عمليات إصالح سياسي خالل التي شهدت ثورات شعبية العربية الدول أن جملة الحال، المواطنة. وحقيقة قيم وتغيب العام 2011 لم تبد اهتماما سياسيا قويا بإصالح النظم التعليمية فيها، وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان القائمة على قبول التنوع؛
والتعددية؛ واحترام وجهات النظر المختلفة.8
وبناء على ذلك، تطرح الدراسة قضية تكامل أبعاد عملية التغيير السياسي واالجتماعي المطلوب إلنجاح بناء المواطنة ومنع إعادة تكرار إنتاج النظم السلطوية في عالمنا العربي، خصوصا وأن واقع الدولة العربية الحديثة يحتاج إلى وقفة تأمل من كل المعنيين وأصحاب العالقة إلعادة بناء شخصية اإلنسان العربي باالستناد إلى مفاهيم حقوق اإلنسان التي تشكل القيم المستقبلية
التي تسعى إلى تحقيقها شعوب العالم في القرن الحادي والعشرين.
هدف الدراسة وأهميتها:
يتمثل هدف الدراسة المركزي في لفت االنتباه إلى قضية مهمة يغيب عنها االهتمام الكافي في العالم العربي حتى اللحظة الراهنة، وتتلخص في تحليل مضمون الثقافة السائدة؛ وتحليل أطر عملية التغيير الهادفة إلى إيجاد ثقافة المواطنة بوصفها شرطا أساسيا لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي. وحقيقة الحال، أن عملية التربية والتعليم تشكل إحدى وسائل إعادة إنتاج الثقافة السائدة أو تغييرها عبر ما تقدمه من قيم ومعرفة تستهدف تمكين األجيال الناشئة من الخبرات التي تؤهلها لالضطالع
بمتطلبات الحياة، والقيام بالمهمات الموكولة إليها في المجتمع.
األردن؛ وهي: العربية، األقطار من عدد في والوطنية المدنية التربية مقررات واقع على الضوء الدراسة لذلك، سلطت ومصر؛ ولبنان، إذ أبرزت أوجه القوة والنقص التي تشوب المناهج من ناحية مدى تضمنها لقيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على تعزيز العملية الديمقراطية وبناء أنظمة حكم رشيدة أم ال، باإلضافة إلى اقتراح القيم المرغوب فيها لتدعيم مناهج التربية المدنية والوطنية في المراحل الدراسية المختلفة التي قد تسهم في تحقيق الغايات المنشودة.
بناء المنشودة، وأهمها نتائج ذات داللة، في تحقيق األهداف إليه من بما تصل الدراسة، تفيد هذه أن البحث ويأمل فريق المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، وإعادة النظر في بناء مناهج مقررات التربية المدنية والوطنية فـي مراحل التعليم المختلفة في الدول العربية سواء على صعيد األهداف أم المحتوى. كما يأمل أن يستفيد منها أصحاب المصلحة والمعنيين في مجاالت التربية والمواطنة وحقوق اإلنسان في الدول مجتمع الدراسة، بما يسهم في تطوير هذه المناهج وتقويمها؛ انسجاما مع التغيرات
السياسية التي تشهدها المنطقة جراء ثورات الربيع العربي وحركات اإلصالح الشاملة فيها.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
تواجه الدولة العربية الحديثة كثيرا من التحديات، أخطرها أزمة المواطنة وما يصاحبها من تداعيات سياسية؛ واقتصادية؛ واجتماعية؛ وثقافية. وقد أدت التغيرات التي شهدها العالم العربي جراء ثورات الربيع العربي العام 2011 إلى زيادة االهتمام بترسيخ قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان لدى األفراد باعتبارها صمام أمان لتماسك النسيج المجتمعي في هذه الدول، وضمانة مهمة لنجاح عمليات التحول الديمقراطي ووقف إعادة إنتاج قيم أنظمة الحكم السلطوية، خصوصا وأن ثورات الربيع العربي قد ال تثمر عن تحوالت ديمقراطية ملموسة، طالما أن النظام التعليمي قد يعيد إنتاج قيم االستبداد التي تغيب قيم المواطنة التي تشكل القاعدة الفكرية الزدهار الديموقراطية، عالوة على تعليم الطلبة قيما هي أبعد ما تكون عن ثقافة حقوق اإلنسان التي
تقبل المساواة؛ والتنوع؛ والتعددية؛ والتسامح مع اآلراء المختلفة.
ولما كان ترسيخ قيم المواطنة يتطلب إصالح التعليم وتزويد األفراد بالمعارف والقيم والمهارات التي تؤثر في استعداد الطلبة
8 ـ محمد فاعور ومروان المعشر، التربية من أجل المواطنة في العالم العربي: مفتاح المستقبل، بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، تشرين األول/ أكتوبر 2011، ص 3-1.
77 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
للمشاركة العامة وتساعدهم على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات؛ فإن تعليم قيم المواطنة يقع عادة في صلب عملية المجتمعات في تتوطد لن الديمقراطية أن إلى اإلشارة الديمقراطية. وتجدر العملية الالزمة إلنجاح المهارات الطلبة تعليم العربية إال في ظل ثقافة حقوق اإلنسان، السيما وأن العالم أجمع على اعتبار حقوق اإلنسان شرطا موضوعيا لترسيخ قيم ؛ وأخالقية؛ اجتماعية قيمة والواجبات الحقوق في المواطنين بين المساواة أن تصبح معه يفترض الذي األمر المواطنة؛ وممارسة سلوكية. 9 لذلك ثمة حاجة ملحة إلصالح التعليم من أجل تعزيز المواطنة من منظور حقوق اإلنسان إذا ما أريد
للديمقراطية أن تترسخ في العالم العربي.
التاريخ؛ المختلفة: بفروعها االجتماعية الدراسات ومقررات خصوصا، والوطنية المدنية التربية مقررات تسهم وعليه؛ السياسي النظام وقيم عن معلومات تتضمنه من لما المواطنة قيم تنمية في والدين وغيرها عموما، واللغات؛ والجغرافيا؛ ومؤسسات الدولة؛ والحقوق والواجبات الوطنية؛ واالنتماء والوالء للوطن؛ وتعزيز الوحدة الوطنية؛ باإلضافة إلى تضمنها مفاهيم عن المساواة؛ والعدل االجتماعي؛ والتعاون؛ والتسامح؛ وتقبل االختالف في اآلراء؛ والتعددية؛ والمشاركة.10 كما أنها
تعكس واقع المجتمع؛ وآماله؛ وتطلعاته؛ وماضيه؛ وحاضره ومستقبله.
وفي هذا الصدد، يتمثل أحد أهم المشكالت التي تواجه المجتمعات العربية في بناء المواطنة بمفهومها المعاصر القائم على حقوق اإلنسان، ما يتطلب إلقاء الضوء على دور النسق التعليمي في مجال إكساب قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، أو
ما يطلق عليه "التنشئة السياسية االجتماعية" التي تعد أهم وسائل بناء المواطنة، وإنجاح عملية التحول الديمقراطي.
وفي ضوء ما تقدم ؛ تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :" ما أبرز قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربية المدنية والوطنية آلخر صف من صفوف المرحلة الثانوية في الدول مجتمع الدراسة )األردن؛
ومصر؛ ولبنان(؟" ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية :
ما مدى تضمن مقررات التربية المدنية والوطنية لقيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في كتب الصف األخير من صفوف المرحلة الثانوية في الدول مجتمع الدراسة؟
كيف يعرض مفهوم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مناهج التربية المدنية والوطنية في الصف األخير من صفوف المرحلة الثانوية؟
ما هي أوجه الشبه واالختالف بين الدول مجتمع الدراسة في مجال تعليم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مقررات التربية المدنية والوطنية؟
ما هي جوانب القوة والضعف في منهاج التربية المدنية والوطنية في الدول مجتمع الدراسة من وجهة نظر أصحاب المصلحة والعالقة؟
المدنية التربية بها مقررات تقوم الذي الدور البحث من تحديد تمكن فريق أن هذه االسئلة إلى وتقتضي اإلشارة والوطنية في غرس قيم المواطنة التي تتناسب ومفاهيم حقوق اإلنسان واتجاهاتها، والدور المطلوب لبناء دولة تحترم
المواطنة وحقوق اإلنسان.
منهجية الدراسة:
استخدم فريق البحث منهج تحليل المحتوى )Content Analysis( لإلجابة عن سؤال الدراسة األساسي واألسئلة المتفرعه عنه التي تحمل األرقام: )1، 2، 3(، وذلك كي يتمكن من الكشف عن أبرز قيم المواطنة المتضمنة في مقررات التربية المدنية والوطنية آلخر صف من صفوف المرحلة الثانوية في دول مجتمع الدراسة )األردن؛ ومصر؛ ولبنان(، إذ يصف هذا المنهج
المحتوى وصفا كميا موضوعيا منظما.
9 ـ علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، المستقبل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 264، 2001، ص 104 – 125.
10 ـ زكي رمزي مرتجى و محمود محمد الرنتيسي، تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، حزيران/ يونيو 2011، ص 161 –195.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان78 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
وجدير بالذكر أنه تم بناء أداة تحليل المضمون لتشمل فئات التحليل كافة قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وخصوصا أن هذه الحقوق متواشجة ومتالحمة ال انفصال بين مكوناتها، وأساسها المساواة وعدم التمييز بين المنتفعين بها. باإلضافة إلى الواجبات التي تضمنتها الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان. كما تم االستعانة في
هذه الخطوة باألدب النظري عن تعليم المواطنة وحقوق اإلنسان والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث.11
وبهدف اإلجابة عن السؤال رقم )4( من تساؤالت الدراسة؛ قام فريق البحث بتصميم استمارة خاصة بإجراء المقابالت مع أصحاب العالقة والمصلحة12 في الدول مجتمع الدراسة لتفسير النتائج التي خلص إليها فريق البحث في تحليل المضمون، منظور حقوق المواطنة من قيم الطلبة على تنشئة الدراسية في المقررات وبيان وجهات نظرهم في عوامل قوة وضعف
اإلنسان باالعتماد على خبراتهم وتصوراتهم المرتبطة بالمواطنة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة اقتصرت على مقررات التربية المدنية والوطنية13 آلخر صف من صفوف المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2012/2011، وذلك لسببين: األول، أهمية هذه المرحلة العمرية التي يكون فيها الطلبة قادرين على االستجابة لما يعرض عليهم من القيم سلبا أو إيجابا، وعادة ما تسعى فلسفة التعليم إلى توظيف هذه القدرة لدى الطلبة للوصول إلى سلوك مرغوب فيه. والثاني، أن هذه المرحلة العمرية تمثل المرحلة األخيرة من التعليم المدرسي التي يتبعها االنتقال إلى التعليم الجامعي أو الدخول في مجال العمل؛ أي أن هؤالء الطلبة هم من سيقود المجتمع ويشكل الحكومة في المستقبل القريب.14 وحقيقة الحال أن االقتصار على المرحلة الثانوية يمكن فريق البحث من عقد المقارنات بين الدول مجتمع الدراسة، إذ تقتصر
كتب التربية المدنية والوطنية في مصرعلى المرحلة الثانوية فقط.
كما أن اختيار هذه الدول الثالث من جملة الدول العربية، بصفتها موضع الدراسة، قد ارتبط بأسباب عدة يأتي في مقدمتها: حدوث تغيير في النظام السياسي المصري عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، بما يعنيه ذلك من أن مصر يمكن اعتبارها إحدى النماذج لألقطار العربية التي حصل فيها تغيير للنظام السياسي، عدا عن كونها أكبر دولة عربية. أما األردن؛ فحاول التكيف مع ثورات الربيع العربي من خالل جملة من اإلصالحات السياسية والقانونية التي أدخلها إلى بنية النظام السياسي، وهو يمثل عينة لألقطار العربية التي حاولت أنظمتها السياسية التكيف التدريجي مع المتغيرات السياسية التي أعقبت ثورات الربيع العربي. وأختير لبنان لكونه يمثل أحد األقطار العربية التي لم تتأثر بثورات الربيع العربي ألسباب عديدة، أهمها طبيعة
نظامه السياسي واالجتماعي، باإلضافة إلى أن لبنان دولة تقوم على التعددية الدينية؛ والمذهبية؛ والسياسية. 15
صدق أداة تحليل المضمون وثباتها:
للتأكد من صدق أداة تحليل المضمون تم عرضها على ثالثة خبراء متخصصين في مجال دراسة المواطنة وحقوق اإلنسان16،
11 ـ اعتمدت األداة على التصنيف األكثر شموال ووضوحا لتحليل المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية، وهو الذي يقسم حقوق اإلنسان إلى سبعة مبادئ أساسية تشمل جميع الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وهي: الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحقوق المدنية؛ والحقوق السياسية؛ والحقوق االقتصادية؛ والحقوق االجتماعية؛ والحقوق الثقافية؛ وحقوق التضامن والتسامح، باإلضافة إلى القيم األخالقية وقيم الوحدة الوطنية وواجبات المواطن. وقد وضع )99( مؤشرا فرعيا لقياس هذه المبادئ الكلية، إذ حرص فريق البحث على أن تكون هذه األبعاد
متصفة بتكامل المعنى والمبنى، والوضوح باإلضافة للشمول.
12 ـ تم إجراء 20 مقابلة في كل دولة، منها 6 مقابالت مع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون التربية المدنية والوطنية آلخر صف في المرحلة الثانوية، و4 مقابالت مع أكاديميين معنيين بحقوق اإلنسان والمواطنة والتربية والمناهج، و2 مقابلتين مع المسؤولين عن إعداد المناهج في وزارة
التربية والتعليم، و4 أربع مقابالت مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتربية والتعليم والمواطنة وحقوق اإلنسان.
13 ـ تجدر اإلشارة إلى أن هذه المقررات معتمدة من وزارة التربية والتعليم في هذه الدول، وتم تدريسها في العام الدراسي 2012/2011. وقد بلغ عدد الدروس في هذه الكتب مجتمعة )67( درسا بمجموع صفحات بلغ )558( صفحة.
14 ـ عادة ما يمثل التعليم الثانوني أهمية خاصة في تكوين القيم االجتماعية للطلبة كون التعليم الجامعي أكاديمي النزعة ومتخصصا، األمر الذي يستلزم معه تفعيل دور المدرسة في اإلعداد للمواطنة وقيمها المختلفة.
15 ـ هناك سبب عام الختيار هذه الدول كمحل دراسة إقليمية تتعلق بمعرفة أفراد الفريق لبعضهم بعضا، وبحجم المخصصات المالية المتوافرة إلجراء هذه الدراسة.
16ـ تم عرض أداة تحليل المضمون )االستمارة( على ثالثة محكمين من ذوي الخبرة األكاديمية يعملون في جامعات: اليرموك؛ والهاشمية؛ والعلوم اإلسالمية العالمية، وقد روعي في اختيار هؤالء المحكمين االختصاص في مجاالت: التربية؛ والقانون؛ والعلوم السياسية.
79 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
إذ جرى تضمين مالحظاتهم في األداة سواء المتعلقة بمدى شمولها وكفاية أبعادها، أو تلك المتعلقة بصياغة بعض األبعاد أو المؤشرات الفرعية لها لتكون مفهومة وواضحة، األمر الذي يفترض معه أن األداة صالحة إلظهار ما صممت لقياسه، وأنها
تتمتع بالصدق.
وقد قام رئيس فريق البحث وإحدى مساعدتيه – كل على حدة – بقراءة الدروس الواردة في المقررات عينة البحث قراءة واعية؛ بهدف التعرف على قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان المتضمنة فيها، وكما وردت في أداة التحليل، ثم تحديد المدلول لكل وحدة من وحدات المضمون، وتحديد المجال الذي تنتمي له الفقرة )الترميز(17. وهكذا سجل تكرار واحد لكل حق ظهر في المضمون الذي تم تحليله، أو كلما كان النص يؤدي في مفهومه إلى حق )الفكرة(، ثم جرى تفريغ نتائج التحليل في جداول تكرارية لكل كتاب.18 وجدير بالذكر أن رئيس فريق البحث وإحدى مساعدتيه قام كل منهما ولوحده بقراءة الدروس الواردة في المقررات عينة البحث مرتين متباعدتين؛ بمعدل عشرة أيام، ليتأكد كل منهما بأن الترميز الذي دونه على متن الكتاب لم يتغير، وفيما إذا كانت هناك تغيرات قد حدثت في التعرف على مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة فيها. وهذه الخطوة
تسهم في جعل عملية التحليل أكثر دقة.
كما جرى حساب نسبة االتفاق بين رئيس فريق البحث ومساعدته في تحليل الفقرات19، التي بلغت 0.86، ثم استخراج معامل الثبات لعملية التحليل وفقا لمعادلة هولستي20، الذي بلغ 0.92، وهي قيمة مرتفعة تؤكد سالمة التحليل وثباته.21 وفي نهاية
المطاف؛ أستخدم برنامج Excel لتحليل البيانات رقميا، ومعالجتها، واستخراج النتائج. 22
صعوبات الدراسة
واجه فريق البحث جملة من الصعوبات في أثناء إعداده لهذه الدراسة، التي تمكن من التغلب عليها، وتجاوزها: علميا؛ وفنيا، ويمكن ذكر أبرز هذه الصعوبات بما يلي:
تبني نظرية سياسية تربوية واضحة يمكن االنطالق منها في صياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها، وتحليل النتائج وفقا . 1لها، وقد كانت هناك أكثر من نظرية تبين أن أفضلها هي "النظرية التربوية النقدية".
اختالف النسق التعليمي بين الدول موضع الدراسة الذي يستدل عليه من خالل األسئلة التالية: هل تعليم مادة التربية . 2المدنية والوطنية يتم بشكل مستقل أم عبر تضمينها في مناهج المقررات الدراسية األخرى؟ وكذلك هل تدرس ضمن جميع المراحل التعليمية أم في مراحل تعليمية محددة؟23 وهل هناك مصفوفة زمنية معتمدة بشكل رسمي من الدولة المصفوفة غير إن هذه أم التكامل والشمول، يحقق مبدأ تعليمية، وبشكل قيم معينة في كل مرحلة إدماج تراعي
موجودة أصال؟.
17ـ وحدة الترميز هي العنصر أو الجزء من المحتوى الذي اعتمد عليه فريق البحث في تحليل المحتوى، ووحدة الترميز التي استخدمت في هذه الدراسة هي الجملة المفيدة: لفظا؛ ومعنى.
18ـ وحدة التكرار تفيد في العد والقياس؛ بهدف إعطاء الصفة الكمية للقيم المتضمنة.
19ـ أستخرجت نسبة االتفاق من خالل تقسيم مجموع الفقرات التي تم االتفاق عليها من قبل الباحث ومساعدته على مجموع الفقرات التي حللت من قبلهم.
20ـ أستخرج معامل الثبات وفقا لمعادلة هولستي من خالل ضرب عدد الذين أجروا التحليل في متوسط االتفاق بينهما مقسوما على واحد مضافا/ مجموعا إلى )عدد الذين أجروا التحليل ناقص واحد( مضروبا في متوسط االتفاق بينهم.
21ـ يذكر الباحثون اإلحصائيون أن القيمة من 0.61 إلى 0.80 تعد قيمة كبيرة.
22ـ اعتمدت المعالجة اإلحصائية على احتساب التكرارات والنسب المئوية لكل قيمة من قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان.
23ـ في مقترح الدراسة األولي اعتمد فريق البحث دراسة صفين في كل دولة هما: الصف األخير من المرحلة الثانوية والصف األخير من المرحلة االبتدائية، لكن فيما بعد تبين له أن مصر ال تدرس مقررات التربية الوطنية والمدنية بشكل مستقل وعلى هيئة كتاب خاص إال في المرحلة الثانوية
فقط، ما جعل فريق الدراسة يقتصر على دراسة آخر صف من صفوف المرحلة الثانوية لضبط عملية المقارنة.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان80 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
اختالف طريقة التعبيرعن الحق الوارد في مناهج الدول مجتمع الدراسة، وطريقة التطرق إليه والتعامل معه. وقد . 3اعتمد فريق البحث على عناصر الحق الموجودة في التعليقات العامة للجان التعاقدية الدولية ـ ما أمكن ذلك ـ لضمان
إدراج هذا الحق في إطاره الواضح في عملية التحليل.
كانت هناك صعوبة في توزيع االستمارة الخاصة بالمقابالت في الدول موضع الدراسة، وتحديدا مصر، والسيما في . 4ظل محدودية الفترة الزمنية لتجهيز الدراسة بشكلها النهائي.24
التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
أوال: مفهوم القيم: الثقافة العامة للمجتمع، وتتخذ أوجها طيبة أو شريرة أو بين ذلك، تعرف القيم بأنها موجهات محددة للسلوك تظهر ضمن فهي بمثابة اعتقاد ثابت بنمط معين من السلوك بأنه أفضل نمط سلوكي سواء على الصعيد الذاتي أو االجتماعي.25 وتعرف أيضا بأنها نماذج معيارية تحدد السلوك المرغوب في نظام معين تجاه بيئة معينة دون تمييز بين عمل الوحدات وأوضاعها الخاصة، ولذلك تمثل هذه القيم بؤرة التكامل بالنسبة ألي ثقافة، فتوجه السلوك والتصرف في بيئة معينة.26 كما تعرف القيم بأنها "مجموعة من المقاييس التي تجعل فردا ما أو جماعة معينة يصدران حكما نحو موضوع محدد أو شيء ما بأنه مرغوب أو غير مرغوب فيه، وذلك في ضوء تقدير الفرد أو الجماعة لهذه األشياء أو الموضوعات وفق ما يتلقاه من معارف وخبرات ومبادئ، وما يؤمن به من مثل في اإلطار الذي يعيش فيه، ويستدل على القيم من خالل أفعال وأقوال وتصرفات الفرد أو باعتبارها أو والقبح بالحسن األشياء على بها يحكم التي المعايير من مجموعة القيم إن القول يمكن وهكذا الجماعة".27
تفضيالت يختارها الفرد، أو باعتبارها حاجات؛ ودوافع؛ واهتمامات؛ واتجاهات؛ ومعتقدات ترتبط بالفرد.
كما تقدم هذه التعاريف نتيجة أساسية مفادها أن التغيير الثقافي يسبق عادة التغير في البناء االجتماعي. وهنا تؤدي المدرسة دورا أساسيا في إعداد الطلبة ألدوار مستقبلية من خالل تنشئتهم على قيم المجتمع األساسية؛ أي أن بناء المواطنة يعتمد على نسبة السكان الذين يخضعون الستراتيجية التحديث السلوكي، كما أن مظاهر اإلصالح السياسي واالجتماعي في أي دولة يجب
أن يتماشى مع مظاهر اإلصالح الثقافي؛ وذلك كون الثقافة هي المعيار لنجاح أي إصالح وتحقيق غاياته.28
ثانيا: مفهوم المواطنة:
انعكس سياق التطور التاريخي لهذا المفهوم على تعريفاته المختلفة؛ فانتقل من اإلشارة إلى نسبة االنتماء التاريخي والثقافي أبعاد جديدة تشتمل على: الحقوق؛ والواجبات؛ بالتعلق به أكثر من غيره؛ إلى تضمن والحضاري إلى بلد معين والشعور والمبادرات؛ والمسؤوليات تجاه النفس وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها. وهذه الحقوق والواجبات ال تمارس إال في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة؛ وتكافؤ الفرص؛ وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ؛ وحمايتها؛
وفتح آفاق ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل بفعالية.29
24 ـ كانت هناك صعوبة في الحصول على موافقات رسمية إلجراء مقابالت مع المدرسين لمواد التربية الوطنية في الدول الثالث، كما أن هناك من انتقد فكرة البحث في المواطنة وحقوق اإلنسان أصال انطالقا من اعتبارات سياسية، والسيما األشخاص الرسميين، كما كانت هناك صعوبة في إيجاد مؤسسات مجتمع مدني في الدول الثالث معنية بالمواطنة وحقوق اإلنسان ولديها عمل أو رؤية واضحة في هذا المجال، فاضطررنا إلى إجراء مقابالت مع مؤسسات يمكن القول إنها األقرب إلى الموضوع، وكان معيارها غير موضوعي انطالقا من رؤية عامة شاملة تحتم استنتاجا معينا،
كما عجز هؤالء جميعا عن تقديم تفسير واضح لبعض النتائج التي عرضت عليهم.
25 ـ كاليد كلكهوهن ووليم كلي، مفهوم الثقافة، في كتاب: األنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث، تحرير رالف لنتون، ترجمة: عبدالملك الناشف )بيروت: المكتبة العصرية، 1967( ص 178.
26 ـ تالكوت بارسونز، النظريات الوظيفية للتغيير، في كتاب: التغيير االجتماعي، مصادره، نماذجه، نتائجه، تحرير: اميتالي اتزيوني، ترجمة محمد حسونه )دمشق: وزارة الثقافة، 1984( ص 135.
27 ـ محمود عقل، القيم السلوكية، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2001، ص 14.
28 ـ تالكوت بارسونز، المرجع السابق، ص 143-140.
29 ـ فارس الوقيان، المواطنة في الكويت: مكوناتها وتحدياتها. وأيضا خضري حمزة، المواطنة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي واإلداري، مجلة علوم إنسانية، السنة السابعة، العدد 45، ربيع 2010. ص 4.
81 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
عرفت المواطنة بأنها: "عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق، والمواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقا سياسية".30 وتعرف بأنها االرتباط االجتماعي والقانوني بين األفراد، الذي يلتزم بموجبه الفرد اجتماعيا وقانونيا بالجمع بين الفردية والديمقراطية، ويكون الفرد مواطنا إذا ما التزم باحترام القانون؛ وإتباع القواعد؛ ودفع الضرائب؛ والمحافظة على أموال الدولة؛ وأداء الخدمة العسكرية؛ واإلسهام في نهضة المجتمع المحلي؛ وتحسين نوعية الحياة السياسية والمدنية للدولة.31 كما تعرف على أنها تمثل وضعية أو مكانة الفرد في المجتمع باعتباره مواطنا، وبما يستتبع ذلك من تمتعه بمجموعة من
الحقوق، والواجبات، والهويات التي تربط المواطنين بالدولة القومية التي يتبعونها.32
ويمكن القول إن المواطنة باعتبارها ظاهرة اجتماعية نمائية ذات طابع ارتقائي؛ قد ظهرت على مدى قرون عدة في ثالثة أبعاد هي: ، البعد المدني للمواطنة الذي برز على السطح في إنجلترا خالل القرن الثامن عشر، ويزود المواطنين بالحقوق الفردية، مثل: حرية التعبير عن الرأي؛ وحق الملكية؛ والعدالة والمساواة أمام القانون. أما البعد السياسي للمواطنة؛ فبرز للمرة األولى خالل القرن التاسع عشر ليمنح المواطنين جميع الفرص واإلمكانيات الالزمة لممارسة السلطة السياسية المتاحة لهم، وذلك من خالل المشاركة في العملية السياسية في المجتمع. وأخيرا البعد االجتماعي للمواطنة الذي ظهر للمرة األولى خالل القرن العشرين ليزود المواطنين بجميع الخدمات الصحية؛ والتعليمية؛ وخدمات الرفاهية الالزمة لهم، وليتيح لهم المشاركة الكاملة
في مجتمعاتهم الثقافية، فضال عن المشاركة في ثقافاتهم المدنية الوطنية.33
خالصة تعريفات مفهوم المواطنة أنها تحدد الحقوق والواجبات التي يفرضها انتماء الفرد إلى مجتمع معين في مكان محدد، كما أنها ترتبط بشعور الفرد نحو مجتمعه ؛ ووطنه؛ واعتزازه باالنتماء إليه؛ واستعداده للتضحية من أجله؛ وإقباله طواعية على المشاركة في أنشطة وإجراءات وأعمال تستهدف المصلحة العامة. وقد ارتبط المفهوم تاريخيا بالتطور في حق المشاركة لذلك هناك خمسة القانون. أمام المساواة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، فضال عن النشاطات بفاعلية ومسؤولية في جوانب رئيسة للمواطنة تتمثل في: األمانة نحو الناس الذين يشاركونه االنتماء إلى الوطن نفسه؛ واإلخالص والشعور الداخلي بوجوب االهتمام بمن يعيش ضمن نطاق الوطن؛ واالحترام الذي يبدي فيه الفرد سماحا آلراء اآلخرين ووجهات نظرهم، وإن كانت ال تتفق مع وجهة نظره ورأيه الخاص؛عالوة على تقبل القوانين واألعراف السائدة؛ وأخيرا المسؤولية التي يتحمل
بموجبها الفرد مسؤولية فردية نحو نفسه، ومسؤولية اجتماعية نحو المجتمع تؤدي إلى نموه.34
ثالثا: التربية على المواطنة
يتفق معظم علماء االجتماع السياسي والتربية على أن هدف التربية هو تحقيق المواطنة.35 لذلك يقصد بالتربـية على المواطنة المتكامل والمتوازن في جوانب شخصيته: فكريا؛ وروحيا؛ واجتماعيا؛ الفرد بناء التي تستهدف التنشئة االجتماعية عملية وإنسانيا، والواعي لحقوقه والملتزم بواجباته، والمؤمن بحقوق اإلنسان ومبادئ العدالة والمساواة للناس كافة، والقادر على اإلنتاج والتنمية والمبادرة المبدعة، والمعتز بانتمائه إلى وطنه، والمتحلي بالروح العلمية والموضوعية والسلوك الديمقراطي، والمتسم بالوسطية والتسامح واالعتدال. أي أن التربية على المواطنة هي تربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق،
الفكرية الندوة وقائع السياسية، الممارسات ودالالت األردنية التشريعية المنظومة في المواطنة لمبدأ القانونية المقاربات الحسبان، عيد ـ 30اإلنسان، 2011، لحقوق الوطني المركز يعقوب ومحمد فضيالت، عمان: تحرير محمد الواقع« وإشكاليات الحقوقي المنظور بين »المواطنة
ص27.
ERIC Digest-( .3-Patrick John, The Concept of Citizenship in Education for Democracy 1999,p.2 31.)ED432532-www.eric.ed.gov
p 129 , 6Age. Educational Researcher. Washington: Apr200832
GRÁINNEMcKeever, Citizenship and Social Exclusion; The Re-Integration of Political Ex-Prisoners 33.>425-in Northern Ireland . The British Journal of Criminology. London: May. Vol. 47, Iss. 3,2007p 424
Gary Hopkins, Teaching Citizenship’s Five Themes 1997, On- Line http://www.education-world. 34com/a_curr/curr008.shtml
35 ـ بسام محمد أبو حشيش، دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات غزة، مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( المجلد الرابع عشر، العدد األول، كانون الثاني/ يناير 2010، ص 260-258.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان82 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
وتربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية عبر منهجية شاملة تربط بين المعرفة والوجدان واألداء. باإلضافة إلى أنها تربية على ثقافة التسامح والحوار والسالم والمبادرة وخلق فرص عمل جديدة ال على التكيف مع البيئة فقط، كما أنها تربية على األسلوب العلمي، والتفكير النقدي في المناقشة والبحث عن الوقائع واألدلة وتحمل المسؤولية تجاه حقوق األفراد والجماعات بما يؤدي إلى تماسك المجتمع ووحدته. والتربية على المواطنة تتمثل في ثالثة أبعاد هي: البعد المعرفي؛ والبعد الوجداني؛
والبعد األدائي أو السلوكي.36
وفي هذا اإلطار؛ يرى علماء االجتماع والتربية أن للتعليم في المدرسة وظائف أساسية عدة من أهمها: نقل الثقافة والمعرفة والمعلومات في المجتمع؛ واكتساب القيم والميول واالتجاهات؛ ومن ثم تنمية قيم المواطنة وسلوكياتها. وهنا تؤدي المناهج المدرسية دورا مهما في بناء المواطنة لدى الطلبة بشكل خاص، وهذا يتطلب أن تقدم المناهج تصورا واضحا لمفهوم المواطنة،
وتساعد الطلبة على القيام بأدوارهم المستقبلية.37
رابعا: حقوق اإلنسان:
والسياسية؛ الفكرية؛ المختلفة: بأصنافها الحديثة األدبيات في اإلنسان" "حقوق مصطلح استخدام شيوع من الرغم على والقانونية؛ والتربوية، وكذلك في الخطاب السياسي المعاصر بشكل عام، إال أن الباحثين اختلفوا في تعريفه باختالف المدارس قانونية أنها ضمانات تقديم تعريف إجرائي لحقوق اإلنسان على السياق المعرفية والفكرية واأليديولوجية. ويمكن في هذا عالمية تحمي األفراد والمجموعات من األفعال التي تعيق التمتع بالحريات األساسية وكرامة اإلنسان، وأن أهم ميزات حقوق قانونا؛ وتركز على كرامة اإلنسان؛ وتحمي األفراد والمجموعات؛ وملزمة أنها مضمونة دوليا؛ ومحمية يلي: اإلنسان ما للدول والجهات الفاعلة فيها؛ وأنه اليمكن التنازل عنها أو نزعها؛ وهي متساوية ومترابطة؛ وعالمية.38 وقد تم االعتماد على كوك الدولية لحقوق اإلنسان في استخراج وتصنيف جملة الحقوق اإلنسانية التي ينبغي قياسها في مقررات التربية المدنية الص
والوطنية.39
األدبيات السابقة:أما التي اعتمدت عليها الدراسة،40 ويمكن تصنيفها إلى دراسات نظرية وأخرى تطبيقية. هناك جملة من األدبيات السابقة الدراسات التطبيقية؛ فقد تناولت تحليل مناهج التربية المدنية والوطنية واالجتماعية، أو تناولت قيم المواطنة وتخطيط المناهج الدراسية في ضوئها، أو مدى تمثل الطلبة لقيم المواطنة ومفاهيمها. كما تناولت هذه الدراسات مدى تضمن المقررات التربوية
لمفاهيم حقوق اإلنسان. وقد خلص فريق البحث إلى جملة من النتائج التي تضمنتها الدراسات السابقة، وأهمها:
والشباب الناشئة لتزويد الدراسية والمناهج المقررات وتخطيط بالمواطنة، لالهتمام عالميا اتجاها الدراسات هذه عكست بجوانب التعلم الالزمة إلعداد المواطنة المسؤولة في المستقبل.
كشفت نتائج الدراسات عن ضرورة االهتمام بتطوير مناهج مقررات التربية الوطنية واالجتماعية لتقوم بالدور المنوط بها في التربية السياسية للناشئة، وإعدادهم للمواطنة المسؤولة في المستقبل.
36ـ محمود السيد، من قضايا التربية على المواطنة، مؤسسة الفكر العربي – 2010، نقال عن الرابط اإللكتروني: /http://www.arabthought.org/content
37ـ علي ليلة وآخرون، التغير االجتماعي والثقافي، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2010.
38ـ دليل لتدريب المهنيين في مجال حقوق اإلنسان، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، العدد 6، جنيف، 1999، ص 51-49. محمد الموسى ومحمد علوان، القانون الدولي لحقوق اإلنسان: الحقوق المحمية، عمان: دار الثقافة للنشر، 2006، ص 11-32. مصطفى قاسم،
التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2006.
39ـ من أهم هذه الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
40ـ بالنظر إلى اشتراط معهد راؤول والينبرغ لدراسات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني أال تتجاوز الدراسة 30 صفحة، يكتفي فريق البحث بذكر عناوين أهم األدبيات السابقة التي اطلع عليها في قائمة المراجع دون استعراضها ومناقشة منهجها ونتائجها.
83 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
لقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة، وتفسير النتائج وتحليلها التي خلصت اليها، لكن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة التي تناولت تحليل مضمون المواطنة، هو انفرادها في تحليل قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان المتضمنة في محتوى كتب التربية المدنية والوطنية آلخر صف من صفوف المرحلة الثانوية في دول عربية عدة ، وبما يعنيه ذلك من دخول هؤالء إلى مرحلة جديدة في حياتهم سواء على الصعيد العملي أم الدراسي. كما تشكل هذه الدراسة أساسا إلجراء دراسات أخرى في المستقبل سواء على صعيد تحليل مضمون قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في المقررات التعليمية داخل الدولة نفسها أو على صعيد إعداد دراسات مقارنة بين أكثر من دولة
عربية أو على صعيد إجراء دراسات مشابهة في دول أخرى لم يتم التطرق إليها في هذه الدراسة.
اإلطار النظري للدراسة: العالقة بين المواطنة والتعليم والتغير االجتماعي في المجتمع
ال تنفصل فكرة المواطنة عن الفلسفة السياسية الليبرالية التي ظهرت في القرن الثامن عشر، وربطت المواطنة بنشوء الدولة بوصفها إطارا اجتماعيا لحماية حقوق األفراد وحرياتهم وممتلكاتهم في إطار سيادة القانون، كما شهد القرن التاسع عشر تطورا في فكرة المواطنة من خالل تعزيز الحقوق السياسية بعد إقرار الحقوق المدنية، وبشكل خاص قبول مبدأ االقتراع العام. بمعنى أنه ال يمكن فصل فكرة المواطنة عن فلسفة األنوار التي بحثت في شرعية السلطة السياسية ومفهوم العقد االجتماعي القائم على فكرة اإلرادة العامة، وأن الحكومة أداة ضمان الحرية وليست أداة قهر، وهو ما تبلور في مرتكزات النظام الديمقراطي بوصفه نظاما إلدارة الصراع يسمح بالتنافس الحر على القيم واألهداف التي يحرص عليها المواطنون.41 أما في القرن العشرين؛ فقد توسعت فكرة المواطنة لتشمل حقوق اإلنسان االقتصادية؛ واالجتماعية؛ والثقافية بعد التطور الذي حصل بإقرار الشرعة
الدولية لحقوق اإلنسان، وأسفر عن تشييد مفهوم "دولة الرعاية".42
وفي هذه الصدد، أمكن تحديد أربعة أبعاد رئيسية للمواطنة تتمتع بدرجة كبيرة من الديناميكية والترابط الوثيق في إطار السياق الراهن للعولمة وما تحمله من متغيرات متنوعة، وهي: 43
القيم . 1 ويتضمن مجموعة الديمقراطي، المجتمع في المواطنين حياة أسلوب إلى يشير الذي للمواطنة المدني البعد التي تشمل حرية التعبير عن الرأي؛ والمساواة أمام القانون؛ وحرية االجتماع؛ وتكوين الجمعيات؛ والوصول إلى بالمواطنين المتعلقة القرارات واتخاذ صنع في الحكومة قدرة على المفروضة القيود إلى باإلضافة المعلومات.
والجماعات والمؤسسات ذات المصالح الخاصة في المجتمع.
بالحق في . 2 الفرد تمتع التي تضمن السياسية والواجبات الحقوق إلى مجموعة يشير الذي للمواطنة السياسي البعد التصويت؛ واالنتخاب؛ والمشاركة السياسية؛ وتقلد المناصب العامة.
البعد االجتماعي االقتصادي للمواطنة الذي يشير إلى مجموعة العالقات التي تربط مابين أفراد المجتمع في سياق . 3اجتماعي معين، وتتطلب ضرورة تمتعهم بالوالء واالنتماء والتضامن االجتماعي، باإلضافة إلى حقوقهم في التمتع الرزق، وكسب المعيشة وسائل من األدنى والحد العمل، في بالحق تمتعهم مثل: االقتصادية، والكفاية بالرفاهية
والعيش في بيئة آمنة.
البعد الثقافي للمواطنة الذي يشير إلى مدى الوعي بالتراث الثقافي المشترك للمجتمع، وكذلك االعتراف بأبعاد التنوع . 4بسبب تظهر التي كافة التمييز أشكال من الفرد وحماية القانونية المساواة مبدأ وتأكيد األقليات، وحقوق الثقافي
عضويته في مجموعة أو فئة معينة في المجتمع .
41ـ روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة نمير مظفر، القاهرة: المؤسسة العربية للنشر، 2005، ص 222-216.
42ـ ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية، ترجمة فاضل جتكر، بغداد: معهد الدراسات االستراتيجية، 2007، ص 143
Hebert, Y., & SEARS, A. )2003( Citizenship education. The Canadian Education Association,43ـ.retrievedfrom Available at http://www.cea-ace.ca/media/en/Citizenship_Education.pdf
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان84 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
أما على صعيد الجهود العلمية النظرية التي بذلت لتحديد طبيعة العالقة بين التعليم والمواطنة والتغير االجتماعي في المجتمع، فقد تمثلت باألساس في مجال نظرية "التربية النقدية"،44 التي تقدم رؤية مختلفة لطبيعة العالقة بين التعليم والمجتمع، إذ تقوم
هذه الرؤية على المرتكزات التالية: 45
التعليم نشاط غير محايد، والمعرفة التي تقدم في المدارس ليست محايدة، وإنما منحازة لفئات اجتماعية على حساب . 1فئات اجتماعية أخرى .
التعليم نشاط سياسي وأخالقي، ويجب النظر إليه في إطار عالقات السلطة وصراع المصالح، كما أن التعليم يفترض . 2التصور وهذه المجتمع والذات اإلنسانية، ويؤثر هذا الحياة والمستقبل، وينطلق من رؤية معينة عن تصورا عن الرؤية مباشرة في تحديد مكانة األفراد في المجتمع، وهذه كلها ذات أبعاد سياسية وأخالقية، كما أن الطبقة الحاكمة
هي التي ترسم للتعليم أهدافه بصورة تتفق مع سياستها ومصالحها.
للتناقض . 3 الفئات االجتماعية السائدة، ولكنه ميدان الكاملة من جانب للسيطرة التعليم نشاط مسيس ال يخضع تماما والصراع، فالمدارس ليست وسائل لمعاودة اإلنتاج االجتماعي والثقافي فحسب، كما أن الفئات االجتماعية المهمشة ال تتلقى الرسائل المعرفية للمدرسة بصورة سلبية دائما؛ بل تقلبها حينا، وتتكيف معها حينا آخر، وتقاومها أحيانا أخرى .
يمكن االستفادة من مناخ التناقض والصراع السائد في المدارس لتغيير الجوانب السلبية ومحاوالت إخضاع الطلبة . 4التجاه سياسي أو ثقافي يعبر عن هيمنة السلطة السائدة. لهذا يمكن استخدام المدارس لتكون ساحة عامة لمناقشة الشأن العام، وتنمية وعي األفراد بحال القهر والالمساواة في المجتمع، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية المدنية، والعمل
بصورة إيجابية لمقاومة القهر، ونشر الحرية، والديمقراطية .
وبمعنى آخر؛ تقوم رؤية نظرية التربية النقدية على ضرورة رفع مستوى وعي الطلبة بالمؤسسات الحالية وتفكيكها ومناقشة أهدافها ودواعيها؛ وذلك من أجل إدراك منظومة عالقات القهر، وإدراك الفرد لمكانه في هذه المنظومة باعتبار ذلك خطوة أولى ثم السعي العملي لتغيير الوضع القائم. لذا يؤكد مفكرو نظرية التربية النقدية على أن التعليم هدف ووسيلة للتغيير في الوقت نفسه لخلق مجتمع جديد. وهنا يبرز التزام المناهج المدرسية في توظيف الوعي والعمل النقديين في إطار مشروع
سياسي للتغيير أو أن تكرس رؤية السلطة القائمة وعالقاتها. 46
ويخلص فريق البحث إلى أن المواطنة من منظور حقوق اإلنسان تمثل مشروعا تربويا للتغيير االقتصادي والسياسي والثقافي الحقوق لممارسة الزمة وسيلة بوصفها والديمقراطية اإلنسان حقوق فهم على أجيال وتنشئة الحديثة، العربية الدولة في والحريات، بحيث يتم من خاللها تغيير عالقات السلطة ومنع إعادة إنتاج األنظمة السلطوية وقيمها لفترة ما بعد الربيع العربي. لذا فإن تبني المناهج الدراسية لمنظور المواطنة يتفق مع المبادئ األساسية للحرية والعدالة والمساواة، كما يشجع الطلبة على أن يصبحوا مواطنين يمتلكون زمام السلطة في المجتمع، وفي الوقت نفسه يمثل تعليم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان عملية إلعداد الطلبة للمشاركة في المجتمع، وتزويدهم بالمعرفة الالزمة للتعامل مع العالم المعاصر المحيط بهم، وهذه أهم
شروط المواطنة الديمقراطية في عالمنا المعاصر.
44 ـ من منظري هذه النظرية: هنري جيرو؛ وميشيل بوتور؛ وروالن بارت؛ وألتوسير؛ وميخائيل باختين؛ ولوسيان غولدمان؛ وصامويل باولز؛ وهيربرت جينتز؛ وأنطونيو جرامشي؛ وباولو فريري؛ ومدرسة فرانكفورت النقدية.
45 ـ كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، الرباط: دار األمان، 2010. سعيد إسماعيل عمرو، في التربية والتحول الديمقراطي، دراسة تحليلية للتربية النقدية عن »هنرى جيرو«، تقديم: حامد عمار، بيروت: الدار المصرية اللبنانية السلسلة: آفاق تربوية متجددة، 2007. عبد العزيز قريش،التفكير النقدي والمدرس،أية ممارسة؟،مجلة علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،المغرب،المجلد:3،العدد:22، آذار/
مارس2002 ،ص.103ـ108.
Rimmington Gibson, et .46ـ وربما تتضح هذه الحقيقة بمقولة غرامشي الشهيرة، من أن كل عالقة هيمنة هي بالضرورة عالقة تربوية.al, Developing Global Awareness 6Bloomfield Hills: Vol. 30, Iss. 1, Jan-Mar 2008 p 17-18
85 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
نتائج الدراسة:
في ما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل مضمون مقررات التربية الوطنية آلخر صف من صفوف لترتيب أسئلة التربية المدنية والوطنية في الدول مجتمع الدراسة: )األردن؛ ومصر؛ ولينان(، إذ ستعرض هذه النتائج تبعا
الدراسة على النحو التالي :47
أمكن إحصاء )685( قيمة بوساطة التحليل الكمي للنصوص المدرسية في مقررات التربية المدنية والوطنية لنهاية المرحلة الثانوية في دول مجتمع الدراسة مرتبطة بقيم المواطنة الواردة في أداة تحليل المضمون. وقد أظهر التحليل أن لبنان يحتل المرتبة األولى من ناحية مجموع قيم المواطنة التي تم رصدها في منهجه المقرر، ويليه األردن، إذ يشكل مجموع كل منهما ما نسبته على التوالي 46.13% و44.67% من المجموع الكلي لقيم المواطنة. أما مصر؛ فقد احتلت المركز األخير في مجموع قيم المواطنة التي ال تزيد نسبة تمثيلها على 9.20% من المجموع الكلي. وفي هذا السياق، يشار إلى أن نتائج المقابالت في الدول مجتمع الدراسة أوضحت بإجماع المستجوبين على أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة حجم المادة المتعلقة بغرس قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، كما أيد هؤالء ربط المواطنة وقيمها المختلفة الواردة في مقررات التربية الوطنية بحقوق اإلنسان الواردة في المواثيق الدولية. وجدير بالذكر أن المستجوبين في كل من لبنان واألردن، أفادوا باحتواء مقررات التربية المدنية والوطنية في الدولتين على دروس تغرس المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، بعكس الحال مع مصر التي أكد المستجيبون فيها على غياب قيم المواطنة
من منظور حقوق اإلنسان عنها.
أظهر التحليل الكمي أن مجموع القيم المرتبطة بالمواطنة في مقررات الدول الثالث يعد ضئيال مقارنة بعدد الفقرات المواطنة من إلى أشارت التي الفقرات نسبته 13.68% من ما المقررات إذ تضمنت هذه اشتملتها، التي الكلي منظور حقوق اإلنسان من المجموع الكلي للفقرات الواردة في هذه المقررات. ومع ذلك يتضح أن لبنان كان في نال لبنان أن أي األردن 17.75% فمصر 12.34%؛ تاله البالغة %69.82 االهتمام في درجة األفضل المركز درجة متوسطة على مقياس درجة األهمية48، بينما نال كل من األردن ومصر درجة منخفظة جدا. أما على الصعيد الكلي؛ فقد كانت درجة االهتمام منخفظة جدا. ولقد أشار تحليل نتائج المقابالت في الدول مجتمع الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أنه لم يتم مراعاة قيم ومبادىء حقوق اإلنسان عند وضع مناهج التربية المدنية والوطنية من وجهة نظر األشخاص الذين جرت مقابلتهم وعبأوا االستمارة، وهؤالء كانوا يرون أن هذه هي إحدى نقاط ضعف مقررات التربية المدنية والوطنية، وكانوا يدعون إلى اعتماد مفاهيم حقوق اإلنسان الوارده في االتفاقيات الدولية التي التزمت
بها دولهم لتكون إطارا عاما عند وضع المناهج الدراسية عموما، ومناهج التربية المدنية والوطنية خصوصا.
توزعت قيم المواطنة التي تم رصدها على الوحدات القيمية الرئيسية، وتبين من التحليل أن قيم الحقوق االجتماعية تحتل المرتبة األولى من ناحية عدد تكراراتها في مقررات التربية المدنية والوطنية في دول مجتمع الدراسة، وذلك في تلتها ثم المواطنة. لقيم الكلي المجموع من %17.81 نسبته ما تشكل قيمة، )122( إلى يصل قيم بمجموع المرتبة الثانية قيم الحقوق الثقافية التي وصل عددها إلى )95( قيمة، تشكل ما نسبته 13.87% من مجموع القيم، يليها قيم الحقوق االقتصادية في المرتبة الثالثة التي بلغ مجموع القيم المرتبة بها )93(، تشكل ما نسبته %13.58 من مجموع القيم. بالمقابل تدرجت بقية القيم في النسب التي حصلت عليها، وكانت أقل قيم المواطنة تكرارا هي
47 ـ رغبة من معهد راؤول والينبرغ لدراسات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في إنتاج دراسات أكاديمية بحدود 15 إلى 30 صفحة تم حذف الجداول المرفقة بكل نقطة، واالكتفاء بالتعليق العام، وما يدلل من األرقام عليها.
48 ـ اعتمدت الدراسة مقياسا لدرجة األهمية حسب النسبة المئوية لقياس مدى تضمن كتب مقررات التربية المدنية والوطنية لقيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، وهي: )80%( فما فوق نسبة عالية جدا؛ و)70%- 79.9%( نسبة عالية؛ و)60%- 69.9%( نسبة متوسطة؛ و)%50.0-
59.9 %( نسبة منخفضة؛ وأقل من )50%( نسبة منخفضة جدا.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان86 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
قيم االنتماء والوحدة الوطنية بنسبة 4.23%.49 وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود إرادة عند واضعي مناهج مقررات التربية الوطنية والمدنية باالبتعاد عن البعد السياسي للمواطنة المرتبط بالحقوق والحريات العامة، مثل: حرية تشكيل األحزاب والجمعيات؛ وحق االنتخاب؛ وحرية الرأي والتعبير وغيرها، واالكتفاء بتلك الحقوق االجتماعية والثقافية والمدنية التي ال تثير الجدل لألنظمة السياسية. وربما تكشف المقابالت التي أجريت عن نتيجة مفادها: وجود مشكالت يعاني منها المجتمع في الدول الثالث، إال أنه لم يتم التطرق إليها، وخصوصا تلك المشكالت المتعلقة بالشق السياسي والعنصرية بالمحسوبية؛ وارتباطها والطائفية األردن؛ في العام المال على والحفاظ السياسي؛ الفساد شاكلة من السياسية في لبنان؛ والتعصب السياسي في مصر )مشكلة ظهرت ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير( السيما وأن الحقوق السياسية كانت نسبتها صفرا في المقرر المصري. وقد أشار تحليل استمارات المقابالت الخاصة بالدولة المصرية إلى أن أحد أهم نقاط ضعف مقررات التربية الوطنية في مصر هو خلوها من اإلشارة إلى الحقوق السياسية في محاولة منها لتجنب تعليم الناشئة، ما قد يؤدي إلى خلق "اضطرابات سياسية" وتكوين "حركات احتجاجبة" على
األوضاع السياسية القائمة في الدولة.
اختلفت درجة االهتمام بغرس قيمة معينة من دولة إلى أخرى حسب الوحدات القيمية الرئيسية. وتشير البيانات إلى غياب االتساق العام في ترتيب القيم بين هذه الدول مجتمع الدراسة، فقد كان ترتيب قيم المواطنة في منهج األردن تنازليا على التتابع التالي: حقوق اجتماعية؛ وحقوق ثقافية؛ وواجبات المواطن؛ وحقوق مدنية؛ وحقوق التضامن؛ وحقوق المساواة؛ وحقوق اقتصادية؛ وحقوق سياسية وقيم أخالقية )الدرجة نفسها(؛ وقيم االنتماء. بينما كان ترتيب قيم المواطنة في مصر على النحو اآلتي: حقوق المساواة؛ وحقوق التضامن؛ وحقوق ثقافية؛ وقيم االنتماء؛ وحقوق اقتصادية؛ وحقوق اجتماعية؛ وواجبات المواطن؛ وحقوق مدنية وقيم أخالقية )الدرجة نفسها(؛ والحقوق السياسية كانت نسبتها صفرا لعدم اإلشارة إليها. أما ترتيب الحقوق في لبنان؛ فكان على النحو اآلتي: الحقوق االقتصادية؛ المواطن؛ نفسها(؛ وواجبات )الدرجة السياسية؛ والحقوق االجتماعية والقيم األخالقية الثقافية؛ والحقوق والحقوق والحقوق المدنية؛ وحقوق التضامن؛ وقيم االنتماء؛ وحقوق المساواة وعدم التمييز. وربما يمكن عزو هذه النتيجة في رأي فريق البحث إلى غياب المصفوفة الوطنية الناظمة لتوزيع أولويات المناهج في الدول الثالث، ومن ثم اختالف توزيع القيم والمفاهيم التي ترغب هذه المناهج في غرسها لدى الطلبة وتشكيل سلوكياتهم. وحقيقة الحال أن نتائج المقابالت لم تفسر هذا المؤشر، واكتفت بالقول إنه عادة ما تتأثر عملية صياغة المقررات الدراسية بواضعي المناهج ورؤيتهم في ظل ظروف وبيئة آنية بعيدة عن الدراسة والتخطيط المستقبلي للمجتمع ومشكالته. ويرى فريق البحث أنه يمكن االستناد إلى العوامل البيئية الموضوعية والذاتية في الدول الثالث لحظة صياغة المقررات التعليمية لتفسير مع مشكلة االنسجام االجتماعي واستيعاب اآلخر في مصر، أو تحديات الوضع متسقا يبدو النتيجة، وهو ما هذه
االقتصادي في لبنان مثال، وهكذا دواليك.
من ناحية توزيع قيم المواطنة على مستوى الوحدات الفرعية، أظهر التحليل أن هناك )8( قيم فرعية مرتبطة بقيم المواطنة قد حازت على تكرارات أكثر من غيرها من الوحدات )106( الواردة في أداة تحليل المضمون.50 وقد التنمية )وهي من في الحق وقيمة االجتماعية( بالحقوق المرتبطة القيم التعليم )وهي من في الحق قيمة أن تبين القيم المرتبطة بحقوق التضامن والتسامح( قد احتلتا المرتبتين: األولى والثانية على التوالي، فقيمة الحق في التعليم تكررت )59( مرة بنسبة 8.61%، بينما تكررت قيمة الحق في التنمية )51( مرة بنسبة 7.45% تلتها قيمة الحق في العمل )من قيم الحقوق االقتصادية( بنسبة 6.13%. وعلى الرغم من أهمية هذه القيم الفرعية، إال أن قيما أخرى لم تنل حظها في التكرار مثل: قيمة منع التمييز على أساس الجنس؛ والحق في الديمقراطية وغيرها من القيم التي لم
49 ـ كان الترتيب التنازلي لها حسب اآلتي: الحقوق االجتماعية؛ والحقوق الثقافية؛ والحقوق االقتصادية؛ وواجبات المواطن؛ وحقوق التضامن والتسامح؛ والحقوق المدنية؛ والحقوق السياسية؛ والقيم األخالقية؛ والحق في المساواة وعدم التمييز؛ وقيم االنتماء والوحدة الوطنية.
50 ـ تتمثل هذه القيم في ما يلي تنازليا: الحق في التعليم؛ والحق في التنمية؛ والحق في العمل؛ والعمل بروح الفريق وممارسة العمل الجماعي والتطوعي،؛ والحق في االنتخاب والترشح؛ والحق في الصحة؛ والدفاع عن الوطن؛ وحرية االتصال والتواصل.
87 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
تحصل على تكرار يوازي أهميتها.51 وهناك قيم فرعية لم تظهر اطالقا في مناهج التربية المدنية والوطنية في دول مجتمع الدراسة مثل قيم: عدم التمييز على أساس: النسب؛ والرأي السياسي؛ والطبقة. باإلضافة إلى قيم: المساواة أمام المرافق العمومية؛ ومنع التعذيب والعقوبات المهينة والقاسية والالإنسانية؛ والحق في تنمية الشخصية؛ ومنع االتجار بالرق أو االستعباد؛ ومنع تشغيل األطفال؛ ومنع عقوبة اإلعدام؛ وعدم رجعية القوانين إن تضمنت عقوبات؛ والحق في التعويض؛ والحق في براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته؛ والحق في سبل إنصاف فعالة عند انتهاك الدولة لهذه الحقوق؛ وحرية االجتماع؛ وحق طلب اللجوء )التماس الملجأ(؛ وحق اإلضراب؛ وحرية اختيار الزوج أو الزوجة؛ وسرية المراسالت؛ وحرية المعتقد؛ وحق الملكية الفكرية؛ وحظر الدعوة للكراهية والتعصب والعنصرية؛ والحق لم( وغيرها. ويعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى عدم وجود مصفوفة وطنية في في رفض الحرب ونبذ العنف )السالدول مجتمع الدراسة تحدد نوع وكم القيم األساسية التي يفترض أن تتضمنها مناهج المقررات الدراسية، فجاءت القيم الفرعية اعتباطية التوزيع: كما؛ ونوعا. لذلك يبرز التناقض أحيانا، فمثال بالرغم من أن التعليم كان في المرتبة األولى، وهو أمر طبيعي نتيجة حث مقررات الطلبة على التعليم، وباألخص في مقرر التربية الوطني األردني، إال أننا نجد أن حرية الفكر والبحث العلمي قد جاءت في ذيل االهتمام بالرغم من االرتباط العضوي بينهما. وكذلك الحال مع قيم أخرى تشير إليها قائمة الحقوق التي تضمنها الملحق رقم )1(. كما أشارت نتائج تحليل المقابالت إلى أن هناك موضوعات حقوقية ذات أهمية خاصة في معالجة مشكالت المجتمع في الدول الثالث، ولكن المقررات التعليمية لم تتطرق إليها. ومن أمثلتها في مصر: حقوق التسامح؛ ونبذ العنف؛ والتعصب السياسي؛ والتمييز الديني؛ والتمييز ضد المرأة؛ وتهميش الهويات الثقافية؛ ومبادىء الشفافية والمحاسبة؛ وحقوق السكن والصحة والحياة الكريمة؛ وقيم أخالقية كفيلة بالقضاء على الالمباالة واالتكالية والسلطوية. وكذلك موضوعات: حقوق الطفل؛ والالجئين؛ والعمالة المهاجرة؛ واألمن اإلنساني؛ والفقر؛ وحرمة المال العام؛ ومبادىء الشفافية والمحاسبة في األردن. أما في لبنان؛ فتمثلت في موضوعات: مفهوم الدولة ودورها؛ والتمييز الطائفي؛ ونبذ العنف؛ والتعصب؛ وقبول اآلخر؛ والطبقية، بالطرق النزاعات وحل المهمشة؛ الفئات ضد والتمييز النزوح؛ وحركات والهجرة والشفافية؛ المساءلة وغياب
السلمية؛ وحقوق األطفال؛ والفقر؛ وحماية البيئة.
وفي ما يتعلق بتوزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية للحق في المساواة وعدم التمييز، أشار التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في األردن، كانت األكثر تضمنا للقيم الفرعية للحق في المساواة وعدم التمييز، تبعه لبنان، ثم مصر في الترتيب. كما يالحظ أن 7 سبع وحدات فرعية وردت اإلشارة إليها من بين 14 أربع عشرة وحدة تضمنها هذا الحق؛ أي بنسبة 50% من مجموع الوحدات الفرعية، بينما كانت نسبة ورود الوحدات الفرعية في كل من مصر ولبنان هي 4 أربع وحدات من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها الحق وبنسبة 28.27% لكل منهما. ويمكن عزو هذا الموضوع، حسب رأي فريق البحث، إلى أن المجتمع األردني ال تتجلى فيه مشكلة التمييز بوصفها مشكلة ملحة كحال المجتمع اللبناني أو المجتمع المصري اللذين لهما مشكالتهما البنيوية في هذا المجال، ولذلك ال يجد حرجا باإلشارة إلى قيم المساواة وعدم التمييز. كما يمكن اإلشارة إلى خالصة نتائج تحليل المقابالت التي أوضحت أن هناك موضوعات حقوقية ذات أهمية خاصة في معالجة مشكالت المجتمع في الدول الثالث، ولكن المقررات التعليمية لم تتطرق إليها، ومن أمثلتها في مصر: حقوق التسامح؛ ونبذ العنف؛ والتعصب السياسي؛ والتمييز الديني؛ والتمييز ضد المرأة؛ وتهميش الهويات الثقافية؛ ومبادىء الشفافية والمحاسبة؛ وحقوق السكن والصحة والحياة الكريمة؛ وقيم أخالقية كفيلة بالقضاء على الالمباالة واالتكالية والسلطوية، ومع ذلك كان تركيز مقرر التربية الوطنية في مصر – بحسب رأي الذين أجريت معهم المقابالت- ينصب على تنمية االعتزاز
51 ـ تتمثل هذه القيم في ما يلي تنازليا: حرية التعبيروالرأي؛ والحق في بيئة سليمة؛ والحق في االنضمام إلى النقابات؛ والحق في األمان الشخصي؛ وحق الحصول على المعلومات؛ وحق الفرد في الحياة؛ والحق في مستوى معيشي مالئم؛ وأداء الخدمة العسكرية؛ وعدم التمييز على أساس الدين؛ والحق في إعالم حر ومستقل ونزيه؛ وحرية التنقل واختيار مقراإلقامة؛ وتقبل االختالف والتنوع اللغوي والديني والعرقي والحضاري والطائفي؛ الوطن؛ وحماية التظلم؛ واالهتمام بمشكالت اللغة؛ والحق في أساس التمييز على العام؛ وعدم الصالح لتحقيق الشخصية الحقوق والتنازل عن إنجازاته واستقراره؛ والحرص على أمن وسكينة المجتمع؛ والحق في المحافظة على الهوية والتراث الثقافي؛ وعدم التمييز على أساس األصل االجتماعي؛ والمشاركة في العملية السياسية؛ والمساواة أمام القانون؛ والمساواة في تكافؤ الفرص؛ وحرية تكوين األحزاب السياسيه؛ والحق في الغذاء السليم؛ وحرية التفكير والبحث العلمي؛ والحق في حرمة الملكية وحمايتها؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ وحق الشعوب في التصرف بمواردها الطبيعية؛ والحق في مسكن الئق؛ وامتثال القيم العلمية من مثل األمانة والموضوعية وحب االكتشاف والمثابرة؛ وعدم التمييز على أساس العرق؛ وحق الشعوب في تقرير خيارها االقتصادي؛ والحق في الضمان االجتماعي؛ وحرية ممارسة الشعائر الدينية وغيرها مما هو وارد في استمارة
التحليل.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان88 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
بالهوية الوطنية؛ والتراث التاريخي؛ وإبراز الخريطة السياسية للوطن ومؤسساته أكثر من االهتمام بالمواطن وحقوقه التعريف المقابالت – على مسألة نتائج - بحسب ينصب االهتمام فإن أما في األردن؛ العامة. وتنمية مشاركته بنظام الحكم وتاريخه ودور القيادة وموقع األردن الجغرافي، بينما هناك حاجة برأيهم إلى أن يكون االهتمام منصبا على التوعية بحقوق المواطن وواجباته؛ وتأهيله للمشاركة السياسية؛ ومعالجة مشكلة الفقر والهجرات والمال العام. بالمقابل؛ فإن جل االهتمام في لبنان ينصب على تعزيز االنتماء للوطن؛ ووحدة أبنائه؛ والتعريف بمؤسسات الدولة؛ ومهماتها؛ ونشاطاتها؛ واحترام قوانينها؛ عالوة على محاربة التعصب الطائفي ونبذ العنف، بينما كانت هناك حاجة إلى التركيز على إكساب الطالب المفاهيم الخاصة بحرية المعتقد والعادات والتقاليد؛ وترسيخ مفهوم الدولة ودورها؛ ومكافحة التمييز الطائفي؛ ونبذ العنف والتعصب؛ وقبول اآلخر؛ والطبقية؛ وتشجيع المساءلة والشفافية؛ ومنع التمييز
ضد الفئات المهمشة؛ وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ وحماية حقوق األطفال؛ ومكافحة الفقر.
أما توزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية للحقوق المدنية؛ فقد أشارت نتائج التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في األردن كانت األكثر تضمنا للقيم الفرعية للحقوق المدنية، تبعه لبنان، ثم مصر في الترتيب. كما يالحظ أن 7 سبع وحدات فرعية وردت اإلشارة إليها من بين 17 سبع عشرة وحدة تضمنتها هذه الحقوق؛ أي بنسبة 41.17% من مجموع الوحدات الفرعية، بينما وردت2 وحدتان فرعيتان في مصر للبنان بنسبة %29.41. الحق، و5 خمس وحدات التي شملها الوحدات الكلي لعدد المجموع بنسبة 11.76% من الدراسة تحدد نوع وكم الدول مجتمع إلى عدم وجود مصفوفة وطنية في النتيجة أيضا البحث هذه ويعزو فريق القيم األساسية التي يفترض أن تتضمنها مناهج المقررات الدراسية، فجاءت القيم الفرعية اعتباطية التوزيع: كما؛ ونوعا. لذلك يبرز غياب قيم أساسية ذات أهمية كتلك المتعلقة بمنع التعذيب؛ والعقوبات المهينة والقاسية والالإنسانية؛ ومنع تشغيل األطفال؛ ومنع االتجار بالرقيق؛ والحق في براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته. وقد الحظ فريق البحث أن نتائج المقابالت في كل من لبنان واألردن، أشارت بوضوح إلى عدم اشتمال المقررات التربوية على الحقوق المدنية بشكل كاف يمكن الطلبة من الوعي بها، وحمايتها من أي اعتداء عليها، لذلك كان هناك تقاطع بين المشكالت التي لم يتم التطرق إليها في هذه المقررات وعالقتها بالحقوق المدنية: احتراما؛ وإعماال. كما يالحظ الفريق البحثي ضعف المنهاج المصري في اطالع الطلبة على الحقوق المدنية بالرغم من أهميتها من ناحية كونها تفرض التزاما إيجابيا على الدولة وفوريا في الوقت نفسه بضمان هذا الحق لمواطنيها. ولقد أشارت نتائج المقابالت التي أجريت مع أصحاب العالقة في مصر بوضوح إلى غياب حقوق اإلنسان عن مقررات التربية المدنية والوطنية، وتركيزها على
تعزيز األنماط السياسية واالجتماعية السائدة في المجتمع.
وحول توزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية للحقوق السياسية؛ فقد أشارت نتائج التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في لبنان كانت األكثر تضمنا للقيم الفرعية للحقوق السياسية، تبعه األردن، بينما لم يتضمن مقرر مصر اإلشارة إلى أية وحدة سياسية. كما يالحظ أنه في لبنان وردت اإلشارة إلى 5 خمس وحدات فرعية من بين 7 سبع وحدات تضمنتها هذه الحقوق؛ أي بنسبة71.43%% من مجموع الوحدات الفرعية، بينما وردت 4 أربع وحدات فرعية في مقرر األردن بنسبة 57.14% من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها الحق. ويعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى اختالف الطبيعة السياسية في الدول مجتمع الدراسة، ووجود تقاليد خاصة للحريات السياسية في المجتمع اللبناني، بالمقابل يبرز حرص القائمين على وضع المناهج المصرية في عهد ما قبل الثورة على تغييب االهتمام بالحقوق السياسية في المقررات الدراسية. كما يالحظ فريق البحث أن قيمتين أساسيتين تغيبان عن المقررات الدراسية في الدول مجتمع الدراسة، وهما: الحق في حرية االجتماع؛ وحق طلب اللجوء. ويبدو أن أسبابا سياسية تقف وراء إغفالهما في الدول الثالث، وجدير بالذكر أن أهم مرتكز لثورات الربيع العربي كان الحق في االجتماع والتظاهر. ولقد أشارت نتائج المقابالت في الدول الثالث إلى غياب االهتمام العام
بتوعية الطلبة بحقوقهم السياسية، وممارستهم لها في إطار تكريس األوضاع السياسية القائمة فيها.
وفي ما يختص بتوزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية للحقوق االقتصادية؛ فقد أشارت نتائج التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في لبنان كانت األكثر تضمنا للقيم الفرعية للحقوق االقتصادية، تبعه األردن ومصر بالعدد نفسه. ويالحظ أن 5 خمس وحدات فرعية من 6 ست وحدات تضمنتها هذه
89 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
الحقوق بنسبة 83.33% ، بينما كان ورود الوحدات الفرعية في كل من األردن ومصر هي 3 ثالث من 6 ست بنسبة 50% لكل منهما. وكذلك يعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى اختالف الطبيعة االقتصادية في الدول مجتمع الدراسة، ووجود تقاليد خاصة للحريات االقتصادية في المجتمع اللبناني، بالمقابل يبرز حرص المناهج المصرية على إيراد حق الشعوب في تقرير خيارها االقتصادي، والتصرف بمواردها االقتصادية كإرث خلفته المرحلة االشتراكية. كما بالرغم من الدراسة الدول مجتمع الدراسية في المقررات أن قيمة حق اإلضراب تغيب عن البحث يالحظ فريق أهميتها لالقتصاديات الحرة. وكشفت المقابالت مع المبحوثين المصريين عن غياب جملة الحقوق االقتصادية عن مقررات التربية الوطينة بالرغم من حاجة المواطنين إليها في معالجة التحديات التي يعيشونها، وأهمها حقوق العمل وشروطه. وكذلك الحال مع نتائج المقابالت التي أجريت في لبنان واألردن، وأشارت بوضوح إلى مشكلتي: الفقر؛
والبطالة، وسوء األوضاع المعيشية، وانعكاسها على الحق في مستوى معيشي مالئم.
أما توزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية للحقوق االجتماعية؛ فقد أشارت نتيجة التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في لبنان واألردن تساوت في عدد الوحدات الفرعية المتضمنه للحقوق االجتماعية، بينما كانت مصر هي األقل تكرارا بعدد وحدات فرعية نسبتها 37.5%؛ أي بواقع تكرار قدره ثالث مرات. ويعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى أن الحقوق االجتماعية ذات طبيعة غير حساسة في الدول مجتمع الدراسة، لذلك كان تكرارها األكثر واألشمل. لكن لوحظ غياب أية قيمة تكرارية للحق في حرية اختيار الزوج أو المبحوثين مع المقابالت السائد. وكشفت االجتماعي الموروث تناقض قد اجتماعية اعتبارت لها من لما الزوجة المصريين عن غياب جملة الحقوق االجتماعية عن مقررات التربية الوطنية بالرغم من حاجة المواطنين إليها في معالجة التحديات التي يعيشونها، وأهمها: حقوق الصحة؛ والسكن؛ والحياة الكريمة. ولقد أشارت نتائج المقابالت في األردن؛ ولبنان؛ ومصر، إلى أن تعرض المقررات الوطنية والمدنية لجملة الحقوق االجتماعية ال يعتريه إشكال تقدم أنها سياسي يعرض األنماط السياسية الموجودة لخطر التغيير، ما يتيح لها المجال للبروز أكثر، وخصوصا
بوصفها إنجازات ألجهزة الدولة، وديمومة شرعية سلطتها السياسية.
الثقافية؛ فقد الفرعية للحقوق الوحدات منظور حقوق اإلنسان على مستوى المواطنة من وعلى صعيد توزيع قيم للقيم الفرعية للحقوق أشارت نتيجة التحليل إلى أن مقرر التربية الوطنية والمدنية في األردن كان األكثر تضمنا الثقافية، تبعه لبنان، ثم مصر. كما يالحظ أنه في األردن وردت اإلشارة إلى 6 ست وحدات فرعية من بين 11 إحدى عشرة وحدة تضمنتها هذه الحقوق؛ أي بنسبة 54.55% من مجموع الوحدات الفرعية، بينما وردت 4 أربع وحدات فرعية في مقرر لبنان بنسبة 36.36% من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها الحق، وكذكك 3 وحدات فرعية في مقرر مصر بنسبة 27.27% من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها الحق. وقد يعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى أن الحقوق الثقافية ذات طبيعة غير حساسة أيضا في الدول مجتمع الدراسة، لذلك كان تكرارها األكثر واألشمل. لكن لوحظ غياب أي قيمة تكرارية للحق في: حرية المعتقد؛ وسرية المراسالت؛ والمناخ الثقافي الحر، كونها تتسبب في إشكاليات اجتماعية؛ وثقافية؛ وسياسية. كما يالحظ حالة الضعف الشديد التي تعاني منها مصر بالرغم من أنها دولة ذات تقاليد ثقافية عريقة، وهو ما يتفق مع نتائج خالصة المقابالت التي أجريت مع المبحوثين المصريين حول إهمال مقرر التربية الوطنية للبحث في العولمة؛ والثقافة اإلنسانية؛ ومنع التهميش الثقافي. كما يستدل من نتائج مقابالت المبحوثين في لبنان أنها تطرقت لضعف حماية حقوق اإلبداع والمبدعين في لبنان والتعريف بهم.
التضامن لحقوق الفرعية الوحدات مستوى على اإلنسان حقوق منظور من المواطنة قيم بتوزيع يتعلق ما وفي والتسامح؛ فقد أشارت نتيجة التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في األردن كانت األكثر تضمنا للقيم اإلشارة األردن وردت في أنه يالحظ كما نفسه. بالعدد لبنان، ومصر تبعه والتسامح، التضامن لحقوق الفرعية إلى 4 أربع وحدات فرعية من بين 8 ثماني وحدات تضمنتها هذه الحقوق؛ أي بنسبة 50% من مجموع الوحدات الفرعية، بينما وردت 2 وحدتان فرعيتان في مقرر لبنان بنسبة 25% من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها الحق. ويعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى أهمية حقوق التضامن والتسامح في حماية وجود الدول مجتمع الدراسة واستقرارها: عالميا؛ وإقليميا؛ ومحليا، ولكن لوحظ غياب أي قيمة تكرارية للحق في رفض الحرب ونبذ العنف، وكذلك لحظرأي دعوة للكراهية والتعصب والعنصرية، بالرغم من التوجهات السياسية العامة لهذه الدول التي تعكسها سياستها الداخلية والخارجية، ما يشير إلى غياب خطة إلدماج حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية، واعتباطية تناول
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان90 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
القيم عند وضع المناهج المقررة باالستناد إلى رؤى القائمين عليها ومعرفتهم. وكشفت نتائج المقابالت مع المبحوثين المصريين واللبنانيين عن غياب جملة حقوق التسامح عن مقررات التربية الوطنية بالرغم من حاجة المواطنين إليها
في معالجة التحديات التي يعيشونها، وأهمها: نبذ العنف؛ والتعصب المذهبي؛ والفكري؛ والسياسي.
وعلى صعيد توزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية لبعد االنتماء والوحدة الوطنية؛ فقد أشارت نتيجة التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في الدول الثالث تساوت في عدد وحدات القيم الفرعية التي تضمنتها أبعاد االنتماء والوحدة الوطنية، إذ تكررت 3 ثالث وحدات فرعية من أصل 8 ثماني وحدات تضمنت هذا البعد، وبنسبة 37.5% من المجموع الكلي لعدد الوحدات التي شملها البعد. ويعزو فريق البحث أساسية لحماية المواطنة وتعزيزها. ولوحظ أن قيم االنتماء والوالء والوحدة الوطنية تمثل درعا النتيجة إلى هذه اهتمام المناهج في الدول الثالث بمشكالت الوطن وحماية أمنه واستقراره في داللة واضحة على وجود مشكلة محيطة الوطنية. المنجزات والحفاظ على الدولة أدوار الوطنية، وتقدير الرموز تقدير لوحظ غياب الموضوع، كما بهذا وكشفت المقابالت مع المبحوثين في الدول الثالث عن نقطة أساسية مفادها؛ أن مقررات التربية الوطنية تهتم بإعالء قيمة الوطن، وتعزيز االنتماء إليه أكثر من اهتمامها بالمواطن وحقوقه في محاولة منها لتكريس األنماط السياسية واالجتماعية واالقتصادية، كما يراها النظام السياسي، بالرغم من الحاجة الماسة إلى تحقيق التوازن بين قيمة المواطن
وحقوقه بالقدرنفسه الذي تعلو فيه قيمة الوطن وحقوقه.
وحول توزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية لبعد القيم األخالقية؛ فقد أشار التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في األردن كانت األكثر تكرارا لعدد هذه الوحدات التي تضمنها العدد واحد من تكرار وبواقع منهما، لكل ولبنان %12.5 كل من مصر نسبة كانت بينما بنسبة %50 البعد هذا الكلي لوحدات القيم الفرعية التي تضمنها هذا البعد، وعددها 8 ثماني وحدات. ويعزو فريق البحث هذه النتيجة إلى الفهم التقليدي للقيم األخالقية، وعدم التوسع فيها لتشمل أبعادا أساسية، مثل: دور الفرد في إدراك حقوقه وواجباته؛ حاجة عن المصريين المبحوثين مع المقابالت وكشفت وغيرها. النزاعات لفض آلية بوصفه الحوار واستخدام مقررات التربية الوطنية المصرية إلى تقدير القيم األخالقية اإلبداعية التي تحث على العمل؛ والتغيير؛ والمبادرة؛ والتطوع وغيرها في مقابل القيم التي تكرسها حاليا من شاكلة الالمباالة واالتكالية واالغتراب. في حين أشارت نتائج المقابالت مع المبحوثين في لبنان إلى افتقاد مقرر التربية الوطنية لقيم المسؤولية؛ والنقد الذاتي؛ واحترام الحوار؛ وتشجيع الطلبة على إبداء آرائهم؛ واحترام اآلراء األخرى، بالمقابل لم يتم التطرق إلى هذه القيم في نتائج مقابالت
المبحوثين من األردنيين.
وفي ما يختص بتوزيع قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان على مستوى الوحدات الفرعية لبعد واجبات المواطن واإلنسان؛ فقد أشارت نتيجة التحليل إلى أن مقررات التربية الوطنية والمدنية في األردن كانت األكثر تكرارا في عدد وحدات القيم الفرعية التي تضمنتها أبعاد واجبات المواطن واإلنسان والوحدة الوطنية، إذ تكررت 8 ثماني وحدات التي الوحدات لعدد الكلي المجموع البعد، وبنسبة 50% من فرعية من أصل 16 ست عشرة وحدة تضمنها هذا شملها البعد. بينما كان لبنان في المرتبة الثانية، ومصر في المرتبة الثالثة، وبنسبة 37.5% و18.75% لكل منهما على التوالي. ويالحظ فريق البحث أن اختالف توزيع هذه القيم من دولة ألخرى يعكس اختالف طبيعة عالقة الفرد بالدولة ورؤية كل من السلطة والفرد لدور اآلخر، مع مالحظة أن قيما أساسية، مثل: دفع الضرائب؛ واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم؛ والحرص على دعائم الديمقراطية وغيرها، تغيب عن هذه المنظومة ألسباب تتعلق برؤية من وضع المقرر الدراسي، وطبيعة فهمه للواجبات األساسية للمواطن، وهو ما أكدته نتائج المقابالت في الدول الثالث.
أما من ناحية أسلوب المناهج في نقل وغرس قيم المواطنة؛ فيمكن القول إن درجة تأكيد القيمة لدى الطلبة تتأثر بحجم أو عدد مرات تكرارها وكذلك بطريقة أو أسلوب عرضها. وعلى ذلك؛ فقد أخضعت نصوص منهج التربية القيم وفقا ألسلوب عرضها، وعلى أساسه تقسيم يعتمد على المضمون تحليل لمستوى آخر من المدنية والوطنية أمكن تقسيم أسلوب العرض إلى طريقتين: األولى، وتعتمد األسلوب الصريح والمباشر؛ والثانية، وتعتمد العرض الضمني أو غير المباشر للقيم. وبناء على ذلك، توزعت القيم إلى نمطين: نمط القيم الصريحة؛ ونمط القيم الضمنية.
91 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
وقد أظهر التحليل أن مجموع القيم التي عرضت ـ بشكل غير صريح ـ كان أكبر من القيم التي عرضت بشكل األردن كل من تقارب الصريحة(. وقد للقيم الضمنية و %14.60 للقيم النسبة هي )%85.40 كانت إذ ضمني، ولبنان في نسبة القيم الضمنية الواردة في منهجيهما بما نسبته 45.47% و46.50% على التوالي. أما القيم الصريحة؛ فكانت نسبتها 40% لألردن و44% للبنان، في حين أن النسبة في مصر كانت 8.03% للقبم الضمنية، و16% للقيم الصريحة. ويالحظ على توزيع قيم المواطنة ـ حسب أسلوب عرضها بين الدول ـ أن االتجاه العام لعرض الوحدات القيمية يتبع طابع االتجاه الضمني، بما يعنيه ذلك من غياب حرص الدول مجتمع الدراسة وواضعي المناهج على إدراج قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان بشكل صريح ومباشر. وأشارت نتائج المقابالت في الدول الثالث إلى جملة من المعوقات التي تضعف عملية تعليم الطلبة لقيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان، وأولها التركيز على البعد النظري التلقيني، وغياب المنهج العلمي الواضح في وضع هذه المقررات، وعدم مناسبة محتويات المقرر مع متغيرات المجتمع والمشكالت التي يواجهها، عالوة على غياب األنشطة التفاعلية الالصفية، كما أشارت إلى ضعف المستويات التعليمية لمعلمي هذه المقررات، وضعف تأهيلهم، واستيعابهم لهذه المنظومة الحقوقية ببعديها االجتماعي والسياسي، وخصوصا في ظل اعتبارها مادة هامشية من جانب الوزارة وإدارة المدرسة، مقارنة بالمواد األخرى، وعدم إعطائها األهمية التي تستحقها. كما أظهر التحليل أن هناك تباينا على مستوى عرض الوحدة القيمية، وإن لم تكن الفروق واضحة جدا، كما اتضح ميلها إلى االتجاه الضمني. وعلى أي حال؛ يدل االتجاه نحو عرض القيم بصورة صريحة على أن مفهوم المواطنة واضح لدى مصمصي المناهج، وأن خلق ثقافة مرتبطة به لدى الناشئة هو مطلب واضح لهم. ولكن البيانات تشير إلى عكس ذلك، ما قد يؤكد افتراض غياب موضوع دور المنهج في اكتساب
قيم المواطنة عن ذهن مصممي تلك المناهج.
وعلى صعيد آخر؛ رصد فريق البحث جملة من الكلمات التي تم استخدامها في مقررات التربية المدنية والوطنية، ويالحظ بأن هذه الكلمات أو المصطلحات مشحونة بقيم عاطفية ذات عالقة عضوية بقيم المواطنة من قبيل مصطلح "الوطن" مقابل مصطلح "المواطن"، وهو ما يؤشر إلى هيمنة الدولة على المواطنين واعتمادهم عليها. كما يالحظ المنهجين: في المفهوم هذا يرد لم بينما المصري، المنهاج في واحدة لمرة سلبي سياق في رعايا لفظ استخدام المنهجين: من أكثر واالنتماء الوالء مصطلحي استخدم األردني المنهج أن يالحظ وكذلك واللبناني، األردني؛ المصري؛ واللبناني، كما تبين أن المنهج المصري كان األقل في استخدام مصطلحات: الوطن؛ والمواطن؛ والمجتمع؛ والديمقراطية بالمقارنة مع المنهجين: األردني؛ واللبناني. وقد أشارت نتائج المقابالت في الدول الثالث إلى وجود عاطفة تعبوية في هذه المقررات لتوجيه الطلبة نحو تبني غاياتها، وتكريس هيمنة الدولة أو السلطة على المواطنين
واعتمادهم عليها.
الفئات األكثر عرضة لالنتهاك )وتشمل: حقوق الوطنية من ناحية تعاملها مع التربية تم رصد مقررات وأخيرا؛ المرأة؛ والطفل؛ وذوي اإلعاقة؛ ونزالء مراكز اإلصالح والتأهيل(. ولم يتمكن فريق البحث من رصد أي ذكر لهذه الفئات أو لحقوقها في مقرر منهج التربية الوطنية في لبنان، ما عدا ذكرا واحدا لعدم التمييز ضد المرأة، وذكرا واحدا لحق الطفل في الحياة. أما المنهج المصري؛ فقد ورد فيه ذكر لحق المرأة في التعليم3 ثالث مرات، وحقها في عدم التمييز على أساس الجنس مرة واحدة فقط. بالمقابل وردت اإلشارة 9 تسع مرات لحقوق المرأة في التعليم؛ والتنمية؛ والعمل؛ واالنتخاب والترشح؛ والعمل التطوعي في مقرر التربية المدنية والوطنية في األردن. كما ذكرت حقوق األطفال 4 أربع مرات في سياق إيراد حقهم في الحياة؛ والصحة؛ والغذاء السليم؛ والتعليم. كما وردت اإلشارة مرة واحدة إلى حق ذوي اإلعاقة في المسكن الالئق. وهذا األمر يدل على ضعف مناهج التربية الوطنية في اإلشارة إلى حقوق األشخاص من الشرائح األكثر عرضة لالنتهاك وكيفية حمايتهم. ويمكن عزو ذلك إلى غياب مصفوفة واضحة للمواطنة من منظور حقوق اإلنسان في الدول الثالث، وهو ما أكدته نتائج المقابالت في الدول الثالث، عدا عن أنه
قد ال ينظر إلى هذه الموضوعات على اعتبار أنها ذات ارتباط عضوي بحقوق المواطنة.
خالصة نتائج التحليل والتوصيات:
تشير النتيجة العامة التي خلصت إليها الدراسة إلى أنه قد حان األوان للقيام بخطوات عملية عديدة نحو إصالح نظام التعليم في الدول مجتمع الدراسة، وبما يجعل هذا النظام مرتكزا إلى قيم المواطنة بمفهومها الحداثي الذي شكل منتهى التجربة اإلنسانية
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان92 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
في القرن الحادي والعشرين، باإلضافة إلى أنه بإمكان كل دولة أن تضيف إلى ذلك ما تراه مناسبا ومفيدا في حالتها الخاصة، من شاكلة مفهوم التعددية الثقافية، وبحيث تستطيع هذه النظم التعليمية إنتاج جيل عربي جديد مستقل ومبدع ومستوعب للقيم االجتماعية التي تزدهر في المجتمعات الديمقراطية، السيما وأن التعليم يعد إحدى وسائل تعديل النسق الثقافي وتغييره ، وأداة المجتمع في صنع مستقبله. كما خلصت الدراسة إلى نتائج خاصة في ضوء إشكاليتها والتساؤالت التي طرحتها والمتعلقة بمدى تضمن مناهج مقررات التربية المدنية والوطنية لقيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في دول مجتمع الدراسة: )األردن؛
ومصر؛ ولبنان(. وقد تبينت جملة من مواطن القصور، أهمها:
باعتبارها . 1 به، تقوم أن يمكن الذي الدور مع تناسبها المقررات، وضعف تضمنتها التي المواطنة قيم ضآلة عدد مناهج، في عملية إكساب القيم للطلبة. كما أن هناك أنماطا من القيم غير مذكورة البتة، وأخرى شبه غائبة على الرغم من أهميتها النسبية للمواطنة سواء على صعيد تكامل قيم المواطنة أو على صعيد ضرورتها في حل مشكالت المجتمع ومراعاة التطورات المستقبلية فيه. ويمكن عزو هذا التوزيع العشوائي وغير المتوازن لقيم المواطنة إلى سعي مقررات التربية الوطنية والمدنية في دول مجتمع الدراسة إلى تكريس أنماط ثقافية قائمة يضعف فيها البعد المبني على حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية، ويغلب عليها فكرة الوالء والطاعة، ما يعني أن التحوالت السياسية التي ترافق الربيع العربي ينبغي أن تترافق مع تحوالت ثقافية تستهدف الميول والعواطف والمواقف، وبما يجعل المدارس أطرافا اجتماعية وسياسية أساسية فاعلة يمكنها أن تؤثر بشدة في عملية التحول الديمقراطي، وال سيما في
مكونها الثقافي.
غياب التوازن في درجة التركيز على قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان سواء بين الدول نفسها أو بين القيم . 2التي تضمنتها المواطنة. ويمكن عزو هذا التباين إلى أن اختيار محتوى المقررات الدراسية ال يتم في ضوء معايير موضوعية محددة بشكل مسبق، وإنما في ضوء المعرفة والخبرة واالهتمام ألعضاء لجان تأليف المناهج. وهنا قد ال تكون منظومة قيم المواطنة موجودة لدى لجان تأليف المناهج بشكل واضح ومتكامل، وإن كانت موجوده فهي ال تشكل بعدا أساسيا في عملية تأليف المنهج، كما يعزى ذلك أيضا إلى غياب مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية أصال. وأشارت نتائج المقابالت إلى هذه النتيجة في الدول الثالث، وطالبت باتساق األهداف المعلنة إحدى اإلنسان حقوق قيم تكون بأن طالبت كما المقررات، هذه محتوى مع والمدنية الوطنية التربية لمقررات
المحددات الرئيسية التي تبنى عليها المناهج الدراسية، إضافة إلى محددات وطنية ودينية أخرى.
عجز القيم وأسلوب عرضها عن مساعدة الطلبة على إدراك المواطنة ودورها في بناء المجتمع والدولة، وهو ما . 3ينسجم مع التوقعات العامة لفريق البحث. إذ أشارت نتائج المقابالت في الدول الثالث بوضوح إلى أن هذه اإلشكالية هي أحد أسباب عدم تمكن المقررات الوطنية من تحقيق هدفها الرئيس في غرس قيم المواطنة، وهي أحد أسباب
ضعف المناهج الوطنية، وعدم شمول مفاهيم المواطنة ووضوحها في سلوك التالميذ اليومي.
تفاوت دول مجتمع الدراسة في استخدام مقررات التربية الوطنية لمصطلحات مشحونة عاطفيا ، وهو ما يؤشر إلى . 4هيمنة الدولة على المواطنين واعتمادهم عليها. كما أوضح التحليل تباين ورود هذه المصطلحات واستخدامها في سياقات مختلفة، عدا عن أن عددا منها لم ترد اإلشارة إليه في بعض الدول. مع التأكيد على أن المصطلح يشكل الوعي، ويسهم في تطوره وضبطه، كما يكشف عن داللته المعرفية والقيمية واألخالقية والسياسية واالجتماعية؛ أي بمعنى آخر يسهم المصطلح في تكريس قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في الوعي والممارسة. وقد أشارت نتائج المقابالت في الدول الثالث إلى ارتباط المواطنة بقيم عاطفية لها عالقة باالنتماء للنظام السياسي والوالء لقيادته
أكثر من عالقتها بإعداد المواطن؛ وتوعيته بحقوقه وواجباته؛ وتفعيل دوره السياسي .
محدودية ورود المصطلحات ذات العالقة بذوي الفئات المهمشة في مقررات التربية المدنية والوطنية، وربما يمكن . 5عزو ذلك إلى أن االهتمام بهذه الشرائح االجتماعية ما يزال محدودا على صعيد المجتمع، وأنه حديث نسبيا لما بعد
مصادقة هذه الدول على االتفاقيات الدولية ذات العالقة.
مادة . 6 يخصص مثال فاألردن الثالثة، األقطار في االجتماعية والوطنية المدنية المقررات مناهج تدريس اختالف مستقلة منذ المرحلة االبتدائية، بينما ال تخصص مصر مادة إال في المرحلة الثانوية فقط.
93 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
توجه المقررات الدراسية محل الدراسة، واستنادا إلى تحليلها، في تناول قيم المواطنة بشكل أساسي نحو المدخل . 7قيم لبعض قليل تناول نفسه الوقت في هناك كان وإن المتنوعة، الدراسية الوحدات في المواطنة لقيم االندماجي المواطنة في موضوعات مستقلة لوحدها. وقد أشارت نتاج المقابالت إلى ضرورة تخصيص مادة منفصلة ومستقلة للتربية المدنية والوطنية مبنية على إطار مرجعي يقوم على مبادىء حقوق اإلنسان ضمن خريطة زمنية تبدأ من
الصفوف األولى في التعليم المدرسي، وذلك على اعتبار أن حقوق اإلنسان تمثل مدخال مناسبا لتعزيز المواطنة.
ميل مقررات التربية الوطنية في الدول مجتمع الدراسة، بقصد أو دون قصد، واستنادا إلى تحليلها ونتائج المقابالت، . 8نحو تكريس األنماط: السياسية؛ واالجتماعية؛ والثقافية القائمة في هذه الدول، كما أنها غيبت الكثير من الموضوعات التي تخاطب احتياجات المجتمع األساسية: )المشاركة العامة؛ والتفكير النقدي في النظر إلى قضايا المجتمع(، عالوة على أن عددا من الموضوعات التي احتوتها لم تعد مصدر توجيه سياسي في ظل المتغيرات العالمية: )الرعايا؛ والقومية؛ والطائفية؛ واالتحادات؛ والدور التاريخي(، كما أدى إغفال مناهج التربية الوطنية والمدنية لحقوق اإلنسان المناهج أو ضعف الحقوق عن بأن تغييب بعض لثقافة حقوق اإلنسان، كما بدا واضحا مناقضة ثقافة إلى شيوع الطفل؛ مثل: لالنتهاك، عرضة األكثر للفئات انتهاكا، وخصوصا األكثر الحقوق جعلها ضمن قد إليها، اإلشارة
والمرأة؛ والمعوقين؛ والعمالة المهاجرة؛ وغيرها.
وفي هذا المجال توصي الدراسة بما يلي:
التأكيد على أهمية البدء في تدريس مقررات التربية المدنية والوطنية في الدول العربية، ومنها دول مجتمع الدراسة . 1منذ الصف األول االبتدائي؛ تحقيقا ألهدافها األساسية في بناء المواطنة والمجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق
اإلنسان.
مراجعة الكتب الدراسية بصورة دورية؛ بهدف تحقيق التوازن في إيراد قيم المواطنة ومعالجتها من منظور حقوق . 2اإلنسان، ومراعاة التدرج والتسلسل في عرضها وبما يتفق مع المستويات التعليمية وأولويات المجتمع، وبما يؤدي إلى السعي المستمر في عرض المواطنة بصورة موضوعية ومحايدة، وباالستناد إلى عالمية مبادئ حقوق اإلنسان
واتفاقياتها الدولية.
زيادة حجم المادة الخاصة بالمواطنة ضمن المقررات الدراسية، والتعامل مع مفاهيم حقوق اإلنسان بشكل صريح . 3مصفوفة شمولية ضمن وبصورة األخرى، دون بحقوق االهتمام وعدم حصر التوازن، أساس وعلى وواضح،
متكاملة.
إشراك المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان والمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني في وضع المناهج التعليمية، بما . 4يؤدي إلى تعزيز المفاهيم اإليجابية من منظور حقوق اإلنسان، ورفدها بأنشطة متنوعة.
تعميم هذه الدراسة على بقية الكتب المدرسية المقررة في جميع المراحل التعليمية وعلى دول عربية أخرى، باإلضافة . 5إلى إجراء دراسات مماثلة تتناول مدى اإللمام بالمواطنة من منظور حقوق اإلنسان على طلبة المدارس؛ والمعلمين؛
واإلدارة المدرسية للنظر في مدى إلمامهم بالمواطنة وممارستها.
دوري . 6 بشكل الدولي للفهم وفقا اإلنسان حقوق بمضامين والوطنية المدنية التربية مناهج واضعي إدراك تطوير ومستمر، وكذلك إتباع وسائل التدريس الحديثة في تعليم مناهج التربية الوطنية.
المهاجرين . 7 والعمال والمعوقين؛ والمرأة؛ الطفل؛ مثل: لالنتهاك، عرضة األكثر الفئات بحقوق االهتمام ضرورة وغيرهم، في مناهج التربية المدنية والوطنية حتى ال يزداد الغبن الواقع على هذه الفئات، ويزداد حجم االنتهاكات
ونوعها التي يتعرضون لها في المجتمع.
ضرورة إدماج حقوق اإلنسان في مناهج التربية المدنية والوطنية من أجل وقف انتشار الثقافات المناقضة لها التي . 8توفر البيئة الخصبة لنمو قيم االستبداد، وعالقات الغلبة، وإعاقة بناء الدولة المدنية الحديثة.
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان94 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
املراجع
أوال: المراجع العربية
الكتب:
إبراهيم ناصر، المواطنة، عمان: دار مكتبة الرائد العلمية، 2002.
الحبيب الجنحاني، المواطنة والحرية، ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية "المواطنة في الوطن العربي"، الرباط: منتدى الفكر العربي، 21-22 نيسان/ أبريل 2008.
نتائجه، تحرير: التغيير االجتماعي، مصادره، نماذجه، للتغيير، في كتاب: الوظيفية النظريات تالكوت بارسونز، اميتالي اتزيوني، ترجمة محمد حسونه )دمشق: وزارة الثقافة، 1984(.
تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي، عمان: المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة، .2005
اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عمان: المعرفة، مجتمع إقامة نحو للعام 2003: العربية اإلنسانية التنمية تقرير
.2003
ديفيد هيلد، نماذج الديمقراطية، ترجمة فاضل جتكر، بغداد: معهد الدراسات االستراتيجية، 2007.
روبرت دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة نمير مظفر، القاهرة: المؤسسة العربية للنشر، 2005.
سعيد إسماعيل عمرو، في التربية والتحول الديمقراطي، دراسة تحليلية للتربية النقدية عن "هنرى جيرو"، تقديم: حامد عمار، بيروت: الدار المصرية اللبنانية السلسلة: آفاق تربوية متجددة، 2007.
علي ليلة وآخرون، التغير االجتماعي والثقافي، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2010.
السياسية، الممارسات األردنية ودالالت التشريعية المنظومة في المواطنة لمبدأ القانونية المقاربات عيدالحسبان، يعقوب ومحمد فضيالت، الواقع" تحرير محمد الحقوقي وإشكاليات المنظور بين "المواطنة الفكرية الندوة وقائع
عمان: المركز الوطني لحقوق اإلنسان، 2011.
لنتون، الحديث، تحرير رالف العالم الثقافة، في كتاب: األنثروبولوجيا وأزمة كاليد كلكهوهن ووليم كلي، مفهوم ترجمة: عبدالملك الناشف )بيروت: المكتبة العصرية، 1967(.
كمال بومنير، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، الرباط: دار األمان، 2010.
محمد الموسى ومحمد علوان، القانون الدولي لحقوق اإلنسان: الحقوق المحمية، عمان: دار الثقافة للنشر، 2006.
محمد فاعور، بطاقة تقييم للتعليم في العالم العربي: البيئة المدرسية ومهارات المواطنة، أوراق كارنيغي، بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، كانون الثاني/ يناير 2012.
كارنيغي، أوراق المستقبل، مفتاح العربي: العالم في المواطنة أجل من التربية المعشر، ومروان فاعور محمد بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، تشرين األول/ أكتوبر 2011.
محمود عقل، القيم السلوكية، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، 2001.
مصطفى قاسم، التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2006.
95 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
الدوريات:
بسام محمد أبو حشيش، دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات غزة، مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( المجلد الرابع عشر، العدد األول، كانون الثاني/ يناير 2010.
دليل لتدريب المهنيين في مجال حقوق اإلنسان، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، العدد 6، جنيف، .1999
زكي رمزي مرتجى و محمود محمد الرنتيسي، تقييم محتوى مناهج التربية المدنية للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي في ضوء قيم المواطنة، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد التاسع عشر، العدد
الثاني، حزيران/ يونيو 2011.
عبدالحميد صبري جاب هللا، تطوير التربية للمواطنة في العالم العربي في ضوء االتجاهات العالمية، مجلة التربية، قطر: العدد152، 2005.
الدار الجديدة، النجاح مطبعة التربية، علوم مجلة ممارسة؟ أية والمدرس، النقدي التفكير قريش، العزيز عبد البيضاء،المغرب،المجلد:3، العدد:22، آذار/ مارس2002.
الوحدة دراسات بيروت: مركز العربي، المستقبل الديمقراطية، الدولة في المواطنة مفهوم الكواري، خليفة علي العربية، العدد 264، 2001.
فارس الوقيان، المواطنة في الكويت: مكوناتها وتحدياتها. وأيضا خضري حمزة، المواطنة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي واإلداري، مجلة علوم إنسانية، السنة السابعة، العدد 45، ربيع 2010.
المواقع اإللكترونية:
اإللكتروني: الرابط عن نقال العربي – 2010، الفكر مؤسسة المواطنة، على التربية قضايا من السيد، محمود http://www.arabthought.org/content
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان96 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
ثانيا: المراجع باللغة اإلنجليزية
Diversity Banks, Group Identity and Citizenship Education in a Global Age. Educational Researcher, Washington: Apr 2008.
Hina Khush Bakht, and others, State of Citizenship Education: A Case Study from Pakistan ,International Journal of Humanities and Social Science, Centre for Promoting Ideas, USA, Vol. ,1 No. 2, 2011
Hebert, Y., & SEARS, A. Citizenship education. The Canadian Education Association)2003(, Available at http://www.cea-ace.ca/media/en/Citizenship_Education.pdf
GRÁINNE Mc Keever, Citizenship and Social Exclusion; The Re-Integration of Political Ex-Prisoners in Northern Ireland . The British Journal of Criminology. London: May. Vol. 47, Iss. 3,2007.
GHK, Study on active Citizenship Education, DG education and Culture, final report submitted, European Commission, 2007
Gary Hopkins, Teaching Citizenship’s Five Themes 1997, Available at http://www.education-world.com/a_curr/curr008.shtml
Patrick John, The Concept of Citizenship in Education for Democracy 1999. Available at http://www.eric.ed.gov
Rimmington Gibson, et al, Developing Global Awareness and Responsible World Citizenship With Global Learning Roeper Review. Bloomfield Hills: Vol. 30, Iss. 1, Jan-Mar 2008.
97 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
امللحق رقم )1(استمارة تحليل مضمون قيم المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في المقررات الدراسية
أوال: الحق في المساواة وعدم التمييز: ) ومن ضمنها جدول خاص بحقوق الفئات المهمشة مثل: األطفال واألقليات والنساء والمعوقين واألقليات(
عدم التمييز على أساس الجنس عدم التمييز على أساس اللون عدم التمييز على أساس الدين عدم التمييز على أساس العرق عدم التمييز على أساس اللغة عدم التمييز على أساس األصل االجتماعي عدم التمييز على أساس النسب عدم التمييز على أساس الرأي السياسي عدم التمييز على أساس الطبقة المساواة أمام القانون المساواة أمام المرافق العمومية المساواة في تكافؤ الفرص المساواة في التمتع بالحقوق )الصحة، التعليم ، اكتساب الجنسية ...الخ( التمييز اإليجابي الهادف إلى تحقيق المساواة )مثل الكوتا للمرأة وغيرها(
ثانيا: الحقوق المدنية: ) ومن ضمنها جدول خاص بحقوق الفئات المهمشة مثل: األطفال واألقليات والنساء والمعوقين واألقليات(
حق الفرد في الحياة )التجارب الطبية، معدالت طول الحياة، حماية المستهلك من المنتوجات الضارة( المرأة والعنف ضد األسري العنف أيضا ويتضمن ( والالإنسانية والقاسية المهينة والعقوبات التعذيب منع
واالتجار بالبشر(الحق في الشخصية القانونية )الحق في التمتع باسم، الحق في التمتع بجنسية( الحق في تنمية الشخصية الحق في األمان الشخصي منع االتجار بالرق أو االستعباد منع تشغيل األطفال منع عقوبة اإلعدام عدم سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي الحق في محاكمة عادلة يكفل فيها حق الدفاع وحقوق األحداث وقواعد قضاء األحداث عدم رجعية القوانين إن تضمنت عقوبات الحق في التظلم الحق في التعويض الحق في براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته حرية التنقل واختيار مقر اإلقامة الحق في حرمة الملكية وحمايتها الحق في سبل إنصاف فعالة عند انتهاك الدولة لهذه الحقوق
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان98 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
والنساء واألقليات األطفال مثل: المهمشة الفئات بحقوق خاص جدول ضمنها ومن ( السياسية: الحقوق ثالثا: والمعوقين واألقليات(
الحق في االنتخاب والترشح حق تقلد المناصب العامة حق المشاركة العامة في اتخاذ القرارات حرية االجتماع حرية تكوين الجمعيات حق طلب اللجوء )التماس الملجأ( حرية تكوين األحزاب السياسيه
والنساء واألقليات األطفال مثل: المهمشة الفئات بحقوق خاص جدول ومن ضمنها ( االقتصادية الحقوق رابعا: والمعوقين واألقليات(
الحق في العمل )ويتضمن أيضا الحقوق العمالية األخرى كاألجر العادل واإلجازات وظروف العمل العادلة وغيرها(
الحق في بيئة سليمة الحق في التنمية حق الشعوب في تقرير الخيار االقتصادي حق الشعوب في التصرف بمواردها الطبيعية حق اإلضراب الحق في االنضمام إلى النقابات
المهمشة مثل: األطفال واألقليات والنساء الفئات الحقوق االجتماعية ) ومن ضمنها جدول خاص بحقوق خامسا: والمعوقين واألقليات(
الحق في مستوى معيشي مالئم وعيش كريم الحق في التعليم الحق في الصحة الحق في تكوين أسرة حرية اختيار الزوج أو الزوجة الحق في الغذاء السليم الحق في مسكن الئق الحق في الضمان االجتماعي
99 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
والنساء واألقليات األطفال مثل: المهمشة الفئات بحقوق خاص جدول ضمنها ومن ( الثقافية الحقوق سادسا: والمعوقين واألقليات(
الحق في إعالم حر ومستقل ونزيه حرية االتصال والتواصل حق الحصول على المعلومات وتداول المعلومات مناخ ثقافي حر سرية المراسالت حق الملكية الفكرية حرية التعبير والرأي حرية المعتقد حرية ممارسة الشعائر الدينية حرية التفكير والبحث العلمي الحق في المحافظة على الهوية والتراث الثقافي
سابعا: حقوق التضامن والتسامح ) ومن ضمنها جدول خاص بحقوق الفئات المهمشة مثل: األطفال واألقليات والنساء والمعوقين واألقليات(
الحق في تقرير المصير السياسي الحق في التنمية لم( الحق في رفض الحرب ونبذ العنف )السواجب تقديم المساعدة لشخص في خطر تقبل االختالف والتنوع اللغوي والديني والعرقي والحضاري والطائفي التعاون الدولي في أثناء الكوارث حظر الدعوة للكراهية والتعصب والعنصرية الحق في الديمقراطية
ثامنا: قيم االنتماء والوحدة الوطنية
االعتزاز باالنتماء: محلي ، وطني، إقليمي، إنساني عالمي الحفاظ على المنجزات الوطنية المخاطرة في سبيل الوطن تقدير الرموز الوطنية التنازل عن الحقوق الشخصية لتحقيق الصالح العام االعتزاز بالهوية الوطنية تقدير أدوار الدولة وتعظيمها االهتمام بمشكالت الوطن، وحماية إنجازاته واستقراره. أخرى
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان100 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
تاسعا: القيم األخالقية
إدراك الحقوق وممارستها والدفاع عنها. العمل بروح الفريق وممارسة العمل الجماعي والتطوعي تضامن أفراد المجتمع في حل المشكالت والتحديات اإلخالص في العمل التفكير النقدي ومهارة التحليل الحوار كآلية لفض النزاعات واالختالفات امتثال القيم العلمية من مثل األمانة والموضوعية وحب االكتشاف والمثابرة. التحلي بالخلق الرفيع. أخرى
عاشرا: واجبات اإلنسان والمواطن
الدفاع عن الوطن الحرص على أمن وسكينة المجتمع التعاون مع مؤسسات تنفيذ القانون والنظام المشاركة في تطبيق نصوص القانون الحفاظ على الممتلكات العامة المشاركة في تكوين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في العملية السياسية أداء الضريبة أداء الخدمة العسكرية فهم الدستور والتشريعات معرفة سمات النظام السياسي معرفة دور البرلمان الواجبات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والبيئة احترام حقوق اآلخرين تحريم اقتضاء الحق بالذات )حل النزاعات وتحصيل الحقوق عن طريق القوة والعنف( الحرص على دعائم الديمقراطية أخرى
101 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
امللحق رقم )2(
أسئلة مقابالت دراسة المواطنة من منظور حقوق اإلنسان في مقررات التربية الوطنية
أوال: يرجى التكرم بتعبئة المعلومات التالية:
الوظيفة : مكان العمل:
الدولة:
ثانيا: يرجى اإلجابة عن االسئلة التالية:
هل اطلعت على مقررات التربية الوطنية في بلدكم؟ )مالحظة: اذا كانت اإلجابة )ال( توقف عن إجراء المقابلة(نعم ال
اذا كانت اإلجابة )نعم(، ما هي أهم ثالثة أهداف لمقرر التربية الوطنية التي يتم تدريسها في دولتكم؟ )رتبها حسب األهمية(
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
هل حققت مقررات التربية الوطنية أهدافها المعلنة في المنهج التعليمي؟ نعم ال
اذا كانت اإلجابة )نعم( او )ال(، رجاء وضح لماذا تعتقد ذلك؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
ما هي أهم ثالث نقاط قوة في مقررات التربية الوطنية في دولتكم من وجهة نظركم؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
ما هي أهم ثالث نقاط ضعف في مقررات التربية الوطنية في دولتكم من وجهة نظركم؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
هل تعتقد أن مقررات التربية الوطنية في دولتكم بحاجة إلى مراجعة؟ نعم ال
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان102 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
اذا كانت اإلجابة )نعم( او )ال(، رجاء وضح لماذا تعتقد ذلك؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
هل تم مراعاة قيم ومبادىء حقوق اإلنسان عند وضع مناهج التربية الوطنية؟نعم ال
هل تؤيد ادخال دروس خاصة بحقوق اإلنسان في مقررات التربية الوطنية في دولتكم؟ نعم ال
اذا كانت اإلجابة )نعم( او )ال(، رجاء وضح أسباب ذلك؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
هل تؤيد ربط المواطنة وقيمها المختلفة الواردة في مقررات التربية الوطنية في دولتكم بحقوق اإلنسان الواردة في المواثيق الدولية؟
نعم ال
ما هي الموضوعات التي ترى أنه مهم للطلبة في دولتكم دراستها في مقررات التربية الوطنية الحالية ولكنها غير مدرجة فيها؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
هل تتضمن مقررات التربية الوطنية الحالية في دولتكم االشارة إلى المشكالت التي يعاني منها المجتمع؟ نعم ال
ما هي المشكالت المهمة للمجتمع في دولتكم وترى ضرورة تضمينها في مقررات التربية الوطنية؟
أ.....................................................................................
ب...................................................................................ج....................................................................................
103 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
برأيك، إلى أي مدى يرتبط نجاح غرس قيم المواطنة في نفوس الناشئة بتدريسها في المقررات الدراسية؟ ولماذا؟
إلى حد كبير جدا ب. إلى حد كبير ج. إلى حد متوسط
إلى حد قليل هـ. إلى حد قليل جدا و. ال ادري
.....................................................................................
برأيك، هل تشكل حقوق اإلنسان مدخال مناسبا لتعزيز المواطنة في المجتمع؟ ولماذا؟
نعم ال .....................................................................................
هل تعتقد أن هناك تعارضا بين حقوق اإلنسان وقيم المواطنة في دولتكم؟ ولماذا؟
نعم ال .....................................................................................
أية مالحظات أو تعليقات أخرى ذات صلة بالدراسة؟
.....................................................................................
انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى
املواطنة من منظور حقوق اإلنسان104 يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
Abstract
Citizenship from the Perspective of Human Rights in the Curricula of National Education in Arab Countries: a case study each from Jordan, Egypt, Lebanon ,.
Research TeamMohammad Yacoub – Head
Saddam Abuazam ManarZuater Najwa Sheikh Researcher Assistants
Samar Tarawneh Maryam Nazal
Raoul Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Lawwithin the Grant program of Research of Human Rights for2012
Amman - June 2012
This study aimed to shed light on the reality of the decisions of civic and national education in a number of Arab countries: Jordan, Egypt and Lebanon; and to measure how much the values of citizenship from the perspective of human rights are contained in curricula , and whether they are able to enhance the democratic process and building new goodgovernancesystems, for the period after Arab spring ;specialywhere the process of education considered one of the means of reproducing the currrent culture or change it through providing values and knowledge designed to enable students to gain experience that qualifies them to carry out the requirements of life and carry out the tasks assigned to them in the community.
The study used content analysis approach which is based on analysis of curriculamthrough virtual qualitative descriptive. The study also interviews with number of stakeholders in the three countries in order to interpret the findings of the research team to analyze the content and indicate their views on elements of strength and weakness of curiiculain the upbringing of the students to the values of citizenship from the perspective of human rights based on their experiences and perceptions related to citizenship.
The results of the study concluded that there is existence of differences between the curriclaof the national and civic education in the three Arab countries in terms of quantity and quality of the values of citizenship from the perspective of human rights and the method of display.on the other hand and As shown by analysis the overall size of the values of citizenship, is very small and not commensurate with the role to be played in the process of the transmission of the values of modernity for students and
105 املواطنة من منظور حقوق اإلنسان يف مناهج الرتبية الوطنية يف األقطار العربية
changing patterns of current social and political cultural, and that there is an urgent need to increase the size of the content aimed at instilling the values of citizenship from the perspective of human rights, particularly for the most vulnerable groups such as children, women, disabled m migrant workers and others.
In light of the above, the research team present number of recommendations which will hopefully contribute to the development of education in national and civil educationfor the students to become able to deal with the requirements of citizenship from the perspective of human rights in a positive and active role as a prerequisite for the success of any process of democratic transition, and so that these educational systems can produce a new independent, creative Arab generation understand social values that thrive in democratic societies.
دراسة حول:
جدلية حقوق اإلنسانيف قانون االنتخاب اللبناين
دينا درويشجورج غالي
د. إيلي الهندي
دراسة أجراها قسم العلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة والجمعية اللبنانية للتربية والتدريب - تحرك من أجل حقوق اإلنسان )alef( بدعم وتمويل من معهد راؤول والينبرغ.
109 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
الئحة احملتويات
110الملخص التنفيذي
112المقدمة
112خلفية تاريخية
113النظام التوافقي اللبناني
114حقوق اإلنسان في الدستور اللبناني
114حسن التمثيل
117الشفافية
117حق الترشح
118حق االقتراع
120الفئات المهمشة: الحصص النسائية "الكوتا"
120الفئات المهمشة: األقليات
121المعايير المتعلقة بالعملية االنتخابية
121معايير ما بعد العملية االنتخابية
122الخالصة والتوصيات
124المالحق
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين110
امللخص التنفيذي
عرف لبنان منذ االستقالل العام 1943 حتى اليوم عشرة قوانين انتخابات؛ أي في ستين عاما تقريبا، ولقد توقفت االنتخابات، بسبب الحرب األهلية، بين األعوام 1972 ـ 1992، ولم يتمكن أي من هذه القوانين من ترسيخ الوحدة الوطنية.1 وها هم اللبنانيون يبحثون اليوم مرة جديدة عن قانون انتخابات جديد يلبي طموحاتهم، ويؤمن صحة التمثيل والسلم األهلي وسط مشهد المنطقة المتفجر. إذ يأمل اللبنانيون أن تأتي انتخابات العام 2013 بجديد يؤمن للمرة األولى وظيفته المفترضة، ويفتح أفقا
رحبا نحو مستقبل أكثر استقرارا وديمقراطية.
لكن األمر ليس بهذه السهولة ، فالمطلوب من قانون االنتخابات الحالي هو أمر شبه مستحيل. إذ يتوقع اللبنانيون من المجلس القانون ولكن الحديثة، الديمقراطيات مصاف إلى بهم يرتقي لألفراد مميزا تمثيال يؤمنا أن نفسيهما واالنتخابات النيابي االنتخابي يفترض به في اآلن نفسه أن يؤمن تمثيل الجماعات المكونة للمجتمع اللبناني )الطوائف( دون سيطرة إحداها على تمثيل األخرى، ودون أن يفصل كليا بينها، بوصفها وحدات سياسية تتشارك عيشا واحدا. كما يفترض بهذا القانون أيضا أن يؤمن تمثيل المناطق، واألقليات، واألحزاب السياسية، ويحترم الخصوصيات والتوازنات. في ضوء ذلك كله، يطرح التساؤل التالي: هل من قانون انتخابات يمكنه أن يؤمن هذا كله؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فماهو البديل؟ هذا ما تحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه عبر مراجعتها لتاريخ قوانين االنتخابات في لبنان، ولألطر الدستورية والميثاقية التي تحدد ما هو المطلوب من القانون الجديد، وتقارنها مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ال سيما المتعلقة منها بالتمثيل الصحيح، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. من خالل هذه المراجعة، وفي ضوء الواقع الحالي للديموغرافيا البشرية والطائفية والتركيبة السياسية الحالية للبنان؛ تستخلص الدراسة أن المطلوب من قانون االنتخاب الجديد هو أمر من المستحيل تحقيقه، إذ ال يمكن ألي قانون ـ كما ستبين الدراسة ـ أن يؤمن المساواة الحقيقية والتامة بين المواطنين وثقل أصواتهم، وبين الطوائف وصحة تمثيلها. أما أحد البدائل الذي يدرس والموجود في الدستور أصال؛ فهو فصل التمثيلين عن بعضهما، وخلق مجلسين: أحدهما لتمثيل األفراد المواطنين بتساو تام؛ واآلخر لتمثيل الطوائف بشكل حقيقي. كما تعرض الدراسة لجميع جوانب قانون االنتخاب المتعلقة بحقوق اإلنسان، ال سيما حق الترشح؛ وحق االقتراع؛ وتمثيل الفئات المهمشة واألقليات، ومدى الشفافية في إدارة االنتخابات قبل
العملية االنتخابية )اليوم االنتخابي( ، وخاللها، وبعدها.
منهجية البحث:
العام 2013، يحتدم أن تجرى في المفترض المقبلة اللبنانية النيابية انتخاب جديد لالنتخابات قانون البحث عن في خضم النقاش حول أية تغييرات يجب أن تحصل على قانون االنتخابات، لكي يضمن حماية حقوق اإلنسان، ويحقق هدفه األساسي، وهو تأمين التمثيل الصحيح، ومشاركة جميع األفرقاء في اإلدارة السياسية للبالد. وعليه؛ برزت الحاجة إلى دراسة تبحث عن مجموعة المبادئ التي تؤمن المشاركة الفاعلة، ومقارنتها مع ما هو متوافر في لبنان، وما هو مطروح في اقتراحات القوانين االنتخابية للبحث في ما يؤمن التوازن بين ضمان حقوق اإلنسان وتمثيل األفراد بشكل مالئم وعادل، وفي الوقت نفسه تأمين
حقوق الجماعات المكونة للمجتمع اللبناني وتمثيلها بشكل مالئم وعادل أيضا.
ولتحقيق هدف هذه الدراسة؛ وهو إضافة بعد حقوق اإلنسان إلى النقاش الدائر، كان ال بد من القيام باإلجراءات التالية: أوال، مقارنة ثانيا، االنتخابية. العملية ومراحل أبعاد جميع في اإلنسان حقوق بضمان المتعلقة العالمية والقيم المبادئ مراجعة يضمن الئقا انتخابيا نظاما تعتمد أخرى شبيهة بمجتمعات تنوعه يناسب الذي االنتخابات وقانون اللبناني المجتمع تركيبة في المقترحة االنتخابية القوانين لجميع مشاريع مقارنة وثالثا، مراجعة والجماعات على حد سواء. لألفراد التمثيل صحة ضوء المبادئ الدولية والممارسات الفضلى. وعليه؛ ينقسم الموضوع على أبرز المحاور التي تطرح إشكالية حقوق اإلنسان في قانون االنتخابات، وتداخلها مع المعطيات السياسية؛ والطائفية؛ وتركيبة النظام اللبناني. وستحاول هذه الدراسة التركيز على الموضوعات األساسية التي لم يتم حسم الجدل حولها أو التي لم تطرح بجدية أصال، محاولة تفادي تكرار المعايير التي أصبحت مقبولة عموما، وتضمنها معظم اقتراحات القوانين. وستتضمن خالصة الدراسة عددا من التوصيات الخاصة بدور
1 محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2002،ص 385.
111 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
المناصرة الذي يجب أن تقوم به جمعيات حقوق اإلنسان في إطار البحث عن قانون انتخابي جديد سيتم اعتماده، ودعوة إلى جميع األطراف اللبنانية لتأخذ باالعتبار هذه التوصيات، لعله يتم إجراء انتخابات نيابية تراعي حقوق الجميع، واألهم من ذلك
تراعي طبيعة المجتمع اللبناني.
فريق العمل
تألف فريق العمل لهذه الدراسة من:
ـ الدكتور إيلي الهندي )منسقا( رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة، والمشرف على برنامج حقوق اإلنسان في الجامعة.
UNHCR ـ دينا درويش، الطالبة في برنامج ماجستير حقوق اإلنسان، ومنسقة الميدان في الهيئة العليا لالجئينفي لبنان.
alef –act for human rights ـ جورج غالي، منسق مشروع في الجمعية اللبنانية للتربية والتدريبalef وساهم في األبحاث الخلفية للمشروع كل من: جيسيكا حالق من جامعة سيدة اللويزة؛ ودونا الهندي من
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين112
املقدمة
يقول العالم الفرنسي ريمون آرون إن القوانين االنتخابية هي االبن والوريث الشرعي للنظام السياسي. والقوانين االنتخابية هي الطريقة المثلى في نقل صورة أي نظام سياسي موجود2. من هنا نرى الترابط المتين واألساسي بين النظامين: االنتخابي؛ والسياسي، الذي يظهر من خالل مبادئ عدة محورية في تأسيس أي نظام ديموقراطي. والنظام االنتخابي هو انعكاس مهم لمحاسن النظام السياسي ومساوئه من خالل احترامه الحقوق والحريات وكفالته لها، سواء أكانت فردية أم جماعية. من هنا يمكن مالحظة مدى تقدم النظام السياسي أو تخلفه من خالل المبادئ والقيم التي يقوم عليها النظام االنتخابي.3 باإلضافة إلى للحكم4، وهو من أفضل األنظمة وأكثرها ديموقراطية، إذ يقوم هذا ذلك، اختار لبنان الديموقراطية البرلمانية لتكون نظاما النظام السياسي بإعادة الديناميكية للعمل السياسي5 . ولكن هناك شروط عدة لنجاح الحياة الديمقراطية قد ال تكون متوافرة تلقائيا. ومن أهمها قانون انتخابي يضمن صحة تمثيل جميع شرائح المجتمع في البرلمان الذي هو مصدر كل تشريع وأساس أساسيا شرعية كل سلطة. وتكتسب العملية االنتخابية وترابطها مع النظام السياسي أهميتها من كون االقتراع العام شرطا للديموقراطية، والقاعدة المطلوبة لتحقيق المساواة السياسية بين المواطنين. ومن شأن حدوث خلل في النظام االنتخابي، ومن ثم النظام السياسي الناتج عنه، أن يجعل الحياة الديمقراطية شبه مشلولة ال بل يجعلها عرضة لإلضرابات، إذ يسعى األفرقاء غير الراضين عن تمثيلهم البرلماني إلى التعبير عن آرائهم بوسائل أخرى خارج البرلمان. وهذا ما كان أحد األسباب والعوامل
التي مهدت الطريق الندالع الحرب األهلية اللبنانية.
األفراد بين الترابط تشديد إلى المجتمع وتسعى تمثيل لتأمين صحة التي توضع االنتخابية، القوانين لبنان في لقد عجزت واإلدارات والمؤسسات العامة، عن إنجاز هذا الدور؛ بل كانت أداة للتجزئة، وتعزيز االنقسامات، وخدمة المصالح الشخصية واالنتخابية لمن هم في السلطة. إذ عمدت القوانين االنتخابية السبعة إلى رسم الخريطة السياسية للبالد التي تساعد الزعماء على تحقيق سياساتهم بعيدا عن تطلعات المواطنين وصحة تمثيلهم. لقد عبر البطريرك الماروني السابق مار نصرهللا بطرس صفير عن ذلك بقوله: "هناك قانون انتخابي لكل دورة، وتقسيم جديد يقصي المناوىء، ويسهل على المرغوب فيهم سبيل النجاح".6 النيابي "الجري المجلس إلى تأمين وصول فئات محددة دون غيرها المقاعد بهدف الدوائر وتوزيع بتقسيم التالعب وكان مندرينغGerrymandering "هذا أدى إلى تشويه التمثيل الشعبي، وسيطرة الجهات المدعومة إقليميا، وإضعاف العملية الديموقراطية السليمة، وهذا ما انعكس على النظام السياسي اللبناني في صورة أزمات متتالية، وعدم تجديد للنخب السياسية.
خلفية تاريخية:
منذ بداية االنتخابات حتى اليوم لم يضع لبنان قانونا انتخابيا ثابتا يكون صورة للنظام اللبناني ويؤمن صحة التمثيل. فقانون االنتخابات للعام 1943 جاء نتيجة حل مجلس النواب من قبل سلطات االنتداب الفرنسي، وقد وفر هذا القانون فسحة للتدخل والتالعب من جانب سلطة االنتداب7. وفي العام 1947 استخدم بشارة الخوري مجددا هذا القانون، ما أدى الى توتر الوضع السياسي في لبنان، إذ اتهم معارضو الخوري هذا األخير بالتالعب في قانون االنتخابات من أجل الحصول على أكثرية نيابية تخوله التجديد لوالية رئاسية جديدة العام 1949. هذه االتهامات أجبرت الخوري على التنحي من سلطة الرئاسة في العام 1952. وجاء قانون 1952 عقب انقالب أيلول األبيض بقيادة كميل شمعون، وكمال جنبالط ، فقد أمن من خالله كميل شمعون
2 محمدالمجذوب، القانون الدستو ري والنظام السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2002،ص 385
3 المصدر السابق نفسه،ص 386.
4 كما تنص الفقرة )ج( من مقدمة الدستوراللبناني »لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية...«
.Giovanni Allegretti, Participer, mais comment, Le Monde Diplomatique, Septembre 2012 5
6 البطريرك مار نصرهللا بطرس صفير خالل افتتاح مجلس البطاركة و المطارنة الكاثوليك في لبنان،جريدة النهار، 11 كانون األول/ديسمبر .2001
7 بشارة الخوري ، حقائق لبنانية. أوراق لبنانية، لبنان، 1960
113 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
أكثرية نيابية توصله للرئاسة في ظل مجلس نيابي يفتقر إلى الشخصيات المعارضة األساسية. وأدى هذا الغياب إلى تدهور دور المجلس النيابي، وأصبحت عملية المحاسبة تجري خارج قبة البرلمان، ما أدى الندالع أحداث العام 19588. في ظل هذه األحداث وتحت وطأة ثورة 1958 وتجليا لصيغة الـ "ال غالب و ال مغلوب" عمد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1960 إلى وضع قانون انتخابات يؤمن توازنا سياسيا معينا، ويضمن تمثيل األفرقاء كافة. واكب هذا القانون الدورات االنتخابية في األعوام: 1960 – 1964 – 1968 – 1972. وبالرغم من أنه قد أمن نوعا من االستقرار للبنانيين، إال أنه لم يمكنهم من تفادي الحرب األهلية. وبقي مجلس 1972 مستمرا بالتجديد خالل الحرب لتعذر إجراء انتخابات حتى العام 1989. وكان هو المجلس الذي أقر اتفاق الطائف. واعتبر اتفاق الطائف القانون االنتخابي أحد األمور األساسية التي يجب إجراء تعديالت عليها، فأقر تعديالت عدة، من بينها زيادة عدد المقاعد اإلسالمية من 45 الى 54 مقعدا لتتساوى مع عدد النواب المسيحيين، ويصبح المجموع 108مقاعد مناصفة، كما حدد الطائف كيفية توزيع المقاعد ضمن كل نصف )نسبيا بين الطوائف، وثم نسبيا على المناطق(. واشترط الطائف أيضا أن تكون الدوائر االنتخابية متساوية مع المحافظات، بعد إعادة النظر بالتقسيم اإلداري )وهذا ما لم يحصل بعد حتى العام 2012(. لكن التالعب بقانون االنتخابات سرعان ما بدا وكأنه أحد الوسائل األساسية التي مكنت سلطة الوصاية السورية من السيطرة على الحكم. إذ نص الطائف على ملء المقاعد النيابية الشاغرة بموت النواب )خالل األعوام من 1972 إلى 1989( وملء المقاعد التسعة المستحدثة بالتعيين لمرة واحدة استثنائية إلتمام نصاب المجلس النيابي الذي بدوره سيقر قانون االنتخابات الجديد للعام 1992. وكان التالعب بقانون 1992 واضحا، إذ زاد عدد النواب إلى 128 بشكل مناقض للطائف، وتم توزيع المقاعد والنواب بما يتناسب مع مصلحة النظام الجديد، الذي كان يتحلى بصبغة أمنية، ويخضع لوصاية النظام السوري، وتتالت بعد ذلك ثالثة قوانين انتخابية مختلفة لثالث دورات هي: 1992 و1996 و2000 تساوت بالسوء والتالعب حتى إن قانون العام 1996 جرى الطعن به أمام المجلس الدستوري من جانب بعض النواب المعارضين، ولكن سارع مجلس النواب باالجتماع "غفلتا" وتبنى القانون المطعون فيه تحت شعار "لمرة واحدة، وبصورة استثنائية".9 كما تقدم الخاسرون في هذه االنتخابات بطعون )ما مجموعه 17 طعنا( أمام المجلس الدستوري، قبل منها 4 أسفرت عن إبطال نيابة 4 نواب. أما قانون العام 2000 فكان األسوأ على جميع األصعدة، إن من جهة تشكيل اللوائح إلى تقسيم الدوائر إلى مراقبة االنتخابات. وعلق الرئيس سليم الحص )الذي من المفترض أن يكون مجلسه قد أعد القانون(10 قائال: "هناك مرض في محافظات جبل لبنان وبدل من أن يحاصر المرض عمم على جميع المحافظات، وبدل أن تحاصر حساسيات الجبل عممت هذه الحساسيات على كل لبنان، و بدل أن نوحد الجبل قسمنا المحافظات".11 وقد عارض مجلس المطارنة الموارنة هذا القانون ووصفوا النتائج "الشبه معروفة مسبقا" بأنها نتيجة الفساد، المال السياسي والترغيب والترهيب12. كما أكدت "الشركة الدولية للمعلومات" أن الفساد في لبنان هو نتيجة فساد الطبقة السياسية التي تجلت في نتائج االنتخابات، وقدرت الشبكة النفقات
غير الحكومية خالل العملية االنتخابية ما بين 160 إلى 240 مليون دوالر13.
النظام التوافقي اللبناني
مما يزيد تعقيد األمور في لبنان هو كون النظام البرلماني اللبناني نظاما مركبا ال يتبع الديمقراطية البسيطة؛ بل ديمقرطية توافقية مركبة تسعى لتمثيل األفراد بشكل صحيح، ولكنها تسعى أيضا إلى تمثيل مواز للجماعات المكونة للمجتمع اللبناني. وهذه االزدواجية التمثيلية اتبعتها معظم الدول التعددية؛ بهدف الموازنة بين احترام حقوق األفراد وحقوق الجماعات. إال أن لبنان دمج بين هذين المستويين التمثيليين في مجلس واحد، بينما فصلتها معظم الدول في مجلسين. وأدى هذا االختالط إلى خلل في التوازن، وجعل مهمة النظام االنتخابي الذي يفترض به تعزيز جوهر النظام اللبناني التوافقي وتأمين االزدواجية االنتخابية، مهمة شبه مستحيلة. فالنظام البرلماني اللبناني أضحى، بحد ذاته، ضحية التركيبة الديموغرافية اللبنانية، إذ يتشكل
8 فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث،Pluto Press,2007,ص 132
9 محمد المجذوب، القانون الدستوري و النظام السياسي،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2002،ص 399
10 جريدة السفير، 31 آب/أغسطس 2000.
11 غسان مطر،جريدة اللواء، 17 كانون الثاني/يناير 1999.
12 جريدة النهار،21 أيلول/سبتمبر 2000.
13 نشر التقرير في جريدة النهار،23 كانون الثاني/يناير 2001.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين114
المجتمع اللبناني من ثماني عشرة طائفة ال تشكل أي منها أكثرية تسعى كلها للحفاظ على خصوصياتها، وإدارة شؤونها الذاتية، ومشاركتها بالقرار السياسي الوطني.14ويضمن النظام اللبناني التوازن بين هذه الجماعات الدينية من خالل تحديد مقاعد نيابية ومراكز في السلطة لكل منها. وينص الدستور )بعد الطائف( على توزيع المقاعد النيابية، على أن يتم إلغاء الطائفية السياسية15 على الشكل التالي: بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، نسبيا بين طوائف كل من الفئتين، نسبيا بين المناطق16. ولكن أعطى
الدستور حرية المراوغة للجماعات السياسية، وهذا بغياب قانون انتخابات ثابت.
حقوق اإلنسان في الدستور اللبناني:
نصت مقدمة الدستور اللبناني في الفقرة )ب( على التزام لبنان باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واعتبرت أنه من واجب الدولة تجسيد مبادئه في كل المجاالت دون استثناء17. لذا؛ فإن المشاركة في إدارة شؤون البالد تعد، بحد ذاتها، حقا أساسيا من حقوق اإلنسان.18 ويؤكد األمين العام لألمم المتحدة األسبق بطرس بطرس غالي أن "االنتخابات هي خطوة أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة الفرد في حكم بلده على النحو المعلن في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق االنسان"19. وعليه؛ تصبح العملية االنتخابية، بمعانيها ومعاييرها الديموقراطية، خطوة ال غنى عنها لتجسيد حق المشاركة في الحكم، وشرطا أساسيا لحقوق اإلنسان. كذلك نص الدستور على حقوق وحريات أخرى هي بدورها أساسية في تأمين المشاركة، وهي: حرية الرأي والتعبير؛ وتكوين الجمعيات؛ والحق في التجمع السلمي ؛
باإلضافة إلى الحق في تولي الوظائف العامة20.
باإلضافة إلى ما سبق، تظهر للباحث مبادئ وعوامل أساسية عدة لحسن تأمين هذه المشاركة مثل: عدم التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيرها من أشكال التمييز، وفي عدم التعرض للتخويف والتهديد. وانطالقا من أهمية ترابط الحقوق كافة وتمحورها في فلك االنتخابات، فقد أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن اشتراك كل فرد في حكم بلده "عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة التنوع من حقوق اإلنسان والحريات األساسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية."21
حسن التمثيل
لعل اإلشكالية األكثر تداوال هي تلك المتعلقة باعتماد النظام االنتخابي والدوائر التي تؤمن أفضل تمثيل. ولكن العقدة ـ كما
Al Hindy E. 2009, Self Determination for minorities: An Arab Perspective, unpublished PhD Thesis, 14 University of Sydney, p. 166
15 المعني بهذا المصطلح هو النظام الديموقراطي التوافقي الذي يخصص مقاعد ووظائف معينة لكل من الطوائف األساسية، كما يوزع كل نظام توافقي هذه على المكونات األساسية، سواء أكانت قومية )سويسرا( أم عرقية )بلجيكا( أم لغوية )كندا(.
16 الدستور اللبناني، المادة 24: » يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفق قوانين االنتخاب المرعية اإلجراء.وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد اآلتية:
أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج – نسبيا بين المناطق.وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تمأل بالتعيين دفعة واحدة، وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون االنتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون
االنتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
17 الدستور اللبناني، المقدمة، الفقرة )ب(. لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم بمواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع
الحقوق والمجاالت دون استثناء.«
18 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 21 )1(.
19 تقرير األمين العام،A/609/46،وCorr.1،الفقرة 76.
20 الدستور اللبناني المواد: 8،12،13
21 قرار الجمعية العامة 137/46 المؤرخ في 17 كانون األول/ديسمبر 1991،الفقرة 3.
115 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
سبق وذكر ـ هي أن صحة التمثيل في مجتمع متعدد، مثل لبنان، ال تعني تمثيل األفراد واألحزاب فقط؛ بل أيضا الجماعات المكونة للمجتمع اللبناني؛ أي الطوائف التي تشكل هوية وسطية لمعظم اللبنانيين بين الهوية الفردية والهوية الوطنية. هذه الطوائف هي شريكة في النسيج السياسي اللبناني بحسب الدستور والميثاق. لذا؛ فإن على قانون االنتخاب أن يعكس هذا الواقع بشكل صحيح. إال أن النظام اللبناني أضحى أسير الواقع الديموغرافي الذي تغير على مر السنين، بينما بقيت النسبة االنتخابية جامدة بين األعوام 1926 و1989. وكان هذا الجمود سببا من أسباب الحرب األهلية، وتعديله أتى بوصفه أحد أبرز نتائجها. واليوم وبالرغم من هذا التعديل فما زالت النسب المحددة بالدستور ال تعكس الواقع الديموغرافي، إذ يحدد الدستور مناصفة اللبنانيون المسلمين22. وبينما يصر لصالح تقريبا لـ %60 الواقع%40 النسبة في تبلغ المسيحيين والمسلمين، في حين بين على المناصفة، تبرز معضلة مزدوجة، وهي تأمين حسن التمثيل في هذه المقاعد المحددة سلفا )إي أن تمثل المقاعد المحددة للمسيحيين حقيقة الواقع، والرأي العام المسيحي، ومثله للمسلمين( وتأمين العدالة بين المواطنين األفراد في المقابل )إذ ال يجوز
أن تكون قيمة صوت مواطن معين أكبر من قيمة صوت مواطن آخر(.
ويرتكز حسن التمثيل، في الواقع، على عوامل عدة، أهمها: النظام االنتخابي المعتمد؛ والدوائر االنتخابية المعتمدة؛ وأيضا تساوي وتأمين االنتخابية؛ الحملة الضغوط؛ وحرية عن بعيدا اللوائح وتشكيل الترشح؛ حق احترام مثل: أخرى، عوامل
الفرص بين المرشحين.
نبدأ بالنظام االنتخابي، ال تنص المعايير الدولية على وجود نظام انتخابي موحد هو األفضل ويجب تطبيقه في جميع الدول؛ بل تؤكد أن اختيار النظام االنتخابي يعتمد على عوامل عديدة، مثل: العوامل التاريخية؛ والسياسية؛ والثقافية؛ والدينية الخاصة بكل دولة شرط أن ينتج النظام المتبع مجلس نواب يمثل جميع األطراف دون استثناء، ويؤمن مساواة المواطنين أمام القانون. فاالنتخابات النيابية الديمقراطية تقتضي وجود نظام انتخابي يعكس رغبة الناخبين من خالل حصولهم على من يمثلهم في النظام األكثري أن من االثنين.23 والمتعارف عليه علميا أن يكون نسبيا، أو أكثريا، أو مزيجا يمكن النظام البرلمان. هذا يعطي أفضل النتائج إذا جاء مع أصغر دائرة ممكنة )الدائرة الفردية( كما هو معتمد في العديد من الدول، مثل: بريطانيا؛ وأستراليا؛ وفرنسا، بينما يعطي النظام النسبي أفضل النتائج كلما كبرت الدائرة وصغرت عتبة الوصول إلى البرلمان. وبالنظر إلى الممارسات الفضلى في المجتمعات المتعددة، يمكن أن نرى بلجيكا مثاال، هذا البلد الذي يتميز بالتنوع لوجود مجموعات مختلفة تحتاج إلى ممثلين عنها. فبلجيكا اختارت التمثيل النسبي لنظامها االنتخابي مع حد أدنى هو 5% لكل مجموعة. من خالل هذا النظام، ضمنت بلجيكا حق المشاركة للجميع دون تمييز.24 كما يشمل النظام النسبي طرق عدة لتطبيقه، لكل منها مفاعيل أساسية على نتائج التحالفات واالنتخابات: اللوائح المقفلة؛ واللوائح المفتوحة؛ والصوت التفضيلي؛ وترتيب األسماء في الالئحة. أما لبنان؛ فلم يعتمد حتى اليوم في كل القوانين االنتخابية السابقة سوى النظام األكثري مع دوائر متوسطة أو كبيرة، وهذا بحد ذاته مخالف لصحة التمثيل والمنطق العلمي. واليوم هناك جدل بين مختلف األفرقاء على النظام الذي يجب اعتماده. إذ يدعو مشروع وزارة الداخلية الذي اقترحه الوزير مروان شربل )2011( إلى اعتماد مبدأ التمثيل النسبي مع اللوائح المفتوحة المكتملة خالل االنتخابات. هذا التقسيم، باعتقاد شربل، يمكن أن يضمن مقاعد انتخابية لجميع اللوائح، وليس فقط اللوائح التي تحصل على 51% من مجموع التصويت على غرار القانون الحالي الذي يعتمد على التمثيل األكثري، بحيث يحصل الرابح على كل المقاعد المخصصة.25 أما مشروع لجنة بطرس؛ فهو يدعو إلى نظام انتخابي مزدوج يعتمد النظام النسبي بالمساواة مع النظام األكثري، بحيث أنه يتم اختيار 77 نائبا من خالل النظام األكثري و51 نائبا من خالل النظام النسبي. ويرى مناهضو النظام األكثري أنه يهمش نسبة كبيرة من المجتمع اللبناني من غير القادرين على تشكيل أكثرية في أية دائرة، كما يأخذ هذا الخلل مفهوما خطيرا إذا ما ربط مع تمثيل الطوائف بشكل صحيح. كما يستبعد أي قانون بدوائر فردية
22 بغياب أي إحصاء شامل رسمي في لبنان منذ العام 1932 تبقى النسب مبنية على التقديرات والتمنيات، أما نسبة 40 و60 في المائة، فهي مدورة مبنية على أرقام الناخبين في لوائح الشطب )القوائم االنتخابية( كما كانت في انتخابات 2009 ، وهي بالتالي األقرب إلى الواقع الحالي ولكنها
تستثني من هم غير المسجلين ومن هم دون 21 )سن االقتراع(.
23 القيم وااللتزامات العالمية المتعلقة بالحق في انتخابات ديمقراطية: دليل عملي لديموقراطية االنتخابات – أفضل الممارسات، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2002، ص 8.
24 مملكة بلجيكا – االنتخابات االتحادية، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ،2007، ص 4.
25 وزارة الداخلية اللبنانية، مشروع قانون االنتخابات النيابية للعام 2013 ، الجمهورية اللبنانية، 2012 ،ص 43.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين116
لكثرة تداخل الطوائف في القرى واألحياء، ما يزيد سوء تمثيل الطوائف. أما مناهضو النظام النسبي؛ فيرون أنه يحسن من تمثيل األفراد على حساب تمثيل الطوائف، كما أنه سيجعل من تشكيل اللوائح مشكلة معقدة، فلكل طريقة تطبيق مشكالتها. كما ستزيد النسبية من تفكك النظام اللبناني، وعدم القدرة على تشكيل نظام/حكومات متماسكة ولو لفترة زمنية. وعليه؛ فإن مقاربة حقوق اإلنسان ال تفضل نظاما على آخر، بل تعتبر أن اعتماد أي نظام انتخابي يجب أن يؤمن حق المشاركة لجميع السكان. لذلك يجب اعتماد تقسيم دوائر منطقي يقترب من الحل األنسب )فردية أكثرية أو كبرى نسبية( ونظام يضمن حصول الجميع
على تمثيل من خالل المقاعد النيابية ولو بنسبة متفاوتة.
وفي ما يختص بتقسيم الدوائر االنتخابية؛ فإن له تأثيرا كبيرا في تشكيل الهيئة الناخبة، ومن ثم في نتائج االنتخابات بأكملها. وبالنظر إلى معظم الدول نرى أن النظام االنتخابي األكثري غالبا ما يترافق مع دوائر صغيرة مع أفضلية للدوائر الفردية، بينما يترافق عادة النظام النسبي مع دوائر كبيرة تؤمن لألحزاب الصغيرة جمع أصوات ناخبيها، ومن ثم تأمين حسن تمثيلها. واعتمد لبنان حتى اآلن أحجاما عدة للدوائر، إذ كانت تتفاوت )حتى في القانون نفسه( بين أصغر من قضاء )دائرة صيدا في قانون 2000( والقضاء، وضم نصف القضاء إلى قضاء آخر )فصل المنية عن الضنية وضمها إلى طرابلس(، والمحافظة، وحتى جمع محافظتين: )النبطية والجنوب في انتخابات 1992 و1996(. في المقابل تبرز اليوم الدوائر الوسطى )أصغر من محافظة وأكبر من قضاء( بوصفها احتماال مرجحا إذا اعتمد النظام النسبي أو الدوائر الصغيرة )قضاء أو أصغر في األقضية التي تضم أكثر من 4 مقاعد( إذا أبقي على النظام األكثري. أما الهاجس األساسي؛ فهو االقتراب، قدر المستطاع، من العدالة والتساوي بين اللبنانيين، وقيمة صوتهم، فال ينتخب أحدهم 11 نائبا بينما ينتخب آخر 2، ويفوز أحد النواب بـ 110,000 صوت بينما يفوز آخر بـ 18,000صوت. وعليه؛ فإن أي معيار يعتمد يجب أن ينطبق على الكل بالتساوي، مع اإلشارة إلى أن هذا المعيار يصعب أن يكون جغرافيا )مساحة الدائرة( بسبب تفاوت الكثافة السكانية، بل يجب أن يكون انتخابيا )عدد
الناخبين، ومن ثم عدد المقاعد في الدائرة(.
وفي توزيع المقاعد النيابية؛ تبرز مشكلة أخرى هي اعتماد التوزيع الذي حصل العام 1990 وتضمن الكثير من الدوافع والعوامل السياسية، بينما يفرض الدستور إعادة توزيع المقاعد مع كل قانون انتخاب جديد وفقا للمعايير الحسابية المذكورة صراحة في المادة 26.24 وفي عملية حسابية صغيرة ترتكز على أعداد الناخبين في العام 2009 ؛ يتبين أن أعداد النواب وتوزيعهم، كما هو ثابت اليوم، لم تعد تنطبق على الواقع. فعلى سبيل المثال، بناء على معادلة الدستور، يجب أن يحصل الناخبون األرثوذكس على 12 مقعدا نيابيا وليس 14 مقعدا، بينما يحصل ناخبو األقليات على 3 مقاعد بدل مقعد واحد. في نة على 29 مقعدا بدل 27 مقعدا ، والشيعة 28 مقعدا بدل 27 مقعدا ، والدروز 6 مقاعد المقابل، من المفترض أن يحصل السبدل 8 مقاعد. على أن تتوزع هذه المقاعد على المناطق، إذ يوجد الناخبون مع أفضلية الباقي األكبر حيث ال يوجد عدد كاف للناخبين27. كما أن التوزيع يجب أن ال يرتبط بالضرورة بالقضاء بل بالدائرة االنتخابية المعتمدة وأعداد الناخبين في هذه
الدائرة، واالختالف وإن كان بسيطا قد يكون مؤثرا جدا في النتائج العامة.
في تشكيل الهيئة الناخبة، وبما أن المناطق اللبنانية مختلطة طائفيا بأغلبيتها الساحقة، فإن معضلة إضافية تبرز لتزيد من تعقيد األمور وصعوبة تأمين التمثيل الصحيح؛ وهي تشكيل المواطنين من الطوائف المختلفة هيئة ناخبة واحدة. يختار الناخبون كلهم بطوائفهم المختلفة في دائرة معينة )مهما كان حجمها( النائب الذي يفترض منه أن يكون ممثل طائفة معينة في قضاء معين. وهذا ما يعني أن هذا النائب لن يتم اختياره من جانب الناس الذين يفترض منه تمثيلهم، وأن المرشح بدوره سيهتم بإرضاء الكتلة الناخبة األكبر حجما بدل أن يهتم بالناس الذين يفترض به تمثيلهم. وأدى هذا الواقع إلى سوء تمثيل لكل األقليات في الدوائر المختلفة. وكان هذا التأثير أساسيا على المسيحيين الذين جعلتهم القوانين االنتخابية والتوزيع السياسي للمقاعد أقلية في الكثير من الدوائر، ولم يختاروا بأنفسهم، في أفضل األحوال، أكثر من 48 نائبا من أصل النواب الـ 64 الذين يحددهم الدستور لهم، ما يشكل خلال جوهريا في التوازن الوطني الميثاقي. لذلك تصاعدت األصوات المطالبة بفصل الهيئات الناخبة بحسب الطوائف، بحيث تختار كل طائفة بنفسها ولوحدها نوابها في منطقة معينة، وطالب بهذا الفصل معظم القوى المسيحية، بينما
26 توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد اآلتية: أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين. ج - نسبيا بين المناطق.
Al-Hindy, E 2009, Self Determination for Minorities: An Arab Perspective, Unpublished PhD Thesis, 27206-University of Sydney, pp.202
117 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
رفضته معظم القوى المسلمة. ويسعى اليوم مختلف األفرقاء إليجاد قانون انتخابي ونظام ودوائر تؤمن أكبر قدر ممكن من صحة التمثيل، وتحد على نحو كبير من تأثير الطوائف في اختيار نواب طوائف أخرى دون أن يتم الفصل التام المذكور أعاله.في اتفاق الطائف، وأصبح جزءا من أما في الحلول؛ فيبرز من بين الطروحات المتداولة اقتراح غير جديد كونه مذكورا دستور 1989، كما كان قبله في دستور 1926، وهو إنشاء مجلس شيوخ. إذ تنص المادة 22 من الدستور28 على ما يلي: "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية". ويجري الجدل حول وجوب تزامن انتخاب المجلسين أو حتى إنشاء مجلس الشيوخ قبل انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي لطمأنة الطوائف على حقوقها وخصوصياتها. ومن المسلم به أن تنتخب كل طائفة ممثليها في مجلس الشيوخ باستقالل تام عن بقية الطوائف، بينما تندمج في هيئة ناخبة مشتركة النتخاب النواب. ويبدو هذا الطرح هو األسلم والمعتمد في معظم الدول التعددية، وهو من ثم يفصل تمثيل الجماعات عن تمثيل األفراد، فال يؤثر أو يغلب إحداهما على األخرى. ويتيح هذا الفصل عمليا االنتقال بالتمثيل الفردي في مجلس النواب إلى أقصى حدود حسن التمثيل مع
نظام أكثري بدوائر فردية أو نظام نسبي مع لبنان دائرة واحدة.
الشفافية
يجب إجراء انتخابات تشريعية تفي بالمعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية بشكل دوري ومتكرر يمكن للناخبين من خاللها مساءلة ومحاسبة ممثليهم. لكن بما أن الفترة الممتدة بين الدورتين هي انعكاس لمطالب ورغبات الناخبين يجري خاللها صياغة القوانين وتطبيقها لتلبية المطالب، فإنه يجب أن يكون امتداد الفترة مقبوال يسمح للنواب بتحقيق أكبر قدر من االحتياجات، وذلك
لتجنب تعليق األعمال أو تعطيلها في حال تغير النواب.29
انتخابية مستقلة هيئة إنشاء معيار أيضا يبرز والنزاهة، الشفافية لتأمين العالم30 بشكل واسع حول المعتمدة الوسائل ومن إلدارة حسن سير العملية االنتخابية ومراقبتها. يمكن أن تتألف الهيئة من أعضاء يتبعون الحكومة أو أعضاء مستقلين. ويقترح الوزير مروان شربل في مشروعه االنتخابي إنشاء هيئة إدارية ذات صفة قضائية لإلشراف على االنتخابات النيابية. ومن الهيئة تأثير خارجي. وتشمل وظائف أي التامة، وال تخضع ألي نوع من باالستقاللية تتمتع الهيئة بأن التأكد الضروري االنتخابية عادة تدريب كل من سوف يشارك في أي شيء يتعلق في العملية االنتخابية؛ وتأهيل المراكز االنتخابية؛ وإعالم الناخبين عن االنتخابات وسيرها وعن المرشحين؛ وتسجيل الناخبين؛ وإعداد اللوائح االنتخابية؛ ومراقبة العملية االنتخابية؛ ومراقبة فرز األصوات؛ وتحديد الرابحين؛ وأخيرا تلقي أي طعون أو شكاوى. إن استقاللية الهيئة تشكل نقطة أساسية للحصول على انتخابات ديمقراطية بصرف النظر عن كيفية تشكيل هذه الهيئة.31إال أن الرأي الذي ساد في لبنان حتى اآلن، هو أن هيئة مستقلة كليا لن تتمكن من إدارة جميع جوانب العملية االنتخابية التنظيمية منها واألمنية واإلدارية. وعليه تم اللجوء في قانون العام 2009 )وفي اقتراح قانون الوزير شربل( إلى هيئة مراقبة مرتبطة بوزارة الداخلية، ما جعلها تفقد جوهر عملها، وتفشل
في تأمين استقاللية إدارة االنتخابات.
حق الترشح
في ما يختص بحق الترشح لالنتخابات النيابية، هناك دائما بعض الشروط التي تحدد األهلية للترشح. من الضروري، بحسب المعايير الدولية، أن تكون هذه الشروط موضوعية ومنطقية ال تعمد إلى تهميش أو حرمان أحد من حق المشاركة. وعدم وضع أية قيود على أساس الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اإلعاقة الجسدية هو أحد أهم هذه المعايير الدولية. هذه القيم تأتي تزامنا مع مبادئ المساواة وعدم التمييز التي تشكل جوهر الدولة الديمقراطية. إذ تنص الشرعة العالمية للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في االستفادة من الخدمات العامة، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو من خالل ممثليهم.
28 ألغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وأعيد وضعها معدلة بموجب القانون الدستوري الصادر في 1990/9/21.
29 نحو تطوير المعايير الدولية لديمقراطية تشريعية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007 ،ص 4.
30 يبلغ عدد البلدان التي اعتمدت هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات 122 دولة، بينما اعتمدت 54 دولة هيئة حكومية، و28 دولة هيئة مختلطة بحسب »الدليل التدريبي حول االنتخابات« الصادر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات 2011، ص. 20.
31 القيم وااللتزامات العالمية المتعلقة بالحق في انتخابات ديمقراطية: دليل عملي لديموقراطية االنتخابات – أفضل الممارسات ، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2002 ،ص 9.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين118
ومن الطبيعي أن توضع بعض القيود على حق الترشح كتلك المتعلقة بـ: العمر؛ والجنسية؛ أو مكان اإلقامة.32أما الواقع في لبنان؛ فهو مختلف، إذ ال تسمح المادة 25 من القانون االنتخابي الحالي لبعض األفراد الترشح ألسباب عديدة. إذ يشمل المنع من الترشح: العسكريين في الفئات المختلفة، مثل: )الجيش؛ واألمن العام؛ وأمن الدولة والجمارك( الذين ما زالوا يخدمون في الفترة االنتخابية، إال إذا استقالوا أو تقاعدوا قبل ستة أشهر من موعد االنتخابات، كما يشمل من هم دون الخامسة والعشرين من عمرهم، والمجنسين لبنانيين منذ فترة ال تقل عن عشر سنوات من موعد االنتخابات، ومن عليهم أحكام قضائية. ومن األسباب التي تحول دون منح هذه الفئات حق الترشح هي مثال: الرغبة في عدم االستفادة من الوجود في القطاع العام لتحقيق مصالح سياسية، أو التأكد من الوعي الفكري الكامل وبلوغ الرشد للحصول على المؤهالت الكاملة للترشح لالنتخابات، وأخيرا قد يكون أحد األسباب هو التأكد من وجود الحس باالنتماء الوطني.33في المقابل، هنالك استثناءات جدلية، مثل شرط أن يكون المرشح متعلما أو يحمل شهادة. وبينما يرى بعض الناس أن هذا االستثناء نابع من حاجة المشرع لقراءة ومناقشة وصياغة القوانين، يعتبره بعضهم اآلخر تمييزا غير مقبول، إذ إن فردا غير متعلم يمكن أن يرى فيه الناس ممثال عنهم أفضل من الكثير
من حملة الشهادات. وعليه يجب عدم حصر حرية الترشح وحرية االختيار للناخبين.
وهناك نقطة أساسية في ما يتعلق بحق الترشح تقضي بمنح كل شخص حرم من هذا الحق، الحق في الطعن بهذا القرارأمام هيئة قضائية أو انتخابية مستقلة. والنظر بهذا الطعن يجب أن يجري ضمن مهلة زمنية مقبولة حتى يتيح للمرشح، في حال قبول طعنه، الوقت الكافي للتحضير لحملته االنتخابية، وال يجوز أن يخضع أي مرشح عندما يوافق على ترشحه ألي نوع
من الضغوطات إلجباره على االنسحاب.34
كما أن هناك شروطا تحد من مشاركة بعض الناس، ويجب أن تكون هناك شروط تشجع مشاركة من يمكنه الترشح ولكنه متردد، مثل الفئات المهمشة. فمثال، لطالما كانت النساء محرومات من عدد من حقوقهن، بما فيها الحق بالمشاركة في الحياة السياسية. وبهدف تغيير هذا الواقع، اتخذت العديد من الدول تدابير معينة أهمها إتباع الحصص النسائية "الكوتا". وسيناقش
هذا الموضوع بالتفصيل الحقا خالل البحث.
حق االقتراع
باالنتقال إلى حقوق الناخبين، يشكل التصويت ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي الذي يجب أن يحدد من يمكنه التصويت. هذا التحديد يجب أن يتم على أسس واضحة تسمح للجميع بمعرفة شروط الحق في المشاركة بالتصويت. ومن المهم أيضا أن تكون شروط سحب حق التصويت واضحة وقانونية لتجنب أية مشكالت تخص هذا الموضوع. ويشكل االقتراع العام والمباشر أحد الركائز األساسية للديمقراطية التمثيلية وأساسا لشرعية المجلس النيابي. هذا المبدأ تضمنه إعالن وارسو العام 2000 الموقع من أكثر من 100 دولة الذي ينص على أن: "إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكام، من خالل ممارسة الشعب الحقوق والواجبات المدنية في اختيار ممثليهم من خالل انتخابات دورية، حرة ونزيهة باالقتراع العام وعلى قدم المساواة". في الواقع، أصبح االنتخاب المباشر للنواب ذا أهمية قصوى ليس بوصفه مبدأ من مبادئ الحكم فقط ولكن باعتباره حقا من الحقوق المدنية األساسية.35هناك عادة أربعة معايير أساسية تحدد من يمكنه التصويت، وهي: العمر؛
والجنسية؛ ومكان اإلقامة؛ والحرمان من الحق بسبب أي إعاقة فكرية أو اقتراف جناية أو جريمة.
المدنية حقوقه بجميع يتمتع عاما عشر الثمانية بلغ شخص كل أن على الدولية المعايير تنص بالعمر، يختص ما وفي والسياسية.36 لكن هناك اتفاق عام على أنه يمكن رفع هذا العمر أكثر من ذلك. ففي هولندا مثال، تم خفض العمر القانوني من 23 عاما إلى 21عاما كمرحلة أولى، ومن ثم إلى 18 عاما. وفي لبنان، مازال العمر المعتمد 21 عاما، وهناك تداول على خفض سن االقتراع إلى 18 عاما. وتم تقديم هذا االقتراح من لجنة فؤاد بطرس. إال أن التخوف يأتي من كون التوازن
32 نحو تطوير المعايير الدولية لديمقراطية تشريعية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007 ،ص 5.
33 المواد: 7،8،9،10 ، القانون رقم 25 من القانون االنتخابي، الجمهورية اللبنانية، 2008.
34 كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008 ،ص 46.
35 نحو تطويرالمعاييرالدولية لديمقراطية تشريعية ،المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007 ،ص 3.
36 كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008 ،ص 41.
119 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
اللبنانية يزداد خلال مع صغر الفئات العمرية، وبزيادة الفئة العمرية 18 إلى 21 عاما سيزداد الديموغرافي بين الطوائف الفارق بين المسلمين والمسيحيين، وسيصبح الضغط أكبر على حسن التمثيل. ومن هذا المنطلق؛ برزت المقايضة السياسية بين خفض سن االقتراع وإعطاء حق االنتخاب لغير المقيمين في لبنان إلعادة نوع من التوازن. إن هذا الجدل والمقايضات مرفوضة تلقائيا من منطلق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، فالحق ال يقايض، وكل مواطن يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها. وحول مكان اإلقامة، لم تقم الدولة اللبنانية، حتى اآلن، بواجبها لتأمين آلية االقتراع للبنانيين غير المقيمين على األراضي اللبنانية، بالرغم من أن أسماءهم ترد تلقائيا ضمن اللوائح االنتخابية. هذه نقطة أساسية بما أن العديد من اللبنانيين الموجودين خارج األراضي اللبنانية يساهمون في إنماء لبنان، لكنهم ال يستطيعون العودة بسبب صعوبة المعيشة فيه.37 وعليه؛ ال يمكن للدولة اللبنانية أن تميز بين مواطنيها أو تحرمهم من حقهم في اختيار ممثليهم لمجرد أن ظروف حياتهم وعملهم تمنعهم من الوجود في لبنان في أثناء فترة االنتخابات. في المقابل يبرز أيضا موضوع السماح للمواطنين باالقتراع في أماكن سكنهم داخل لبنان دون إجبارهم على العودة الى أماكن قيدهم األساسية لذلك. وهذا االقتراح مع أنه يسهل أمور الناخبين، إال أنه ال يمس بجوهر حق االقتراع، بل يجعل عملية الفرز أكثر تعقيدا، ويعرضها الحتمالية الخطأ، فضال عن أن معظم اللبنانيين غير مقيمين
في قراهم، فقد أفرغ الريف من أهله، وسيكون االقتراع في أماكن سكنهم عامال إضافيا يكرس هجرهم لقراهم.
في ما يتعلق باقتراع حاملي اإلعاقات العقلية، تنص القوانين االنتخابية في العديد من البلدان على أنه يجب استبعاد حق الترشح واالنتخاب لذوي االحتياجات الخاصة العقلية. ولكن يشهد العالم المتطور العديد من النقاشات حول حقوقية هذا التدبير. ففي الجهة األولى، يعد حجب هذا الحق مخالفة واضحة للمادة 29 من العهد الدولي لحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. وتأكيدا على هذا السياق، فلقد أصدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قرارا بإبطال حجب المشاركة السياسية لمواطن ذوي أن الناس بعض فيعتبر الثانية، الجهة من أما االنتخابية.38 حقوقه له وأعادت نفسية، مشكالت من يعاني هنغاري االحتياجات الخاصة العقلية غير قادرين على اتخاذ قرارات سياسية ، وأنهم يتأثرون بآراء محيطهم. تبقى هذه النقطة شائكة، ولكن من المفروض ضبط قرارات كهذه، وتنظيمها بشكل دقيق وشفاف ال يكون تلقائيا وشامال بل ينظر إلى كل حالة على حدة ويميز بين مستوى اإلعاقات. أما في ما يختص باإلعاقة الجسدية؛ فيجب أال يحرم من يعاني منها من حقه في االقتراع. لهذا يجب على المشرفين على العملية االنتخابية تأمين كل التسهيالت الالزمة، مثل: تجهيز المراكز االنتخابية لتسهيل مرور
وحركة ذوي االحتياجات الخاصة،39وتأمين وصولهم إلى مراكز االقتراع من أجل ممارسة حق التصويت.
أما في ما يتعلق بمكتسبي الجنسية حديثا، فاختلفت القوانين االنتخابية في تحديد المهلة التي يمكنهم بعدها االقتراع، فاعتبر قانون العام 2000 أنه يمكنهم االقتراع فورا بعد الحصول على الجنسية. في حين لم يخولهم قانون العام 2008 االقتراع إال بعد انقضاء 10 سنوات على تجنيسهم. ويمكن اعتبار هذا األمر إخالال بمبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون، إال أن ما يمكن تفهمه هو أن الجنسية أعطيت لكثير من الناس الذين ال يستحقونها، ولكن حصول خطأ ال يبرر تصحيحه بخطأ آخر. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األمر ال يطبق على المرأة األجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني، إذ يحق لها االقتراع
فور حصولها على الجنسية.
ختاما، يبرز استثناء آخر غير مبرر يحد من حق االقتراع، وهو منع العسكريين والموقوفين غير المحكومين من حقهم، وهذا أمر مخالف لجوهر المساواة أمام القانون بالحقوق والواجبات، وتجب العودة عنه بشكل كامل. فالموقوف يفترض أن يعامل، بوصفه بريئا، بحقوق مدنية كاملة إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي، وعلى الدولة أن تتحمل عبء تأخير المحاكمات وازدياد عدد هؤالء. أما العسكريون الذين يخدمون أمن الوطن؛ فال مبرر الستثنائهم من المشاركة في العملية السياسية، وحجة عدم توريطهم في السياسة حجة واهية؛ ألن العسكري مواطن له رأيه السياسي والوطني المساوي ألي مواطن آخر، إضافة إلى
أن هذا الرأي ينعكس من خالل عائلته أصال.
خاصة بطاقات أو أذونات استصدار إلى اللجوء دون لالقتراع كافيا سندا الهوية بطاقة اعتبار يجب أخرى، جهة من باالنتخابات تكون مكلفة وعرضة لألخطاء والتالعب. كما أن هناك أمرا أساسيا آخر يجب أخذه باالعتبار، وهو منح أي ناخب
37 تعتمد 114 دولة آليات القتراع مواطنيها غير المقيمين بحسب »كتيب اإلصالحات«، الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي، ص24.
Alajos Kiss vs Hungary, Netherlands Institute of Human Rigth 38
39 كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008 ،ص 70.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين120
حرم حق التصويت يوم االقتراع، لعدم وجود اسمه في اللوائح أو بقرار من المشرفين، الحق بالطعن الفوري، والقرار المعجل لتصويب األوضاع. أخيرا، من حق أي ناخب الحرية في التصويت من دون التعرض ألية ضغوطات.40
الفئات المهمشة: الحصص النسائية "الكوتا"
ما تواجه المهمشة، سيتم التركيز على فئتين أساسيتين هما: األقليات؛ والنساء. فكثيرا الفئات باالنتقال إلى موضوع تمثيل النساء حواجز تحول دون تمثيلهن تمثيال عادال وفعاال بسبب التمييز الذي ما زال قائما بين الرجل والمرأة . وهناك العديد من المعاهدات العالمية المعترف بها والمعتمدة مثل: ميثاق األمم المتحدة؛ واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لمكافحة التمييز؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جميعها تنادي بضرورة وقف التمييز في التمثيل. وينبغي أن تسعى الدول لوضع النظم االنتخابية التي تحقق كامل المساواة بين الرجل والمرأة.41وهناك طريقة متبعة، في معظم األحيان، في ما يختص بموضوع الحصص النسائية "الكوتا"، وهي تلك التي تعتمد مبدأ تخصيص نسبة معينة للنساء من أي الئحة انتخابية. ويمكن تشريع هذا األمر، وتعريض من ال يتبع هذا المبدأ لعقوبات صارمة.42ففي بلجيكا، مثال، تم وضع قانون يقضي بتساوي عدد النساء والرجال على أي الئحة انتخابية، كما أنه ال يسمح أن يحتل أول مركزين من أي الئحة شخصان من الجنس نفسه.43 وفي لبنان، يقترح مشروع وزارة الداخلية وجوب أن تضم كل الئحة انتخابية بين أعضائها نسبة ال تقل عن 30% من الجنس اآلخر، واعتماد الئحة يدرج فيها، بصورة متتابعة، اسم مرشح من جنس معين، ثم حكما مرشح من الجنس اآلخر.44 وفي بلدان أخرى؛ جرى تحديد عدد معين من المقاعد للنساء في المجلس، وليس في اللوائح. في المقابل يبرز رأي آخر مفاده أن تخصيص مقاعد للنساء في الترشيح أو النتائج قد يكون، بحد ذاته، انتقاصا من حقوق المرأة، واعتبارها قاصرة بحاجة إلى معاملة استثنائية؛ ألنه بدون هذه المعاملة لن تكون المرأة قادرة على الوصول إلى الندوة البرلمانية. وهذه النظرة مفهومة ومحقة، ولذلك غالبا ما يتم اعتماد "الكوتا" بشكل استثنائي ومؤقت على عدد معين من الدورات، على أن تلغى من بعدها. ويبدو أن المجتمع اللبناني بحاجة إلى مثل هذا اإلجراء؛ ألن عدد النساء اللواتي انتخبن في البرلمان ال يتناسب أبدا مع دورهن الفاعل في المجتمع اللبناني، وبخاصة إذا ما أضفنا لذلك
كون أغلبيتهن وصلن إلى البرلمان بسبب ارتباطهن برجل سياسة معين.
الفئات المهمشة: األقليات
في ما يختص بموضوع األقليات، تنص المادة 25 من الشرعة العالمية للحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام دون الخضوع ألي نوع من أنواع التمييز.45ويجب وضع إجراءات خاصة لتشجيع وتفعيل مشاركة الجميع في الحياة السياسية. لكن من غير المقبول إتباع اإلجراءات نفسها لفترة زمنية طويلة، بل يجب وضع خطط أو قوانين تبعا للتغيير الديموغرافي الحاصل بين كل فترة انتخابية وأخرى.46 وأي نظام انتخابي يجب أن يحرص على التمثيل العادل لكل األقليات. لذلك، هناك حاجة ملحة لتصميم مفصل لعدد األقليات، توزيعهم الجغرافي والنسبة التي يشكلونها. ومن الضروري أن يجري هذا التصميم خالل كل دورة انتخابية، ووضع خطة تتواءم والتغييرات الجديدة لضمان العدالة والمساواة. وتتضمن حقوق األقليات الحق في االعتراف بهم؛ والحق في ممارسة وإتباع الديانة والتقاليد التي يؤمنون بها؛ والحق في المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرارات من دون تمييز. ومن المهم مراعاة الشق المتعلق بموضوع
40 كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008 ،ص 75.
41 القيم وااللتزامات العالمية المتعلقة بالحق في انتخابات ديمقراطية: دليل عملي لديموقراطية االنتخابات – أفضل الممارسات، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2002 ،ص 12.
42 نحو تطوير المعايير الدولية لديمقراطية تشريعية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007 ،ص 7.
43 الكوتا االجندرية في األنظمة االنتخابية وتطبيقها في أوروبا، البرلمان األوروبي، 2008 ،ص 42.
44 وزارة الداخلية اللبنانية، مشروع قانون االنتخابات النيابية للعام 2013 ، الجمهورية اللبنانية،2012 ، ص 24.
45 ندرور ينولدس، األنظمة االنتخابية وحماية ومشاركة األقليات، مجموعات حقوق األقليات العالمية، 2007 ،ص 3.
46 نحو تطوير المعايير الدولية لديمقراطية تشريعية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007 ،ص 7.
121 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
األقليات في األنظمة االنتخابية، وبخاصة في المجتمعات المشحونة بالضغوطات والخالفات الطائفية والسياسية.47وهناك أربعة متغيرات أساسية يجب إدراجها في ما يتعلق بموضوع األقليات وهي: حجم األقلية بوصفها مجموعة؛ ودرجة التجمع أو االنتشار الجغرافي؛ ودرجة التجانس أو االختالف العرقي داخل المجموعة الواحدة؛ وأخيرا عدد الناخبين من كل مجموعة.48وعندما نتكلم عن األقليات في لبنان، ال نعني المكونات األساسية للمجتمع اللبناني بالرغم من أن كلها، من الناحية التقنية، أقليات، إذ ال تشكل أي منها أغلبية أو أكثرية، وهي تتمتع بمقاعد محددة ووظائف معينة يجب أن تخضع لمعيار حسن التمثيل الذي ذكر سابقا. أما المعنيون بتعبير أقليات هنا، فهم المجموعات التي ال يؤهلها عدد المنتسبين إليها أو ال يخولها القانون الحصول اللبناني. وتشمل هذه األقليات طوائف معينة معترف بها، المجتمع ثم، تعاني من تهميش كبير في على مقاعد، وهي، من مثل: )السريان الكاثوليك؛ والسريان األرثوذكس؛ واألشوريين؛ والكلدان؛ واألقباط؛ والالتين، واإلسماعيليين؛ واليهود(، كما تشمل كل الطوائف غير المعترف بها، مثل: )البهائيين – شهود يهوه(، وكل المجموعات اإلثنية، مثل: )األرمن؛ والسريان؛ واألشوريين؛ واألكراد؛ والتركمان( وكل من ال ينتمون إلى أية طائفة أو مجموعة إثنية. على كل هؤالء، بحسب الواقع الحالي لألمور، أن ينضووا تحت لواء طائفة أو أخرى لكي يخولهم القانون المشاركة في الحياة السياسية. وهذا ما يتناقض، بشكل
جوهري، مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وأبسط المعايير الدولية.
ال تتركز، في الواقع، معظم األقليات في لبنان في مكان معين؛ بل تنتشر في جميع األراضي اللبنانية. وعليه، فإن ربط المقاعد المخصصة لها بقضاء معين ضمن التوزيع الطائفي للمقاعد، هو ، بحد ذاته، أمر مجحف ، ألن أيا يكن هذا القضاء، فإن نسبة كبيرة من ناخبي األقليات ستكون خارج هذه الدائرة. ومن الضروري أن يؤخذ هذا الواقع باالعتبار إذا ما أبقي على النظام االنتخابي الحالي، أو إذا ما أنشئ مجلس الشيوخ. ففي حال إنشاء مثل هذا المجلس، يمكن للفئات التي يؤهلها حجمها لذلك أن تتمثل بمقعد، أو أن تتمثل مجتمعة بمقعد على أال يرتبط بمنطقة أو فئة، أما في انتخاب النواب خارج القيود الطائفية إذا ما تم، فيمكن لكل المنتمين لهذه األقليات المشاركة بوصفهم مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، واختيار ممثليهم من منطلقات
سياسية صرفة، وبحسب البرامج السياسية لألحزاب ومرشحيهم.
المعايير المتعلقة بالعملية االنتخابية
إن تفاصيل العملية االنتخابية مهمة جدا لتأمين حقوق الناخبين، والمساواة بينهم وحرية اختيارهم، وهي تضم العديد من المعايير المعايير سرية االقتراع؛ والالئحة االنتخابية القوانين. ومن بين هذه الغالب، مقبولة ومعتمدة في معظم التي أصبحت، في المطبوعة سلفا؛ وكيفية الفرز؛ وتوحيد يوم إجراء االنتخابات، كذلك ضبط اإلنفاق واإلعالن االنتخابيين؛ ومشاركة المجتمع المدني والهيئات الدولية بالمراقبة؛ وحق الطعن، وغيرها. كما سبق وذكر، لن تدخل هذه الدراسة في هذه المرحلة كون أي من هذه المعايير ال يواجه جدلية سياسية في لبنان. وعليه؛ فهي تقنية بحتة، ونكتفي بذكرها، مع اإلدراك الكامل أن القبول المبدئي بهذه المعايير ال يعني، بالضرورة، إدخالها في القوانين، وال يعني، بالطبع، سهولة في التطبيق، إذ يحتاج كل من هذه المعايير
آليات متكاملة قد تكون معقدة ومكلفة جدا، مثل: مراقبة اإلنفاق االنتخابي.
معايير ما بعد العملية االنتخابية
إن مرحلة ما بعد عملية االنتخاب تتمتع باألهمية نفسها لمرحلتي: االنتخابات، وما قبلها . وتشمل المعايير الدولية ما يلي: من حق الجميع الحصول على نتائج االنتخابات مفصلة وكاملة مع المخالفات ومجريات العملية االنتخابية.49 بعد ذلك، يحق لكل مواطن أن يكون على علم بما يجري داخل البرلمان، وما هي خطط الممثلين الذين اختارهم. ويجب عرض جميع مشاريع القوانين على المواطنين الذين لديهم الحق التام في التعبير عن آرائهم سلميا وطلب التغييرات. إن مساءلة ومحاسبة الممثلين حق، كما هو واجب، على جميع المواطنين لضمان تحقيق مطالبهم. وكان ال بد من اإلشارة إلى هذه المعايير، بالرغم من أن الكثير منها متعلق بالعمل التشريعي والنظام الداخلي لمجلس النواب؛ ألنها مرتبطة، بشكل أساسي، بقدرة الناخب على محاسبة
من انتخب في االنتخابات التالية بناء على عمله في السنوات المحددة، وهذه القدرة هي جوهر الديمقراطية واالنتخابات.
47 أندرور ينولدس، المصدر السابق نفسه ، 2007 ،ص 28.
48 المصدر السابق نفسه، 2007 ،ص 26.
49 كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008 ،ص 86.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين122
الخالصة والتوصيات:
باإلمكان وضع مشاريع قوانين انتخابية عديدة، تختلف كثيرا عن بعضها بعضا؛ ألن األساليب التي يمكن أن تعتمد كثيرة. ففي لبنان، ما زال النقاش جاريا على قانون االنتخاب الذي سوف يتم اعتماده. واالنتخابات النيابية المقبلة أصبحت قريبة، وما زال القانون الجديد غامضا. وهناك حاجة ملحة العتماد نظام انتخابي جديد، يساهم في تطوير الحياة السياسية، ويضمن حق الجميع في التمثيل. وهنا يقع الدور على عناصر المجتمع المدني بالتحرك والمطالبة بإقرار قانون جديد يراعي حقوق اإلنسان ويضمنها، من خالل تبني المبادئ والمعايير الدولية باعتبارها قاعدة أساسية مع األخذ باالعتبار المجتمع اللبناني، وواقعه، وحاجاته. إن إرادة الشعب يجب أن تكون أساس السلطة، كما هو معبر عنها من خالل ممارسة المواطنين لحقهم المدني والسياسي في اختيار ممثليهم من خالل انتخابات عادية، حرة ونزيهة، تجرى باالقتراع العام وعلى قدم المساواة، وعن طريق التصويت السري، وتتم مراقبتها من جانب سلطات انتخابية مستقلة، وتكون خالية من التزوير؛ والترغيب؛ والترهيب.50الحق في انتخابات ديمقراطية حقيقية ينطوي على مجموعة واسعة من القيم المعترف بها دوليا عن حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وممارسة هذه القيم من الدولة، بما يتطابق مع تركيبتها ونظامها، توضح مدى نمو هذه الدولة وتطورها. وتترابط هذه القيم من خالل مبادئ: الشمولية؛ والشفافية؛ والمساءلة في السياق االنتخابي، وهذا األمر يوفر األساس لثقة الجمهور في االنتخابات وفي الحكومات التي تنتج عنها. وللمواطنين ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في الحرص على صيانة الحقوق اإلنسانية في أي قانون انتخابي سيعتمد. وهنا يكمن دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي لدى المواطنين، وتحضير
تقارير واقتراحات يمكن اعتمادها من السلطات المعنية.
في موضوع قانون اإلنتخابات اللبناني وجدلية حقوق اإلنسان فيه، هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها. وهنا يكمن دور المتخصصين في المساهمة في النقاش العام حول هذه القضايا لالستفادة من خبراتهم ونشر وجهات نظرهم. وتؤدي منظمات المجتمع المدني - بما في ذلك منظمات مراقبة االنتخابات؛ وجمعيات حقوق اإلنسان؛ ومجموعات التربية المدنية وغيرها - أدوارا مهمة في تحليل األطر القانونية لالنتخابات، وتقديم توصيات من أجل تحسينها، ومراقبة العمليات المحيطة بها.51وبناء عليه، نستخلص من هذه الدراسة والبحث والتحليل اللذين تضمنتهما الموضوعات التالية التي لم يتم حسم الجدل حولها أو لم تطرح جديا، ونقترح على هيئات المجتمع المدني إدخالها ضمن برامج المناصرة التي تقوم بها للضغط على
المعنيين بإصدار قانون انتخابي جديد:
تظهير المعنى الصحيح لحسن التمثيل بشكل يوازي بين حسن تمثيل األفراد وحسن تمثيل الجماعات، دون أن يكون أحدهما على حساب اآلخر. )مع المالحظة أن أفضل توازن قد يكون بالفصل التام بينهما عبر إنشاء مجلس شيوخ
ينحصر فيه تمثيل الجماعات(.
تحقيق المساواة بين الناخبين عبر حجم الدوائر )عدد الناخبين( وعدد المقاعد التي يقترع لها كل ناخب.
تطبيق المادة 24 من الدستور، وإعادة توزيع المقاعد بحسب ما ورد فيها مع وضع كل قانون انتخاب جديد.
رفع التأثير السياسي في االنتخابات، إما عبر حكومة حيادية من غير المرشحين أو من خالل هيئة مستقلة.
رفع أية شروط تحد من حق الترشح، مثل: )الشهادات العلمية أو غيرها...(.
خفض سن االقتراع ليساوي سن الرشد القانوني )18 عاما(.
تمكين كل مواطن يتمتع بحقوقه بالتصويت حتى العسكريين؛ والموقوفين؛ والمرضى؛ والمعوقين؛ والمجنسين.
تمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان والمسجلين في لوائح الناخبين من االقتراع في االنتخابات العامة.
50 نحو مجتمع ديمقراطيات – المؤتمر الوزاري، إعالن وارسو النهائي، 2000 ،ص 2؛ المادة 21 من الشرعة العالمية لحقوق اإلنسان.
51 باتريك مرلو، الترويج ألطر قانونية لديمقراطية االنتخابات، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2008 ،ص 4.
123 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
النظام الترشيح بشكل مؤقت على عدد دورات محددة )النسبة تحدد حسب النسائية "الكوتا" في اعتماد الحصص االنتخابي(.
تأمين حق اإلقليات المعترف بها وغير المعترف بها في المشاركة في االقتراع والترشح ، شأنها شأن بقية اللبنانيين.
اإلصرار على تطبيق المعايير المقبولة نظريا المتعلقة بسير العملية االنتخابية.
العمل على تعديل القوانين المتعلقة بعمل النواب بعد انتخابهم، بما يمكن المواطن من مساءلتهم ومحاسبتهم.
نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أضاءت على بعض الموضوعات الجدلية، وساهمت في تزويد المجتمع المدني بمادة ضغط إضافية نحو قانون انتخابات جديد، يسير بلبنان خطوة إلى األمام صوب سالم أهلي دائم، وديمقراطية أفضل.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين124
امللحق 1 – معايري النظام االنتخابي بحسب حقوق اإلنسان52
المعاهدات أو النصوص المتعلقة المعيار/ المبدأ
الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي ، ميثاق المادة 39
إعالن وارسو )2000( والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد
المادة 25 )ب(
ينبغي أن يتم انتخاب أعضاء المجلس النيابي من خالل انتخابات عامة تطبق االقتراع السري
إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات نزاهة بشأن الدولية، بالمعايير تفي تشريعية انتخابات إجراء يجب أية من خالية تكون أن يجب وأنها الوطنية، السياسية المنافسة اعتبارات ثنائية أو متعددة األطراف التي يمكن أن تتعارض مع نزاهة
العملية االنتخابية
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 25 )ب(
يجب أن تعكس مدة والية المجلس النيابي الحاجة للمساءلة، وهذا يتم من خالل انتخابات تشريعية دورية وثابتة
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 26
إعالن وارسو )2000( أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية
التمييز العنصري، المادة 5 )ج(
ال يجوز فرض قيود على أهلية الترشح عبر التمييز على أساس الدين؛ أو الجنس؛ أو العرق؛ أو األصل العرقي؛ أو القدرة البدنية.
انتخابات إلجراء الحالية االلتزامات منظمة في المشاركة الدول في ديمقراطية
األمن والتعاون األوروبي، المادة 6.3السياسية، و المدنية للحقوق الدولي العهد
المادة 25
يجب أن تكون الشروط الموضوعة على الحق في الترشح واالنتخاب والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد من المادة 25 في المدرجة ملتزمة بأسس الموضوعية. فعلى سبيل المثال، من المعقول فرض سن االنتخاب. في للحق المخصص السن عن يكون مختلفا الترشح على ويجب عدم حجب هذه الحقوق على أي مواطن إال في األطر المدرجة في القانون التي يجب عليها؛ أي هذه األطر، أن تتحلى بالموضوعية. فعلى سبيل المثال يمكن حجب حق الترشح واالنتخاب لفرد ذي عاهة عقلية.
بمرض المصابين األشخاص حماية مبادئ عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، المبدأ
الرابعالخاص اإلعالن الدولي، البرلماني االتحاد
بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة، المادتان: 7 و8
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 2 )3(
أي مواطن له الحق في اللجوء إلى محكمة نزيهة ومستقلة أو إلى لجنة انتخابات مستقلة في حال تم استبعاد طلب الترشح.
52 Organization for security and Co-operation in Europe )OSCE(; Electoral systems and the protection andparticipation of - minorities - Minority Rights group international; Toward the Development of international standards for democratic legislatures )NDI(
125 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 20 )2(
يمكن للدولة إعادة النظر أو استبعاد أحد المرشحين باالستناد إلى المبادئ المدرجة تحت المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
السياسية، و المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 2 )3(
أي إجراء الستبعاد أي مرشح يجب أن يحال إلى هيئة قضائية مختصة تنظر في األسس الدستورية والقانونية لتثبيت االستبعاد
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،4، 7)أ(، 8
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، المادة الثانية
الحصص بنظام تعرف المرأة مشاركة لتعزيز التفضيلية المنظومة الذي يوزع المقاعد مناصفة 50-50 بين الرجال واإلناث على القوائم القوائم تعاقب قانونية آلية في إدراجه يجب النظام وهذا الحزبية.
المخالفة.
Inter parliamentary union. The contribution of Parliament to democracy: A framework. IPU
p 2والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد
المادة 25 )ج(
يجب واألقليات، المهمشة الفئات مشاركة وضمان تشجيع أجل من والتعددية األقليات؛ أي الفئات؛ بين التنوع تضمن آليات وضع الدينية. وأحيانا يجب اتخاذ ترتيبات لضمان تمثيل األقليات من خالل "تخصيص " المقاعد في المجلس النيابي. و لكن يجب استعراض هذه
الترتيبات من الناحية الديموغرافية ألجل ضمان صحة التمثيل.
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 25
أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة المادة ،A/SP1/12/01 البروتوكول
األولى )و(المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة
للهيئات التشريعية الديمقراطية، الفقرة 1،3،1
يجب عدم إرغام المنتخب على القيام بحلفان ديني يتعارض مع مبادئه.
الحفاظ على حيادية الدولة تجاه األمور المتعلقة بالدين.
للكومنولث،المعايير البرلمانية الرابطة للهيئات التشريعية الديمقراطية، الفقرة 1،3،1
إعالن وارسو )2000(
ال يجوز على المشترع أن يتقلد وظيفة أو مكانة في أي من السلطات التنفيذية و/أو القضائية
Bradshaw &Pring, Parliament and Congress, 2nd edition, Quartet Books, London pp 83-97
السياسية، و المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 19)2(
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 19
والتعبير. للرأي أوسع حرية له تؤمن بحصانة المشترع يتحلى باإلضافة إلى عدم وجوب المالحقة القانونية ألي مشترع على مواقفه
ومبادئه، ولو بعد انتهاء واليته.
الدولي البرلماني االتحاد مجلس قرار )IPU(، مكسيكو، 1976
إن حماية أعضاء المجلس النيابي تعد أساسا مهما لتمكينهم من الدفاع، وتعزيز حالة حقوق اإلنسان في بالدهم
السياسية، و المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 26
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، المادة 7 المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة
للهيئات التشريعية الديمقراطية
فوق وضعية في المشترع لوضع النيابية الحصانة استخدام عدم الوالية خالل فقط صالحة الحصانة هذه أن على والتأكيد القانون.
النيابية
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين126
المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة الفقرة ، الديمقراطية التشريعية للهيئات
1.4.3
السلطة المشترع من صالحية النيابية من الحصانة تبقى حرية رفع التشريعية فقط، ويتم هذا من خالل التصويت في الهيئة العامة. ويمنع
على السلطة التنفيذية رفع الحصانة النيابية.
المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة الفقرة، الديمقراطية، التشريعية للهيئات
1.3.3الدائم الممثل UN A/54/178، رسالة من
لدولة رومانيا أمام األمم المتحدة مرسلة الى األمين العام في 27 تموز/يوليو 1999.
أجل ومن سلطة، كل استقاللية لضمان هذا السلطات فصل يهدف ضمان عدم حصر الثقل السياسي في اتخاذ القرارات في سلطة واحدة
فقط.
حصانته سحب بعد للمشترع وتفضيلية خاصة بتدابير األخذ يمنع النيابية من جانب المجلس النيابي.
IPU, The parliamentary mandate: a global comparative study. Inter parliamentary union. Geneval, 2000, 92
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادتان: 7 و 8 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة
14 )أ(
آخر. كأي مواطن نفسها والسياسية المدنية بالحقوق المشترع يتمتع المواطنين، بقية مع المشتركة حقوقه بجميع المشترع يتمتع وعليه،
وباألخص أمام المجالس القضائية.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، المادة 23)3( األدنى الحد ،C131 الدولية العمل منظمة
لألجور اتفاقية تحديد المستويات، 1970
على الهيئة التشريعية توفير مرتبات عادلة ومناسبة لجميع المشرعين باإلضافة إلى البنية التحتية المناسبة.
،29 رقم المعاهدة الدولية، العمل منظمة خرة ، المادة 2 )2( اتفاقية العمل بالس
للمشترع الحق في تقديم استقالته
ندوة األوروبي، والتعاون األمن منظمة والحكم الديموقراطية المؤسسات عن الديموقراطي، وارسو، 14 أيار/مايو 2004
المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة للهيئات التشريعية الديمقراطية، الفقرة2.1.1
للسلطة التشريعية فقط الحق في تعديل أنظمتها وقوانينها
المعايير للكومنولث، البرلمانية الرابطة للهيئات التشريعية الديمقراطية الفقرة 2.2.1
على المجلس النيابي االجتماع بفترات منظمة وكافية من أجل السماح هذه وعلى المطلوبة. بمهماتهما القيام تشريعية ووحدة مشترع لكل تطويل أي الستبعاد وهذا اللزوم، من أكثر تطول ال أن الدورات
للعملية التشريعية.
التدابير الالزمة في حال اضطرت التشريعية أن تضع على السلطة إلى االنعقاد في دورات استثنائية.
تحديد ، بشكل واضح ودقيق، الحاالت التي تتمكن من خاللها السلطة التنفيذية من دعوة المجلس النيابي إلى االجتماع.
للمشترع الحق بالتصويت من أجل تعديل جدول أعمال االجتماع.
127 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
للمشترع الحق بتقديم اقتراحات لقوانين، باإلضافة إلى تقديم تعديالت على القوانين المقترحة.
على الهيئة التشريعية إبالغ أعضاء مجلس النواب والمواطنين مسبقا عن أوقات االجتماعات، ومحتوى جدول األعمال.
إعالن وارسو النهائي أن تكون شفافة من أجل ضمان المشترع واآلليات االشتراعية على حسن المساءلة.
توصيات للكومنولث، البرلمانية الرابطة دراسة مطلقة خالصة ديموقراطية أجل من البرلمان عن للكومنولث البرلمانية الرابطة
واإلعالم، الفقرة 8.4اإلنساني البعد كوبنهاغن عن اجتماع مستند
لندوة األمن والتعاون األوروبي، الفقرة 7.4
يجب أن تكون لوائح الحضور ونتائج التصويت داخل المجلس متوافرة للمواطنين لضمان الشفافية.
الرأي واطالع المغلقة، الجلسات في التصويت نتائج تدوين يتم أن العام على نتائجها.
للمشترعين فقط الحق قي التصويت داخل المجلس النيابي.
على أعضاء المجلس النيابي أن يختاروا و/أو ينتخبوا أعضاء الهيئات التشريعية ورؤساء اللجان النيابية بحسب النظام الداخلي للمجلس.
من حق المشترع تأسيس لجان نيابية دائمة أو مؤقتة.
على المشترع انتخاب رؤساء اللجان بشكل شفاف.
كل اللجان لديها الحق في تقديم تعديالت على القوانين.
لكل اللجان الحق في طلب استشارة اختصاصي.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 20 إعالن وارسو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 22 الرابطة البرلمانية الدولية، المادة 12
للمشترع الحق في حرية تكوين الجمعيات.
، والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 22)2(
مع متناسبا يكون أن يجب السياسية األحزاب شرعية على قيد أي أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إعالن وارسو العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية
والثقافية، المادتان: 7 و 8
مفتوح النيابي المجلس حرم أن من التأكد التشريعية السلطة على للمواطنين واإلعالم بشكل آمن.
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادة 25
على السلطة التشريعية القيام بجميع الخطوات المناسبة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة: ممرات خاصة أو حتى تسهيالت للصم والبكم.
أي تصميم لقانون االنتخابات يجب أن يأخذ باالعتبار: ضمان صحة التمثيل للمجموعات واألقليات،
وضمان التعاون بين جميع الفئات.
على مصممي النظام االنتخابي أن يأخذوا باالعتبار األقليات الموجودة في البالد: األعداد؛ والتوزع الجغرافي؛ واللغات المستعملة؛ ونسبة األمية.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين128
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المادتان: 1و 2
على مصممي القانون االنتخابي أن يأخذوا باالعتبار: حق جميع األقليات في الوجود واالعتراف بهم
حق كل فرد في حرية اختيار الهوية، وعدم تحمل معاناة هذا القرارحق المجموعات في ممارسة طقوسها الدينية ونشاطاتها الثقافية بحرية.
حق المشاركة في اتخاذ القرارات من دون أي تمييز أو تهميش.
أن تضع الممكن التي من االنتخابية األنظمة النظر في جميع إعادة عوائق تمييزية على األقليات وممثليها.
وضع تدابير تمثيلية خاصة لضمان التعاون بين األقليات والمجموعات االجتماعية. وأن تضمن هذه التدابير التمثيل والتعاون في مجتمعات
ما بعد الحرب.
والسياسية، المدنية للحقوق الدولي العهد المواد: 1و 2 و 25
االنتخابات واالستفتاءات هي لضمان حق تقرير المصير لألقليات.
، والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد المواد: 1و 2 و 25
وهذا االنتخابية، العملية في االشتراك المجتمع أعضاء جميع على أيضا لضمان حقوقهم االقتصادية؛ واالجتماعية؛ والسياسية؛ والثقافية.
، والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد المواد: 9،17،25
المواد: اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن 3،7،21
مالحظات األمم المتحدة العامة 25، الفقرتان: 9و 11
مستند كوبنهاغن الفقرة 7.7
ضمان سالمة المرشحين من اإلكراه؛ والعقاب؛ والتخويف؛ والعنف. حرية ضمان أجل من للمواطن الحقوق هذه ضمان إلى باإلضافة
االنتخاب.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، المادة 13 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، المادة 12
الحق في التنقل بحرية لبناء الدعم االنتخابي
OSCE ODIHR, Restrictions on Political Parties in the Election
Process: OSCE Human Dimension Background
;)Paper 7 )October 1998
عدم وضع قوانين وإجراءات تعسفية تمنع المواطنين والمرشحين من المشاركة في العملية االنتخابية.
UN General Comment 25Paragraph 19
تحديد قيمة اإلنفاق االنتخابي، وهذا لضمان عدم تأثر المقترع باإلنفاق.
Copenhagen Documentparagraph 7.8
ICCPR article 19 UDHR Article 19 UN General Comment 25,
paragraph 25
االنتخابي، وتمكين الدعم التنقل، وجمع الحكومة ضمان حرية على المرشحين من إعالن مشاريعهم االنتخابية.
التعليق العام رقم 31 الفقرة 8 على الحكومات وضع قوانين وتنظيمات تضمن المحاسبة والمالحقة القانونية لألفراد والمرشحين الذين يسعون لعرقلة العملية االنتخابية.
129 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
امللحق 2قوانني االنتخابات: اخلطوط العريضة
أوال: قانون االنتخابات للعام 1943
يتكون مجلس النواب من 55 عضوا. كل محافظة تعتبر دائرة انتخابية )خمس محافظات(. المرشح لالنتخابات يجب أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره،وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة. الناخب يجب أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره. منع الجمع بين النيابة والوظائف العامة أو الدينية متى كان أصحابها يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة. الدورة في المقترعين أصوات نصف من أكثر على المرشح ووجوب حصول دورتين، على االنتخابات إجراء
األولى، واالكتفاء بالغالبية النسبية في الدورة الثانية.وجوب إجراء إحصاء عام للسكان في مدة ال تتجاوز السنتين.
ثانيا: قانون االنتخابات للعام 1950
رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 77 عضوا. اعتبار المحافظة دائرة انتخابية باستثناء المحافظات التي بلغ عدد المقاعد فيها 15 فإنها تقسم إلى أكثر من دائرة
انتخابية. وعلى هذا األساس قسمت كل من محافظتي جبل لبنان ولبنان الشمالي إلى ثالث دوائر بحيث أصبح لبنان مقسما الى تسع دوائر.
السن المطلوبة للمرشح بقيت 25 سنة، وكذلك شرط اإللمام بالقراءة والكتابة. ولكن القانون نص، للمرة األولى، على عدم جواز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية اال بعد انقضاء خمس سنوات على تجنسه.
السن المطلوبة ما تزال 21 عاما. عدم الدمج بين النيابة والوظائف العامة أو الدينية. اشتراط اإليداع في صندوق الدولة مبلغ خمسة آالف ليرة اللبنانية ال يعاد إلى المرشح لالنتخابات، إال إذا نال %15
من أصوات المقترعين.اإلبقاء على نظام الدورتين، واعتبار المرشح الذي ينال العدد األكبر من األصوات فائزا بشرط أال يقل هذا العدد عن
40% من أصوات المقترعين في الدورة األولى، وعدم السماح للمرشحين الذين ينالون أقل من 15% من األصوات في الدورة األولى من التقدم إلى الدورة الثانية.
ثالثا: قانون االنتخابات للعام 1952
تخفيض عدد المقاعد في مجلس النواب إلى 44 بحجة رفع مستوى التمثيل الشعبي. اعتماد الدائرة االنتخابية الفردية المصغرة، وتقسيم لبنان إلى 33 دائرة. منح المرأة اللبنانية البالغة من العمر 21 سنة حق االنتخاب، مع اشتراط حيازة شهادة التعليم االبتدائي أو شهادة
مدرسية تثبت أن حاملتها درست دروسا توازي منهاج شهادة التعليم االبتدائي. غير أن مرسوما اشتراعيا صدر في 1953/2/18؛ أي قبل إجراء االنتخابات، ألغى اشتراط حيازة الشهادة للمرأة.
جعل االقتراع إجباريا، ومعاقبة كل من يتخلف عن الواجب دون عذر مشروع بغرامة تتراوح بين 50 و 100 ليرة لبنانية. غير أن المرسوم االشتراعي المذكور استثنى اإلناث من ذلك.
الدينية. أو العامة والوظائف النيابة بين الجمع وعدم المرشح، وسن الناخب بسن المتعلقة الشروط على اإلبقاء والقوانين االنتخابية الالحقة لم تدخل عليها أي تغيير.
تخفيض مقدار الكفالة المالية وجعلها ثالثة آالف ليرة ال تعاد إال إذا نال المرشح 20% من األصوات على األقل.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين130
إلغاء الدورة الثانية، واالكتفاء بدورة واحدة في االنتخابات، واعتبار المرشح الذي ينال العدد األكبر من أصوات المقترعين فائزا.
االنتخابات تجري في يوم واحد لجميع الدوائر، غير أنه أجاز تعيين موعد خاص لكل محافظة اقتضت ذلك سالمة األمن. وبما أن هذا التعبير مطاطي؛ فقد قرر المسؤولون، منذ ذلك التاريخ، وبشكل اعتباطي، أن سالمة األمن ال
تسمح بإجراء االنتخابات في يوم واحد.
رابعا: قانون االنتخابات للعام 1957
رفع عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 66 عضوا. جعل لبنان 27 دائرة انتخابية. اإلبقاء على الشروط المتعلقة بسن الناخب والمرشح، ومقدرا الكفالة المالية، وعدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة،
وإجراء االنتخابات في يوم واحد إال إذا اقتضت سالمة األمن خالف ذلك.رفع المدة الزمنية التي يجوز بعد انقضائها انتخاب المتجنسين إلى عشر سنوات بدال من خمس. تطبيق نظام الدورة االنتخابية الواحدة، وفوز المرشح الذي ينال العدد األكبر من األصوات، وفوزاألكبر سنا عند
تساوي األصوات.إلغاء العقوبة المالية لمن يتخلف عن التصويت لعدم النص عليها.
خامسا: قانون االنتخابات للعام 1960
رفع عدد النواب إلى 99 عضوا. جعل لبنان 26 دائرة انتخابية بعد تقسيم المحافظات الخمس إلى دوائر. اإلبقاء على الشروط المتعلقة بسن الناخب والمرشح، وعدم الجمع بين النيابة والوظيفة، وإجراء االنتخابات في يوم
واحد إال إذا حالت سالمة األمن دون ذلك. اإلبقاء على مقدار الكفالة المالية، وإدخال تعديل طفيف على عدد األصوات التي يجب أن ينالها المرشح لتعاد إليه
الكفالة، فقد أصبح عليه أن ينال 25% من األصوات على األقل.إدخال مبدأ االقتراع بالبطاقة االنتخابية إلى النظام االنتخابي في لبنان، وذلك للمرة األولى.غير أن القانون نفسه نص
على أال يعمل بالبطاقة في أول انتخابات نيابية تلي صدوره.اللبناني، النظام االنتخابي إلى انتخاب، العازلة، أوالمعزل، في كل مركز إدخال نظام االقتراع السري، أوالغرفة
وذلك للمرة األولى كذلك.تطبيق نظام الدورة االنتخابية الواحدة على األسس ذاتها التي حددها القانون السابق.
سادسا: قانون االنتخابات للعام 1992
رفع عدد األعضاء إلى 128 عضوا. طبقت معايير مختلفة في ما يتعلق بتوزيع الدوائر في االنتخابات. ففي الجنوب دمجت محافظتا: الجنوب؛ والنبطية
في دائرة انتخابية واحدة، وجعلت كل من محافظة بيروت؛ ومحافظة لبنان الشمالي دائرة واحدة. وتم اعتماد القضاء ليكون دائرة انتخابية في جبل لبنان، والبقاع.
سابعا: قانون االنتخابات للعام 1996
أصبحت المحافظة دائرة انتخابية في كل من محافظات: بيروت؛ والبقاع؛ والشمال. وتم دمج محافظتي: الجنوب؛ والنبطية في دائرة واحدة ، وجعل القضاء دائرة انتخابية في جبل لبنان.
131 جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين
ثامنا: قانون االنتخابات للعام 2000
تقسيم لبنان إلى 14 دائرة انتخابية. اعتبار الدائرتين االنتخابيتين في الجنوب دائرة واحدة، وهذا بسبب األوضاع االستثنائية في تلك المنطقة. االنتخابية البطاقة االنتهاء من وضع لحين وذلك القانون، هذا تاريخ بعد التي ستجري االنتخابية البطاقة اعتماد
الموحدة لالنتخابات.هذا القانون لم يعتمد اإلقليم اإلداري الثابت و ال الوحدات اإلدارية داخل المحافظة )األقضية(، و لم يعمد إلى إنشاء
وحدات إدارية جديدة مقسمة بشكل موضوعي.
تاسعا: قانون االنتخابات للعام 2005
استخدم قانون العام 2000 وهذا بسبب ضيق الوقت، وانحسار السلطة السياسية في ذلك الحين بعد أحداث شباط العام 2005 وما تبعها من ظروف وأحداث.
هذه في ستفصالن اذ والنبطية( )الجنوب؛ الجنوب: بدائرتي يتعلق وحيد تعديل مع مجددا نفسه 2000 قانون ففرض االنتخابات؛ ألن قانون2000 نص على دمجهما »استثنائيا ولمرة واحدة فقط«.
عاشرا: قانون االنتخابات للعام 2009
اعتمد هذا القانون على تقسيم الدوائر االنتخابية إلى دوائر صغرى على أساس القضاء بصوره مشابهه لقانون االنتخابات الذي عمل به العام 1960 ، باإلضافة إلى احتواء القانون على إصالحات أخرى، مثل: إجراء االنتخابات بجميع الدوائر في يوم واحد بدال من أن تجرى، كما السابق، في أربعة أسابيع متتالية؛ ومراقبة حجم اإلنفاق لكل مرشح؛ وإنشاء هيئة متخصصة لإلشراف على مراقبة هذه اإلصالحات. إال أن القانون لم يأخذ باإلصالحات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قانون االنتخاب، إذ إنه لم يقر تخفيض سن االقتراع إلى 18 عاما وأبقى على سن 21، وألغى كذلك إقرار الورقة الموحدة للمرشحين التي يفترض أن تقلص من احتماالت التزوير، كما رفض إعطاء العسكريين حق المشاركة في التصويت والذي برر بالرغبة في إبعاد الجيش عن االنقسامات الداخلية، كما أرجأ القانون مشاركة المغتربين بالتصويت إلى انتخابات العام 2013.
جدلية حقوق اإلنسان يف قانون االنتخاب اللبناين132
قائمة املصادر
باتريك مرلو، الترويج ألطر قانونية لديمقراطية االنتخابات، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2008
بشارة الخوري، حقائق لبنانية.أوراق لبنانية، لبنان ، 1960
البطريرك مار نصرهللا بطرس صفير خالل افتتاح مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان، جريدة النهار، 11 كانون األول/ ديسمبر 2001
تقرير األمين العام، A/46/609 و Corr.1،الفقرة 76.
جريدة النهار،21 أيلول/سبتمبر 2000
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات 2011، "الدليل التدريبي حول االنتخابات"
الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي "كتيب اإلصالحات"
الدستور اللبناني المقدمة والمواد: 8 و12 و13 و24
غسان مطر، جريدة اللواء، 17 كانون الثاني/يناير 1999
Pluto Press,2007 ،فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث
القانون رقم 25 من القانون االنتخابي، الجمهورية اللبنانية، 2008، المواد: 10،9،8،7
قرار الجمعية العامة 137/46 المؤرخ في 17 كانون األول/ديسمبر 1991، الفقرة 3.
أفضل - االنتخابات لديموقراطية عملي دليل ديمقراطية: انتخابات في بالحق المتعلقة العالمية واإللتزامات القيم الممارسات، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2002
كتيب لالتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، االتحاد األوروبي، 2008
الكوتا الجندرية في األنظمة االنتخابية وتطبيقها في أوروبا ، البرلمان األوروبي، 2008
محمد المجذوب، القانون الدستوري و النظام السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2002
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، 2007، نحو تطوير المعايير الدولية لديمقراطية تشريعية
مملكة بلجيكا - االنتخابات االتحادية، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2007
نحو مجتمع ديمقراطيات - المؤتمر الوزاري ، إعالن وارسو النهائي ، 2000
نشر التقرير في جريدة النهار،23 كانون الثاني/يناير 2001.
وزارة الداخلية اللبنانية 2012، مشروع قانون االنتخابات النيابية للعام 2013
Al Hindy E. 2009, Self Determination for minorities: An Arab Perspective,unpublished PhD Thesis, University of Sydney
Giovanni Allegretti, Participer, mais comment, Le Monde Diplomatique,Septembre 2012
دراسة حول
وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومــدى االلتـــزام بتنفـــيذ اتفاقيــــــة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
في كل من: مصر؛ ولبنان؛ وتونس؛ واألردن
الباحث الرئيسي : د. نواف كبارة
الباحثان المساعدان : أ. جهدة أبو خليل و أ. حسن يوسف
135 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الئحة احملتويات
137المقدمة
139التشريعات الخاصة باإلعاقة في الدول المشمولة بهذه الدراسة، ومدى تطابقها مع بنود االتفاقية الدولية
139حول تعريف اإلعاقة )المادة األولى من االتفاقية(
139حول مبدأ المساواة وعدم التمييز )المادة الخامسة(
140النساء ذوات اإلعاقة )المادة السادسة(
140األطفال ذوو اإلعاقة )المادة السابعة(
140 إذكاء الوعي )المادة الثامنة(
141إمكانية الوصول )المادة التاسعة(
141الحق في الحياة )المادة العاشرة(
141حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية )المادة الحادية عشرة(
141األهلية القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء )المادتان: الثانية عشرة؛ والثالثة عشرة(
141حرية الشخص وأمنه )المادة الرابعة عشرة(
عدم التعرض للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او الال إنسانية أو المهينة أو االستغالل أو العنف أو االعتداء ) المادتين الخامسة عشرة و السادسة عشرة (
142
142حماية السالمة الشخصية )المادة السابعة عشرة(
142حرية التنقل والجنسية )المادة الثامنة عشرة(
142العيش المستقل؛ واالدماج في المجتمع؛ والتنقل الشخصي )المادتان: التاسعة عشرة؛ والعشرون(
142حرية التعبير والرأي؛ والوصول إلى المعلومات )المادة الواحدة والعشرون(
142احترام الخصوصية ؛ والبيت؛ واألسرة )المادتان: الثانية والعشرون؛ والثالثة والعشرون(
142التعليم )المادة الرابعة والعشرون(
143الصحة؛ والتأهيل؛ وإعادة التأهيل )المادتان؛ الخامسة والعشرون؛ والسادسة والعشرون(
143العمل والعمالة )المادة السابعة والعشرون(
143مستوى المعيشة الالئق؛ والحماية االجتماعية )المادة الثامنة والعشرون(
144المشاركة في الحياة السياسية والعامة )المادة التاسعة والعشرون(
144المشاركة في الحياة الثقافية؛ وأنشطة الترفيه و التسلية؛ والرياضة )المادة الثالثون(
144الجهات الرسمية المعنية بشؤون اإلعاقة
145جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة ودورها في الترويج لإلتفاقية
146اقتراحات ألي تدخالت مستقبلية محتملة
147الملحق رقم 1
149الملحق 2
137 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
املقدمة
القرن ثمانينيات من بدءا المفاهيم، في ثورة عرفت أنها عالمية، قضية بوصفها اإلعاقة مراجعة وضع في ضوء يتضح الماضي، وذلك عندما تبنت األمم المتحدة القواعد المعيارية الموحدة، وأعلنت العقد الدولي للمعوقين واإلعاقة )1983 ـ 1992 ( فاستجد للمرة األولى في تاريخ قضية اإلعاقة تحول في المقاربة من نموذج الرعاية الطبية، الذي كان سائدا في مستهل القرن العشرين، إلى نموذج أو مثال جديد قائم على الحقوق؛ والدمج؛ والمساواة. وقد صيغت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتكون وثيقة قائمة على مبدأ الحقوق. لكن، وبعد ما يزيد على ستة أعوام على إعالن االتفاقية، تتخلف معظم الدول العربية عن تنفيذها. والواقع أن الكثير من هذه البلدان ما تزال تعتمد المقاربة الرعائية والطبية في التعامل مع جميع الشؤون
المتعلقة بسياسة اإلعاقة.
وقد سبق ذلك خوض العديد من دول العالم المعنية بحقوق اإلنسان، وبخاصة الحقوق االقتصادية؛ واالجتماعية؛ والتنموية؛ والثقافية، نضاال مريرا لسنوات عدة بدءا من منتصف التسعينيات، لطرح اتفاقية دولية جامعة لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتواصلت المحاورات والمناقشات لسنوات عدة حتى كانون األول/ ديسمبر2006، وهي السنة التي أعتمدت فيها أيار/ في التنفيذ حيز ودخلت 30 آذار/مارس2007 عليها في التوقيع باب اإلعاقة، وفتح حقوق األشخاص ذوي اتفاقية
مايو2008.
وعليه؛ وجدت دول العالم نفسها منذ ذلك التاريخ أمام استحقاقات دولية أقرتها االتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 154/64، ومطالبة األمين العام لألمم المتحدة بتقديم تقرير عن حالة االتفاقية، والبروتوكول االختياري الملحق الوطنية، وإصدار القوانين لمراجعة وإجراءات تدابير التخاذ البلدان من كبير عدد رصد توجه إذ تنفيذها، وموضع بها، لتنفيذ وطنية تنسيق منظمات أو مراكز الى إنشاء الدول واالتفاقية وتتوافق معها. كما عمدت هذه تتواءم جديدة تشريعات
االتفاقية بصورة أشمل، أو دفع الدول للتصديق عليها وعلى ملحقاتها.
كما تضمنت التحركات واللقاءات الدولية العمل على ما يلي:
أوال: اتخاذ تدابير تشريعية لتنفيذ االتفاقية.
ثانيا: إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم في إطار تنفيذ االتفاقية، وذلك في مؤتمرات الدول األطراف التي تعقد في األمم المتحدة، وفي إقرار اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وانتخابها.
وعليه، ومن خالل هذه التحركات واألنشطة واآلليات المستخدمة في أعلى هيئة دولية، أصبحت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD( واحدة من أدوات حقوق اإلنسان، إلى جانب المواثيق الدولية الحقوقية األخرى، إذ ألحقت االتفاقية جميع
القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة إلى المرجعية الحقوقية وإحدى قضايا حقوق اإلنسان.
من دولة، تاريخه 118 حتى عليها التي صادقت والتنفيذ، للتصديق االتفاقية بعد طرح التوجه فاعال ونافذا هذا وليكون بينها 13 دولة عربية، وبعد مرور ستة أعوام على دخولها حيز التنفيذ؛ فإنه يتوجب على الدول المصدقة على االتفاقية تقديم
تقرير حول تنفيذها.
ثقافتهما تطوير أو حديثة عالمية مفاهيم البحث عن والخبراء المدني المجتمع منظمات على األساس، توجب هذا وعلى ومعلوماتهما حول هذا الموضوع، وذلك من خالل طرح نماذج قانونية تساعد على تطوير التقارير الدورية المقدمة حول تنفيذ والمبادرة الدولية )IDA(لإلعاقة التحالف الدولي من جانب عدة دولية هذا اإلطار، معايير وصيغت في االتفاقية.
لتحفيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)DRPI( بوصفها نماذج تستخدم آليات للمتابعة الدورية ألعمال االتفاقية.وقد استفادت العديد من الدول والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال اإلعاقة من هذه النماذج في تهيئة وتفعيل البيئة
التشريعية المحلية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة138ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وتركز هذه الدراسة على رصد أداء بعض الدول العربية، وليس جميعها )ألسباب فنية ومالية مرتبطة بالدراسة المقدمة( التي وقعت أو صدقت على االتفاقية، إذ تشمل الدراسة مراجعة القوانين واللوائح الموجودة حاليا، إلى جانب السياسات المتعلقة
باإلعاقة في هذه الدول.
وتتمثل األهمية العلمية والموضوعية للدراسة في أنها:
دراسة متخصصة تتم وفقا لمنهج المقاربة الحقوقية لقضية اإلعاقة من منظور اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 1دراسة رصدية معنية برصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة داخل محيط الدول والفئة المستهدفة.. 2اإلنسانية؛ . 3 والكرامة والحرية؛ بالعيش؛ المناداة شعارات لتحقيق العربي الربيع ثورات لمطالب فورية استجابة
والعدالة االجتماعية؛ والمساواة لهذه الفئة )األشخاص ذوي اإلعاقة(.استجابة لمطالب الدول األطراف لالتفاقية إلعداد التقارير المعنية بتنفيذ االتفاقية، وإصدارها.. 4الدولية . 5 تنفيذ االتفاقية الموازية عن متابعة الدورية التقارير المدني، إلعداد المجتمع لمنظمات أداة جديدة ومهمة
باألمم المتحدة واللجنة المعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومجلس حقوق اإلنسان.وتهيئة . 6 وتنفيذها؛ االتفاقية؛ اإلعاقة، لتفعيل باألشخاص ذوي وقوانين خاصة مقترحات من إعداد المنظمات تمكن
البيئة القانونية الداخلية أمام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.تمكن من تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية التي تشملها الدراسة، ونقل التجارب المختلفة المنفذة.. 7
مجهودا تتطلب كافة العربية الدول تغطية أن العربي، ونظرا إلى اإلعاقة في العالم مدى االهتمام بقضية تقييم أجل ومن يتخطى اإلمكانيات المتوافرة لهذه الدراسة، فإن هذه الدراسة تقوم بتحليل هذا الواقع في بعض الدول العربية، وهي: لبنان؛
وتونس؛ واألردن؛ ومصر لتحديد مدى التزامها بتنفيذ بنود االتفاقية الدولية. وقد تم اعتماد هذه الدول لألسباب التالية:
أوال، يعد كل من األردن وتونس، أول دولتين عربيتين صادقتا على االتفاقية في العام 2006، وعليه يمكننا متابعة الجهود التي بذلت لتنفيذها.
وتغيير ثورة يعيشان حالة أيضا، وتونس، التي صادقت عليها العام 2008، االتفاقية أن مصر التي صادقت على ثانيا، كبيرين، ما يساعدنا على تقييم مدى شمول قضية اإلعاقة في هذه التغييرات.
وأخيرا؛ تم اختيار لبنان الذي وقع على االتفاقية العام 2007 ، لكنه لم يصادق عليها حتى اآلن، كون القانون اللبناني الصادر في العام 2000 يعد من أكثر القوانين العربية تقدما في مقاربة القضية من موقع حقوقي.
ومن أجل إجراء تقييم مركز، سيعتمد البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية:
هل هناك تشريعات شاملة للتعامل مع قضية اإلعاقة؟ وهل تنسجم هذه التشريعات مع روح االتفاقية الدولية وبنودها ؟. 1من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات المتعلقة باإلعاقة في الدول المعنية ؟وهل هي جهة تقريرية أو استشارية؟. 2ما هو حجم االلتزام بتنفيذ قوانين اإلعاقة في الدول المشمولة في هذه الدراسة؟ وما هو دور أصحاب القضية في اتخاذ . 3
القرار؟ وهل هناك اتحادات تمثل األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى الدولة؟ وهل هذه االتحادات هي منتخبة أو معينة؟ وما هو دورها في الدفع لوضع االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة موضع التنفيذ؟
اإلعاقة، حقوق األشخاص ذوي بنود اتفاقية مقارنة تحليلية بين هذه التساؤالت، ستقوم الدراسة بتقديم كل عن ولإلجابة
والتشريعات المعتمدة من جانب الدول المشمولة في هذا البحث.
139 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التشريعات اخلاصة باإلعاقة يف الدول املشمولة بهذه الدراسة، ومدى تطابقها مع بنود االتفاقية الدولية:
الخاصة كانت القوانين لبنان، من وتوقيعها ومصر، جانب: األردن؛ وتونس؛ من الدولية االتفاقية المصادقة على قبل هذه في اإلعاقة بشأن التشريع للقضية. ويتفاوت والطبية الرعائية المقاربة لبنان، تعتمد الدول، باستثناء هذه باإلعاقة في الدول من دولة إلى أخرى. فبعض الدول أقرت قوانين جزئية تعود إلى السبعينيات، مثل مصر، بينما قام كل من :األردن؛ وتونس؛ ولبنان بسن قوانين تعود إلى ما قبل صدور االتفاقية. ويظهر الجدول التالي بوضوح وضع اإلعاقة قبل المصادقة
على االتفاقية الدولية وبعدها
الدولة قبل االتفاقية بعد االتفاقية
تونس قانون رقم 46 لسنة 1981 للنهوض بالمعاق وحمايته، الذي تم
تعديله بالقانون التوجيهي 83 للعام 2005 للنهوض باألشخاص المعوقين.وحمايتهم
األردن قانون رعاية المعوقين رقم 12 سنة 1993م قانون 31 للعام 2007 المتعلق
.بحقوق األشخاص المعوقينلبنان القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق األشخاص المعوقين
مصر
القانون رقم 39 تاريخ 6/24/ 1975 بشأن تأهيل المعوقين والقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن حماية المعوقين العاملين، وقانون الطفل المصري رقم 12 السنة 1996 المواد من 75 ـ 86 وقانون الضمان 87 لسنة 2000 والقانون
2004 الخاص بالتسهيالت الهندسية في المباني العامة
العمل جار حاليا على مشروعقانون جديد حول اإلعاقة
وبهدف تحليل مدى تقارب هذه التشريعات مع بنود اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ال بد من إجراء مقارنة بين بنود هذه االتفاقية وتشريعات الدول التي تشملها هذه الدراسة التي خلصت إلى التالي:
حول تعريف اإلعاقة )المادة األولى من االتفاقية(:
المساواة مع قدم بالتمتع، وعلى يتمثل بضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي المادة األولى من االتفاقية غرضها تحدد اآلخرين، بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وقد عرفت هذه المادة األشخاص ذوي اإلعاقة بأنهم كل األشخاص ذوي اإلعاقات: العقلية؛ والجسدية؛ والحسية؛ والذهنية، الطويلة األجل، التي قد تحول، في ضوء التعامل مع الصعوبات المختلفة، دون مشاركة هؤالء األشخاص الفعلية في المجتمع. وفي مراجعة تعريفات اإلعاقة في قوانين الدول المشمولة في هذه الدراسة؛ يظهر بوضوح اقتصار تعريف اإلعاقة في قوانين: تونس؛ واألردن؛ ولبنان، على النظرة الطبية لألشخاص ذوي
اإلعاقة. أما في مصر؛ فليس هناك أي تعريف لها في ظل غياب قانون خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.
حول مبدأ المساواة وعدم التمييز )المادة الخامسة(:
باالستفادة الحق لهم كما تضمن القانون، أمام المساواة اإلعاقة لجميع األشخاص ذوي االتفاقية الخامسة من المادة تضمن وتطالب اإلعاقة، أساس على التمييز أشكال جميع المادة هذه تمنع كما القانون. يوفرها التي كافة والفوائد الحماية من بتأمين الترتيبات التيسيرية المعقولة لهؤالء األشخاص. وإذا ما راجعنا الدساتير والقوانين المعتمدة في الدول المشمولة في هذه الدراسة، يتبين أن دساتير الدول األربع تؤكد على المساواة الكاملة لمواطني هذه الدول أمام القانون، ومن ثم أن ال تكون اإلعاقة عامال تمييزيا على الصعيد الدستوري. فتونس مثال، يوجد لديها دستور عام يؤكد على المساواة بين المواطنين، إال أن القانون رقم 2005/83 الخاص باإلعاقة يؤكد على تكافؤ الفرص، ومنع التمييز، كما يجرم في حال التمييز القائم على اإلعاقة ) القانون التونسي، المادة األولى( .أما في لبنان؛ فيؤكد الدستور اللبناني على المساواة بين اللبنانيين، لكن ال يوجد نص قانوني أو رسمي يمنع أو يدين الذين يمارسون التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، كما لم يعرف القانون رقم 220/2000
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة140ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
في أما تعرضهم للتمييز. حال دعاوى في رفع من اإلعاقة تمكنان األشخاص ذوي مادتين التمييز، ولكنه يتضمن مفهوم الحالة األردنية؛ فقد جاء في الدستور األردني أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. كما يعرف القانون األردني حول أو الحقوق من ألي اإلعاقة مرجعه إنكار أو استبعاد او إبطال أو تقييد حد أو كل أنه على 2007 التمييز اإلعاقة للعام الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وفي غياب أي تشريع في مصر حول اإلعاقة، فليس هناك من مستند يمكن اعتماده لمقاربة الموضوع، علما أن مشاريع القوانين المقترحة حول اإلعاقة حاليا في مصر تستند إلى مبدأ عدم التمييز.
النساء ذوات اإلعاقة )المادة السادسة(:
والجمعيات بالقضية، الحكوميين المعنيين اهتمامات عن غائبة تزل اإلعاقة لم ذوات المرأة من قضية أن األمر واقع عقدته الذي المؤتمر أظهر فقد أنفسهم. اإلعاقة ذوي جمعيات األشخاص وحتى واإلقليمية، النسائية الوطنية واالتحادات المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية في القاهرة خالل شهر تموز/ يوليو من العام 2006، أن هذا الموضوع ينقصه الكثير من الجهد إلظهار خصوصيته ضمن إطار قضية اإلعاقة بشكل عام، خصوصا في ضرورة تفعيل وعي المرأة من ذوات اإلعاقة بقضيتها، وكذلك التزام جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة والجمعيات النسائية
بالموضوع.
يمكن اعتبار القانون األردني للعام 2007 القانون الوحيد الذي يشير إلى رفض أي تمييز على أساس الجنس، بينما ال يوجد أي إشارة في تشريعات الدول الباقية إلى خصوصية وحقوق النساء ذوات اإلعاقة.
األطفال ذوو اإلعاقة )المادة السابعة(:
ال يختلف واقع الطفل من ذوي اإلعاقة عن حالة محور المرأة من ذوات اإلعاقة من ناحية غياب االهتمام الجدي بالموضوع، باستثناء أن قضية الطفل من ذوي اإلعاقة تعكس واقع قضية اإلعاقة بشكل عام. والحقيقة أن القضيتين الرئيسيتين في موضوع الطفل من ذوي اإلعاقة هما: الصحة؛ والتربية. فعلى الصعيد األول؛ ال يختلف الواقع عما هو مطروح في محور الصحة. أمأ على الصعيد التربوي؛ فإن إخفاق الكثير من الدول في تنفيذ مضمون محور التربية من ناحيتي: اعتماد سياسات الدمج ثم ومن المدرسي، الدمج اإلعاقة فرصة ذوي من الطفل يفقد بالموضوع، متخصصة وزارية وحدات وإنشاء المدرسي؛ االجتماعي، ويضعه أمام خيارين: إما الدخول إلى مدارس مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة فقط؛ أو أن يفقد الحق في التعلم. وال بد من اإلشارة هنا إلى أن هناك اتفاقا كامال ما بين جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة حول دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية والبصرية، بينما لم يزل النقاش مفتوحا حول الدمج في ما يختص باإلعاقتين السمعية والفكرية. كما ال بد من اإلشارة العربي وبرامجها، وكذلك العالم بالطفولة في المعنية الجمعيات الطفل من ذوي اإلعاقة عن خطابات إلى غياب موضوع
محدودية االهتمام بهذا الموضوع من المؤسسات الدولية المعنية بموضوع الطفولة، مثل »اليونيسف«.
المادة تؤكد اإلعاقة، إذ ذوي األطفال وحقوق إلى خصوصية الذي يشير الدول قوانين بين القانون األردني الوحيد ويعد الثالثة منه على أهمية ضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، وبناء قدراتهم وتنميتهم، دون ذكر أي تفاصيل وحقوق معينة في هذا الخصوص. ويمكن اعتبار أن حقوق الطفل من ذوي اإلعاقة محصورة بما يتعلق بالموضوع التربوي، إذ تنص القوانين في كل من: تونس؛ ولبنان؛ واألردن على حق الطفل من ذوي اإلعاقة في الوصول إلى التعليم والمعرفة ضمن إطار المنظومة
العادية للتعليم.
إذكاء الوعي )المادة الثامنة(:
يكتفي القانون التونسي بتحفيز اإلعالم للمساهمة في خطة وطنية للوقاية من اإلعاقة، لكنه ال يتضمن أي بند يتناول فيه دور الدولة في تغيير المفاهيم الموروثة والسلبية حول اإلعاقة، وكذلك هو الحال في القانون اللبناني. إال أن هذين القانونين يلحظان ضرورة إدراج اإلعاقة ضمن مادة تدريسية في المعاهد التربوية. ويمكن اعتبار هذه المادة في القانونين مساهمة في تغيير النمط السلبي حول اإلعاقة في المجتمع. أما االستراتيجية الوطنية في األردن لألعوام 2010-2015؛ فتتضمن محورا خاصا
حول اإلعالم؛ والتثقيف؛ والتوعية.
141 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اإلعاقة. إلى النظرة في التحول مسار في المضيئة القليلة المؤشرات من هي واإلعاقة اإلعالم قضية إن القول؛ ويمكننا فمن الغياب شبه الكلي حول الموضوع في وسائل اإلعالم المختلفة إلى التعاطي مع الموضوع من موقع الشفقة والخير، إلى التي نظمتها التوعية والضغط إلى حمالت لهذا التحول يعود الرئيسي الحقوق. ولعل السبب القضية من موقع التعامل مع جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة إما مباشرة مع الصحفيين، أو عن طريق نزولهم إلى الشارع دفاعا عن قضيتهم، ما حدا
بوسائل اإلعالم إلى االهتمام بالموضوع، وتغطية أخباره.
إمكانية الوصول )المادة التاسعة(:
تضمن التشريعات في الدول األربع حق األشخاص ذوي اإلعاقة في استعمال المرافق العامة، وذلك عن طريق فرض معايير هندسية لألبنية العامة. فباإلضافة إلى قوانين اإلعاقة في كل من: تونس؛ ولبنان؛ واألردن، أصدرت مصر في العام 2004 في تقتصر القوانين هذه أن إال الجسدية. اإلعاقة المطلوبة لألشخاص ذوي الهندسية والتسهيالت بالمعايير خاصا قانونا تفسيرها للتسهيالت البيئية على احتياجات اإلعاقات الجسدية. وعليه ليست هناك أية إشارة إلى ضرورة توحيد لغة اإلشارة، وتعميمها لمصلحة اإلعاقات السمعية. وكذلك األمر نفسه في ما يختص باإلعاقات البصرية، إذ ال توجد إشارة إلى حق أصحاب الحركة حرية وحول لذلك. المناسبة التكنولوجيا توفير في الدولة واجب وإلى المعلومات، إلى الوصول في اإلعاقة هذه والتنقل؛ فتشير القوانين في الدول الثالث إلى حق الشخص من ذوي اإلعاقة في الحصول على وسيلة نقل معفاة من الرسوم الجمركية. ويمكن اعتبار القانون 220 في لبنان الوحيد الذي يتضمن مواد تركز على تجهيز وسائل النقل العام لالستخدام من
جانب األشخاص ذوي اإلعاقة.
الحق في الحياة )المادة العاشرة(:
تكفل قوانين الدول األربع الحق في الحياة للمواطنين كافة، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، وتعاقب، دون تمييز، أي اعتداء على هذا الحق.
حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية )المادة الحادية عشرة(:
حاالت في اإلعاقة ذوي مع األشخاص التعامل كيفية إلى إشارة أو مواد أي األربع قوانين الدول في يوجد ال الكوارث، واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حماية سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في الظروف الخطرة والحاالت اإلنسانية
الطارئة.
األهلية القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء )المادتان: الثانية عشرة؛ والثالثة عشرة(:
ال تضمن القوانين في تونس؛ ولبنان؛ واألردن، األهلية القانونية، والحق في الوصول إلى القضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصا في ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واإلدارية.
حرية الشخص وأمنه)المادة الرابعة عشرة(:
يضمن القانون التونسي تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحق في الحرية والسالمة الشخصية على قدم المساواة مع اآلخرين. أما في لبنان؛ فلم تتطرق المادة التشريعية الوحيدة الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة في لبنان في القانون 220، مباشرة إلى هذا الموضوع، لكن التنفيذ الجدي ألحكام القانون التي تنص على االحترام الكامل والدقيق لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يضمن الثالثة إلى أهمية الحفاظ على المادة بصورة غير مباشرة تأمين حقهم في الحرية والسالمة الشخصية. وفي األردن؛ تشير
الحرية والسالمة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة142ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة او لالستغالل أوالعنف أواالعتداء)المادتان: الخامسة عشرة؛ والسادسة عشرة(
ال توجد في قوانين الدول الثالث أية إشارة مباشرة إلى حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من التعرض للتعذيب أو العنف؛ وإنما هناك تأكيد على دور الدولة في حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من كل أنواع االستغالل. إال أن هذا الحق مكفول لجميع مواطني
الدول التي وقعت على االتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب.
حماية السالمة الشخصية )المادة السابعة عشرة(:
هذه المادة هي األقصر في االتفاقية، لكن يمكن اعتبار أن قوانين الدول المشمولة في هذه الدراسة تتضمن هذه الحماية، بوصفها جزءا من الحماية التي يتمتع بها المواطن بشكل عام، إال أن قوانين اإلعاقة في هذه الدول لم تشر بوضوح إلى هذا الموضوع.
حرية التنقل والجنسية )المادة الثامنة عشرة(:
تتضمن القوانين في: تونس؛ ولبنان؛ واألردن؛ ومصر، تمتع األشخاص بحقهم في حرية التنقل، والحق في اكتساب الجنسية، دون تمييز بسبب اإلعاقة. لكن القوانين في تونس؛ واألردن ؛ ومصر، تخاطب المواطنين كافة، وليس األشخاص ذوي اإلعاقة مباشرة. بينما ينص القانون 220 في لبنان، صراحة على كفالة حرية التنقل وعلى الحق في اكتساب الجنسية لألشخاص
ذوي اإلعاقة، دون تمييز.
العيش المستقل؛ واالدماج في المجتمع؛ والتنقل الشخصي )المادتان: التاسعة عشرة؛ والعشرون(:
يمكن اعتبار أن القوانين كافة في الدول الثالث، تؤكد على الحق في الدمج والعيش بأكبر قدر من االستقاللية، كما تنص على ضرورة القيام بمجموعة إجراءات لضمان ذلك، مثل: الحق في السكن المستقل؛ والتنقل؛ والدمج التربوي... وغيرها.
حرية التعبير والرأي؛ والوصول إلى المعلومات )المادة الواحدة والعشرون(:
يعد هذا الحق مضمونا كما هو لبقية مواطني الدولة. فاالختالف بين دولة وأخرى يعود إلى درجة الحرية المعطاة للمواطن في دساتير هذه الدول. أما من ناحية الحق في الوصول إلى المعلومات؛ فاألمر يتعلق بتأمين المعلومات بلغة مقروءة من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، وتعميم لغة إشارة موحدة للصم. وإذا ما عدنا إلى قوانين اإلعاقة في الدول المشمولة بهذه
الدراسة ؛ فإننا ال نجد نصا رسميا حول هذا الحق.
احترام الخصوصية ؛ والبيت؛ واألسرة )المادتان: الثانية والعشرون؛ والثالثة والعشرون(:
يمكن اعتبار هذا الحق من الحقوق العامة لجميع المواطنين، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة. وبشكل عام، تكفل دساتير الدول هذا الحق دون وجود في القوانين الخاصة باإلعاقة أي إشارة لهذا الموضوع، ولكيفية ضمانه لألشخاص من ذوي اإلعاقة غير القادرين على ضمان استقاللية كاملة في حياتهم. إلى جانب ذلك، لم تتناول أي من قوانين الدول حق األشخاص ذوي اإلعاقة
في الزواج وبناء األسرة.
التعليم )المادة الرابعة والعشرون(:
ولبنان؛ تونس؛ قوانين تؤكد إذ الدراسة. بهذه المعنية الدول قوانين بين توافقا األكثر المواد المادة من اعتبار هذه يمكن واألردن على حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعلم، والحصول على المعرفة في مدارس دامجة مع بقية المواطنين والتالمذة. كما تضمن المادة الستون من القانون اللبناني حق الشخص ذوي اإلعاقة في الحصول على التعلم ضمن إطار المدارس العادية، بعد تأهيلها. وكذلك الحظ القانون اللبناني أهمية األخذ باالعتبار الخصوصيات المتعلقة بإجراء االمتحانات لألشخاص الصم؛ أما القانون التونسي؛ فيشير في الباب السادس)المواد من 19 إلى 25 ( إلى حقوق والمكفوفين؛ وذوي اإلعاقات الصعبة. األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على التعليم العام والمهني في مدارس عامة او متخصصة. وفي األردن؛ تتناول المادة
الرابعة هذا الحق.
143 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
في الحق عن ضمان جدا بعيدا األربع، يبدو اإلعاقة في الدول باألشخاص ذوي المتعلق والتعليمي التربوي إال أن الواقع التعلم وفق مفهوم التعليم للجميع المعتمد من منظمة »األونيسكو« ونص االتفاقية وقوانين الدول األربع. وإن كان األردن قد اطلق استراتيجية وطنية للنهوض بواقع اإلعاقة في البلد، فإنه ال وجود حتى اآلن إلى إجراءات جدية لتأهيل األبنية المدرسية الستقبال ذوي اإلعاقات، ولم تؤمن الوسائل التقنية لذلك، مثل: كتب »البرايل« للمكفوفين. أما في لبنان؛ فقد تم تأهيل بعض
األبنية المدرسية بمبادرات معظمها من جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع المدني.
الصحة؛ والتأهيل؛ وإعادة التأهيل )المادتان؛ الخامسة والعشرون؛ والسادسة والعشرون(:
تتناول المواد 27 حتى 33 من القانون اللبناني الحقوق الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان، وهي تضمن الحق في القانون التونسي؛ فيؤكد على هذا الحق في الباب أما التأهيل والمعينات. الحصول على التغطية الطبية الشاملة ، وخدمات الخامس في المواد من 14 إلى 18، بما فيها التغطية الشاملة الصحية والتأهيل، وكذلك األمر في القانون األردني في المادة الرابعة، لكنه يتناولها بتفاصيل أقل من قوانين لبنان؛ وتونس. وفي مصر؛ يتم تأمين التغطية الطبية ضمن إطار القوانين العامة
للتغطية الصحية للمواطنين كافة.
يمكن القول؛ إنه يوجد لدى الدول المختلفة شكل من أشكال الضمان الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتختلف طبيعتها من دولة الى أخرى. ففي لبنان مثال هناك ما يسمى االستشفاء على حساب وزارة الصحة. وبالرغم من أن القانون اللبناني يشير إلى أن االستشفاء يكون بالكامل على حساب الوزارة لألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أن الواقع يؤكد أن وصول الشخص لهذا الحق ليس بالشيء السهل. كما أن الدولة ال تغطي كلفة الدواء واالستشفاء الخارجي. لكن بشكل عام، توجد لدى معظم الدول
تأمينات مقبولة من المعينات، مثل: الكراسي المتحركة؛ والعصا البيضاء؛ والسماعات الطبية وغيرها.
العمل والعمالة )المادة السابعة والعشرون(:
كما هو الوضع في المادتين السابقتين؛ فإن موضوع التشغيل والتأهيل للعمل يحتل مواقع رئيسية في قوانين الدول األربع المشمولة في هذه الدراسة.
وفي مراجعة القوانين المختلفة المتعلقة بالعمل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ يتضح اعتماد معظم الدول على مبدأ فرض نسبة مئوية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة. وتختلف هذه النسبة بين دولة وأخرى. فهي بحدود 4% في األردن؛ و5% في مصر؛ و%1 في تونس؛ و3% في لبنان. إال أن تلك النسب تتفاوت بين القطاعين: العام؛ والخاص في بعض الدول؛ بمعنى أنها تقتصر على القطاع العام في بعض الدول، مثل مصر، بينما من المفترض أن يتم تنفيذها على القطاعين: العام؛ والخاص في الدول الثالث الباقية. إلى جانب ذلك، يالحظ ضعف وسائل التحفيز لدى القطاع الخاص في معظم الدول التي تعتمد هذه الوسيلة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، وعدم وجود نظام عقوبات للمخالفين في العديد منها، أو أنها تكون غير ذي أهمية باعتبارها قيمة في اإلعاقة ذوي األشخاص توظيف إلى يشير المصري العملي للتوظيف؛ فالواقع التطبيق أما على صعيد بسيطة. مادية القطاع العام، ولكن الكثير منهم ال يواظبون على العمل. كما تتمثل أهم المشكالت التي تعيق تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في: غياب برامج التأهيل لدخول سوق العمل؛ ورفض تشغيلهم من قبل المجتمع؛ وغياب التسهيالت الهندسية ؛ ومن ثم أزمة
التنقل، وبخاصة لذوي اإلعاقات: البصرية؛ والجسدية.وفي لبنان؛ يشير القانون2000/220 إلى إنشاء صندوق يمول من الشركات التي ال تلتزم بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
لديها بالنسبة المذكورة، وتصرف أمواله على تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل.
مستوى المعيشة الالئق؛ والحماية االجتماعية )المادة الثامنة والعشرون(:
في ما يتعلق بالمستوى المقبول للحياة والحماية االجتماعية؛ فإن تونس واألردن لديهما قوانين حكومية تضمن حصول األشللقانون الكامل بالتطبيق لبنان العتقاد المشرع أنه إليه يفتقر ما وهذا خاص ذوي اإلعاقة على مستوى مقبول من المعيشة،
220، تنتفي ضرورة وجود قانون متعلق بهذا الموضوع.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة144ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المشاركة في الحياة السياسية والعامة)المادة التاسعة والعشرون(:
السياسية والعامة لألشخاص ذوي المشاركة في الحياة في الحق ولبنان؛ واألردن، على تونس؛ تنص القوانين في كل من: وتأمين االقتراع، صناديق إلى الوصول في اإلعاقة األشخاص ذوي حقوق موضوع مباشرة تتناول ال أنها إال اإلعاقة،
التسهيالت الالزمة لذلك.
المشاركة في الحياة الثقافية؛ وأنشطة الترفيه و التسلية؛ والرياضة )المادة الثالثون(:
تسهيل خالل من وذلك تضمن مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية، قوانين الثالث الدول لدى توجد البيئة لحرية الحركة والتنقل، ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة: رياضيا؛ وثقافيا.
غياب نلحظ األهلي، إذ القطاع جمعيات عمل نتاج اإلعاقة من برياضة األشخاص ذوي المتعلقة النشاطات معظم تزل لم رياضات األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج وخطط وزارات الشباب والرياضة، وكذلك االتحادات الرياضية العربية، بالرغم من
أن النشاطات الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة المدعومة من الجمعيات األهلية، قد نجحت في إخراج مستوى رياضي واعد.
الجهات الرسمية المعنية بشؤون اإلعاقة
تتعلق أو هيئات وطنية لديها صالحيات انشأت مجالس قد الدراسة، بهذه المشمولة الصدد، أن الدول األربع يتبين في هذا أن مرجعية إال باإلعاقة لديها. الخاصة القوانين والمراسيم تنفيذ باإلعاقة، ومتابعة الخاصة الوطنية بوضع االستراتيجيات الهيئة يترأس من هو االجتماعية الشؤون وزير فإن لبنان مثال؛ واخرى. ففي دولة بين تختلف والمجالس الهيئات هذه أما الهيئة. بتنفيذ قرارات المعنية الحكومية الجهة الوزارة هي أن المعوقين والمؤلفة من 18 عضوا، كما الوطنية لشؤون في األردن؛ فقد أنشىء مجلس باسم » المجلس األعلى لشؤون المعوقين« ليكون هيئة مستقلة، تضم في عضويتها مجموعة كبرى من أمناء وزارات متعددة، مع عدد معين من األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي الجمعيات األهلية. وفي تونس؛ يترأس رئيس الحكومة »المجلس األعلى لإلعاقة« الذي يضم أكثر من عشرة وزراء؛ وعشرين شخصا آخر يمثلون جمعيات وهيئات األعلى لشؤون »المجلس بإنشاء يونيو2012 قرارا حزيران/ المصرية في الحكومة رئيس أصدر فقد مختلفة. وأخيرا؛ المعاقين« برئاسة رئيس الحكومة المصرية؛ وعضوية عدد كبير من الوزراء والخبراء؛ وممثلين معينين عن األشخاص ذوي
اإلعاقة، وهو شبيه في تركيبته بالمجلس التونسي.
والواضح أن التمثيل الرسمي في هذه المجالس والهيئات الوطنية، يعد متفاوتا من ناحية األهمية بين دولة وأخرى. ويسجل في معظم هذه الهيئات وجود ملحوظ لممثلي الجهات الرسمية التي تضم أحيانا وكالء الوزارات، ومديرين عامين لوزارات مختلفة، أهمها: الصحة؛ والتربية؛ والعمل؛ والرياضة، كما هو الحال في مصر؛ وتونس؛ واألردن. إلى جانب ذلك؛ فقد اعتمد كل من األردن ولبنان، ما اطلق عليه لقب ضباط االرتباط، وهم موظفون في الوزارات المختلفة يمثلون وزاراتهم في الهيئة الوطنية، ويشكلون نقطة الوصل بين الهيئة أو المجلس األعلى والوزارات المختلفة في ما يتعلق بتنفيذ القرارات في الوزارات لما تنص فخالفا داخلها. اإلعاقة تمثيل األشخاص ذوي في هو المختلفة الهيئات هذه بين الرئيسي الفارق أن المعنية. إال عليه اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من ناحية حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعبير عن مواقفهم عن طريق منظمات منتخبة منهم وتمثلهم، وباستثناء القانون اللبناني، فإن القوانين في الدول الثالث الباقية تعتمد مبدأ التعيين لألشخاص ذوي اإلعاقة في هذه الهيئات وفي أعداد تختلف بين دولة وأخرى. أما في لبنان؛ فيتمثل األشخاص ذوو اإلعاقة بثمانية ممثلين: أربعة منهم في اإلعاقة مباشرة من األشخاص ذوي اآلخرين األربعة انتخاب يتم في حين اإلعاقة، تنتخبهم جمعيات األشخاص ذوي في أما العهد. حديثة المصرية فالتجربة وأخرى. دولة بين تتفاوت فإنها الهيئات، هذه فاعلية مدى عام. وحول اقتراع مثال االهتمام نواح جديرة بالمالحظة، هناك واألردن؛ لبنان وفي لإلعاقة. األعلى المجلس تم تفعيل أنه يبدو فال تونس؛ بأمور اإلحصاء والبحوث والدراسات وإنشاء قواعد المعلومات كما هو في لبنان، والموضوعات المتعلقة بالتربية المتخصصة والطفولة والتدخل المبكر كما هو في األردن، إذ وضع المجلس األعلى استراتيجيات تنفيذ القوانين الخاصة باإلعاقة ومتابعتها مع الجهات المعنية. إال أنه على صعيد واقع فعالية عمل هذه اللجان؛ تظهر التجربة أن النتائج ال تبشر بالخير كثيرا. فكثير من هذه الهيئات واللجان ال تجتمع بشكل دوري وال تجري متابعة لقراراتها. كما ال تظهر الكثير من الوزارات المعنية اهتماما وجدية في التعاطي مع القرارات التي تصدرها هذه الهيئات واللجان، كما سيتم تبيانه في ما يتعلق بتنفيذ المواد الرئيسية في
القوانين والتشريعات المختلفة في الدول األربع.
145 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة، ودورها في الترويج لالتفاقية
يختلف وضع جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة بين دولة وأخرى، إال أنه يمكن القول؛ إن ما يسمى بالربيع العربي قد أنتج تحوال مهما وإيجابيا على صعيد قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة في تنظيم أنفسهم، والمطالبة بحقوق الفئة التي يمثلونها. ففي برزت كما القائمة، واالتحادات الجمعيات من الكثير ديموقراطية في تغييرات إجراء إلى التونسية الثورة تونس؛ أدت اتحادات اإلعاقة بتشكيل األشخاص ذوي قامت جمعيات واألردن؛ فقد مصر إلى كل من كثيرة. وباالنتقال جمعيات جديدة تمثلهم على مستوى البلد، وهو ما لم يكن متوافرا في فترة ما قبل التحوالت األخيرة. وقد باشرت هذه االتحادات العمل على قاعدة الحقوق، والعمل المطلبي. أما في لبنان؛ فإن جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة ناشطة جدا في البلد، وهي ـ في الواقع
ـ من القوى الفاعلة الرئيسية التي تحرك القضية، وتمارس ضغطا كبيرا على الحكومة من أجل تنفيذ القانون2000/220.
بعد استعراض مواد االتفاقية وقوانين الدول األربع، وبإجراء مقارنة بين القوانين الحالية المختلفة المتعلقة باإلعاقة، بما في ذلك تلك التي صدرت بعد التصديق على االتفاقية، يمكن للمراقب أن يخرج بالمالحظات التالية:
تتبنى معظم القوانين، ما عدا القانون اللبناني الذي اعتمد جزئيا منطق الحق والمسؤولية المجتمعية في قضية اإلعاقة، . 1نموذج المقاربة الطبية في تعريفها اإلعاقة.
حساب المقاربة الحقوقية . 2 اإلعاقة على تجاه األشخاص ذوي المقاربة الرعائية التونسي على يشدد القانون للقضية التي يتبناها القانونان: األردني؛ واللبناني.
تبنت كل هذه القوانين تشكيل هيئة وطنية لشؤون اإلعاقة لتتولى تنفيذ القانون. إال أن الهيئة )أو المجلس( تختلف في . 3تركيبتها؛ وصالحياتها؛ وتكوينها من دولة إلى أخرى.
ويظهر جليا أن هناك تركيزا على موضوع التأهيل والعمل، إذ رأت معظم القوانين تخصيص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين: العام؛ والخاص لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهذا أمر إيجابي. إلى جانب ذلك، يبدو الفتا للنظر غياب أية إشارة جدية إلى المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص ذوي اإلعاقة في بيئته ، وإنهاء كل أشكال التمييز ضده، باستثناء القانون اللبناني جزئيا. أما في ما يتعلق بآلية تنفيذ القانون والجهات المولجة بذلك؛ فيظهر أن هناك نوعا من الشراكة بين القطاعين: الحكومي؛ واألهلي في صياغة القرارات والخطط الحكومية الخاصة بقضية اإلعاقة. إال أن معظم هذه القوانين تلحظ تعيين الهيئة المولجة بقضية اإلعاقة من السلطات المعنية، باستثناء القانون اللبناني الذي ينفرد في وضع آلية تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، وبصورة خاصة عملية االنتخابات االنتخابات طريق )عن أنفسهم اإلعاقة اإلعاقة، واألشخاص ذوي وجمعيات األشخاص ذوي األهلية، لتمثيل الجمعيات المباشرة( في الهيئة الوطنية. إذا؛ يبدو واضحا غياب التمثيل الديموقراطي في الهيئات واللجان المعنية بالموضوع، وضعف تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في هذه اللجان والهيئات بشكل كبير، وخضوعه لمزاجية صاحب قرار التعيين؛ نظرا ألن القوانينـ باستثناء القانون اللبنانيـ ال تلحظ أي معايير لعملية االختيار. وتضع هذه القوانين معظم العالم العربي في موقع بعيد جدا عن المعايير الدولية األساسية والصادرة في القرارات والمواثيق الدولية المختلفة وعن معايير اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تركز بثبات على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات، وعلى ضرورة تأمين التمثيل الحقيقي لألشخاص ذوي التي تعنيهم. ومن الالفت للنظر أيضا في هذا اإلطار شبه الهيئات واللجان كافة التي تخصهم وفي القرارات اإلعاقة في غياب هذا الموضوع عن االهتمامات المباشرة للمشرع في الدول المختلفة عند اقتراح القوانين، ومتابعة عملية تنفيذها، إذ إن
معظم مشاريع القوانين حول الموضوع جاءت من الحكومات.
ثل: الصحة؛ والمعينات؛ والتأهيل؛ وفي النهاية؛ ال بد من اإلشارة إلى أن هذه القوانين قوية في ما يتعلق بالنواحي الخدماتية، موالتربية؛ والعمل، ولكنها ضعيفة جدا في ما يتعلق بالحقوق األساسية، مثل: الحق في األهلية القانونية؛ واللجوء إلى القضاء؛ وحق التمثيل واالختيار الحر لممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وحقوق المرأة ذات اإلعاقة، والطفل والمسن من ذوي اإلعاقة،
والحق في التصويت االنتخابي وغيرها من الحقوق.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة146ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اقتراحات ألي تدخالت مستقبلية محتملة
مع أن االتفاقية تعبر بوضوح بأن اإلعاقة هي قضية حقوق، وتستوجب برنامج عمل، فإنه من الجلي أن التزام الحكومات األربع بتطبيق االتفاقية، وبعد ما يزيد على ستة أعوام من صدورها، هو محدود ومتواضع. ويمكن أن يعزى هذا الوضع إلى سببين: أولهما، هو عدم جدية االلتزام الحكومي بالقضية، وضعف حركة اإلعاقة الوطنية في الدول األربع. بينما ينبع ثانيهما
من عدم وجود أمانة فعالة وكفوءة تتولى مسؤولية مراقبة الحكومات والمنظمات المعنية بتنفيذ االتفاقية ومتابعتها.قد ال يسهل العثور على إجابات سهلة حول ما يمكن فعله في هذا الصدد، إال أن بعض االقتراحات
قد تساعد في تقديم حل:
في المقام األول، تعد التجارب الناجحة لبعض الحاالت المتعلقة بتكوين جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة وأنشطة . 1أن المرء وسع وفي التطبيق. واستراتيجيات في مضمونها غنية المنطقة، في السياسي والضغط المطلبي العمل الثورة بعد وجودها بفرض اإلعاقة حركة تبدأ بينما في األردن وتونس، وجزئيا لبنان، في يدرج هنا التجارب
المصرية.أن أكثر ما تمس الحاجة إليه في هذا الميدان، توفير التأييد والدعم لتكوين جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول . 2
األربع، وفي مساعدة الجمعيات القائمة كي تعمل وتقيم الشبكات في ما بينها. ضرورة اطالق خطط وطنية حقيقية لتنفيذ االتفاقية، على أن تشمل تفاصيل عملية لبرامج وأهداف واضحة للتنفيذ . 3
ضمن إطار مدد زمنية واقعية، تشمل جميع القطاعات من تربوية إلى صحية إلى تأهيلية، ما يغطي مواد االتفاقية كافة. ولكي نضمن صحة تنفيذ هذه الخطط، ال بد من أن تقرها مجالس الوزراء، وأن تدخل في المالية العامة للدولة ضمن موازنة كل وزارة معنية، وأن يحدد الجهاز المعني بالتنفيذ، على أن يلحظ باستمرار الشراكة في التنفيذ مع
أصحاب القضية.
147 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
امللحق رقم 1
ملخص االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تتضمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 50 خمسين مادة، من بينها 16 ست عشرة مادة تتعلق بالحقوق مباشرة. وتتوزع االتفاقية على ثالثة أقسام: القسم األول؛ ويتناول مجموع الحقوق الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والقسم الثاني؛ ويتناول مسؤولية الدول في تنفيذ بنود هذه االتفاقية، أما القسم األخير؛ فيتناول آلية المراقبة لضمان تنفيذ بنود االتفاقية من جانب الدول
قة عليها. المصد
ويقع القسم المتعلق بالحقوق في 16 ست عشرة مادة، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بضمان التعامل مع قضية اإلعاقة من موقع الحق اإلنساني، ضامنة االنتقال الجذري من المنظومة الفكرية القائمة على الرعاية واإليواء إلى الخطاب القائم على مبدأ الحقوق وتكافؤ الفرص. وتشمل الحقوق التالية: الحق في المشاركة الكاملة في جوانب الحياة كافة مع بقية أفراد المجتمع؛ والحق في التنقل؛ والحق في التواصل والحصول على المعلومات؛ والحق في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية بما فيها حق االقتراع؛ والحق في التعليم والحصول على المعرفة؛ والحق في الحصول على جميع الخدمات الطبية وتقديمات الضمان
االجتماعي؛ والحق في التوظيف والعمل؛ وأخيرا الحق في الترفيه والمشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية.
وتتناول المادة األولى من االتفاقية األهداف التي يمكن تلخيص أهمها بما يلي:
أ. االعتراف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وضمانها؛ وتعزيزها؛ وحمايتها.ب. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في المجالين: العام؛ والخاص.
الحياة في المساواة قدم على الكاملة ومشاركتهم واستقالليتهم؛ ذواتهم؛ على اإلعاقة ذوي األشخاص اعتماد تعزيز ج. االقتصادية؛ والثقافية؛ والمدنية والسياسية.
د. الترويج ألشكال جديدة من التعاون الدولي لدعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة، ولتحقيق أهداف هذه االتفاقية.
وتتناول المواد من3 إلى 16، الحقوق كافة التي تضمنتها االتفاقية لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة من الدولة والمجتمع. فتركز المادة الثالثة على دور الدولة في اتخاذ جميع اإلجراءات إلنهاء كل أشكال التمييز القانوني ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.
اإلعاقة، ذوي األشخاص ضد التمييز أشكال جميع إزالة في المجتمع مسؤولية بمعنى للقضية؛ المجتمعي البعد ولتأكيد تنص المادة الخامسة على أهمية قيام الدول المصدقة على االتفاقية بتغيير القوالب النمطية، واألنماط الثقافية واالجتماعية،
والممارسات العرفية أو أي طابع آخر يشكل عقبة في طريق ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة أو أسرهم لحقوقهم.
أما المادة السادسة؛ فتتناول مسؤولية الدول في تأمين وسائل النقل والتسهيالت الهندسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وإذ تركز االتفاقية على حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من إمكانية التعرض ألشكال العنف المختلفة، وأهمية حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على الخدمات القضائية والقانونية، فإن المادة التاسعة تنص على أن: تسلم الدول األطراف بأن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون بصفة خاصة في الميادين العامة والخاصة لشتى أنواع العنف وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، ولهذا ينبغي للدول األطراف أن تضمن احترام كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة
وسالمتهم.
بينما تنص المادة العاشرة على أهمية تشجيع الدول األطراف على احترام حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع المداوالت القانونية، وحظر جميع أشكال التمييز خالل المرافعات القانونية أو في أثناء قضاء عقوبة السجن، واعتبار هذا
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة148ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التمييز في عداد السلوك اإلجرامي الجسيم، وتصنيفه على هذا النحو عندما يرتكب بحق األشخاص ذوي اإلعاقة.ولعل الجانب األهم واألكثر إثارة في االتفاقية، هو اإلشارة المباشرة إلى حق األشخاص ذوي اإلعاقة في االنخراط الكامل في الحياة السياسية وإزالة الحواجز كافة التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم وواجباتهم السياسية. إذ تنص اإلعاقة، السياسية لألشخاص ذوي بالحقوق االتفاقية بهذه الدول األطراف اعتراف الحادية عشرة على ضرورة المادة
والتعهد باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية.
وتركز المادة الثانية عشرة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعلم، والحصول على المعرفة.
واشتملت المادة الثالثة عشرة على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على الخدمات الطبية. إذ تنص على ضرورة تشجيع الدول األطراف على إمكانية استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من الخدمات الطبية، وخدمات إعادة التأهيل التي يحتاجون
إليها، على نحو يضمن حقهم في الصحة، وفي تقوية اعتمادهم على الذات، والعيش حياة مستقلة.
ويأتي موضوع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان حصولهم على العمل في المادة الرابعة عشرة، التي تنص على أن تسلم الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفي اختيار مهنهم ووظائفهم بحرية. وستعتمد جميع التدابير
الالزمة لمشاركتهم على قدم المساواة في سوق العمل.
الى جانب ذلك، تؤكد المادة الخامسة عشرة على واجب استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من تقديمات الضمان االجتماعي، إذ تنص على أن تتعهد الدول األطراف بإزالة جميع القواعد والممارسات التي تحد من استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من
فوائد الضمان االجتماعي.
واخيرا؛ تنص المادة السادسة عشرة على حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالترفيه وممارسة النشاطات الرياضية المختلفة.
مما ال شك فيه أنه ال قيمة ألية اتفاقية ضامنة للحقوق من دون وجود آلية تنفيذ ومراقبة لضمان جدية االلتزام. بناء عليه، تنص االتفاقية في المادة السابعة عشرة على ضرورة تشجيع الدول األطراف، وفقا ألنظمتها القانونية بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية تكفل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم. كما توافقت الدول األطراف على التشاور والتعاون بشأن إنفاذ مضمون
هذه االتفاقية، فضال عن العمل معا بروح التعاون لتحقيق أهدافها. وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد بما يلي:تصميم برامج تسهل تنفيذ االتفاقية استنادا إلى القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها من الصكوك التي تعزز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم. إلى جانب ذلك ينشأ ما يسمى المؤتمر، وهو اللقاء
الدوري للدول المصدقة على االتفاقية.
أما آلية مراقبة مدى التزام الدول المصدقة على االتفاقية، فتنص المادة العشرون على إنشاء لجنة خبراء معنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )تدعى فيما يلي بـ »اللجنة«(.
إلى جانب تشكيل اللجنة، تنص المادة الواحدة والعشرون على أن تتعهد الدول األطراف بتقديم تقرير إلى األمين العام لألمم المتحدة، لتتولى اللجنة دراسته، ويتعلق بالتدابير التشريعية والقضائية واإلدارية، أو أي تدابير أخرى، تم اعتمادها إلعمال أحكام هذه االتفاقية. أما التقارير التي تقدمها الدول األطراف؛ فيجب أن تحدد ما أحرز من تقدم، فضال عن القيود المؤثرة في درجة الوفاء بااللتزامات بموجب هذه االتفاقية. ويجب أن تتضمن كذلك معلومات كافية عن الصعوبات التي تواجه تنفيذها. وتقدم الدول األطراف تقاريرها لتقوم اللجنة بتقييمها في فترة سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف
المعنية، وبعد ذلك يتم تقديمها كل أربع سنوات، أو عندما تطلب منها اللجنة ذلك.
يتم ونساء( اللجنة من 12 خبيرا)رجاال تتألف أن فتنص على اللجنة، بكيفية تشكيل المتعلقة الثانية والعشرون المادة أما والعلماء؛ واالختصاصيين؛ والمثقفين؛ اإلعاقة؛ ذوي األشخاص منظمات في البارزين الوطنيين القادة بين من اختيارهم واألطباء المعروفين بنزاهتهم الخلقية السامية، وكفاءتهم في حماية وتعزيز حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، والذين العادل الجغرافي التوزيع ذلك في مراعية األطراف، الدول تنتخبهم الخبراء وهؤالء الشخصية. بصفتهم الخدمة يتولون
والتخصص في أنواع حاالت اإلعاقة المختلفة.
وفي ما يختص بمكتب اللجنة واجتماعاتها؛ فمنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين. إذ تنتخب اللجنة مكتبها لفترة سنتين، كما تجتمع عادة كل سنة في مقر االمم المتحدة لفترة ال تتجاوز أسبوعين لتقييم التقارير المقدمة عمال بالمادة السابقة.
149 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مللحق 2س؛ ولبنان؛ واألردنا
مراقبة القانون والسياسة على المستوى الوطني في كل من: تون
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
الدولية المعايير
صة الخا
واإلقليمية اإلنسان
بحقوق )الميثاق/المادة(
اإلجابة عن السؤال تكون بنعم أو ال:-ض القوانين
أوال:- بالنسبة لـ )نعم( نجد أن بعص ذوي
ت تساعد على تمتع األشخاوالسياسا
ت، ولو أنها ض الحقوق والحريا
اإلعاقة ببعت على العموم، ومثل ذلك:-
جاءب
صحية 2- والتدري1- الحق في الرعاية ال
-4ت البيئية
والتسهيال -3
والتأهيل ت الجمركية 5- الحق في التعليم
واإلعفاءاوالمشاركة
الدمج ـ
6العالي
والتعليم والثقافية
ضية والريا
في الحياة السياسية المستوى
على والتطبيق
المراقبة -7
صد(.الوطني)ر
«ص المعوقين
ص بحقوق األشخا»الخا
يعتمد لبنان قانونه 2000/220
ف بـ وهو القانون المعرو
،2000منذ العام
ت سياسا
صدر األساسي لتوجيه . يعتبر هذا التشريع هو الم
ص ذوي الحكومة وتوجيه المجتمع نحو احترام حقوق األشخا
ضح الدور اإلعاقة. وفي اإلجابة عن األسئلة من 1 إلى 40 يت
س الحقوق اإلنسانية المركزي للقانون 220 في العمل على تكري
ت الحكومة لتأمين ص ذوي اإلعاقة، وفي تفعيل سياسا
لألشخات المختلفة في إطار عملية التنمية اإلنسانية المستدامة
الخدماص ذوي اإلعاقة. والحكومة اللبنانية منذ
وتأمين الحقوق لألشخاش االجتماعي أوال، ووزارة
صلحة اإلنعا50 عاما تعمل عبر م
الشؤون االجتماعية الحقا، على تطبيق سياسة توفير الرعاية ب
ت التأهيل وإعادة التأهيل والتعليم األكاديمي والتدريوخدما
صة ص
س متخص ذوي اإلعاقة من خالل مدار
المهني لألشخاوتدعمها أموال
يديرها القطاع األهلي ت
خدماومراكز
غير جمعياته
خالل الحكومة. وقد كان المجتمع المدني من
ت الرعاية ض برامج التأهيل وخدما
الحكومية قد بدأ بتوفير بعصغيرة من المعوقين حتى قبل نيل لبنان استقالله. لكن
بأعداد ت محدودة ومتقطعة إلى أن بدأ تدخل الدولة
ت كانهذه الخدما
ش االجتماعي. وتتابع وزارة صلحة اإلنعا
من خالل برامج مالشؤون هذه المسيرة، علما أن القانون 220 في حال تنفيذه والرعاية
ت التأهيل خدما
والكامل يجعل صحيح
بالشكل الص ذوي اإلعاقة
س الحقوق لألشخاوتكري
صادر 83، ال
القانون في العام 2005، وفي ف
يعرالثانية
مادته على أنها تلد
اإلعاقة ب
ص أو تكتسمع الشخ
فيما بعد، وهي إعاقة ب الجسد،
صيدائمة ت
س، أو العقل، أو الحوا
ت المرء فتحد من قدرا
على القيام بنشاط أو ت
النشاطامن
أكثر اليومية،
األساسية صي
ت الطابع الشخذا
وتحد واالجتماعي،
في انخراطه
من المجتمع.
0.هل تساعد القوانين ت الحكومة
و/أو سياساعلى تيسير االحترام
والممارسة الكاملة والفعالة والمتساوية
والمتماثلة لجميع الحقوق اإلنسانية
ت األساسية والحريا
ص ذوي لألشخا
اإلعاقة؟ت
ما هي التعريفاب التي يشتمل
والجوانعليها التحليل؟
فالهد
اتفاقية حقوق ص ذوي
األشخااإلعاقة، المادة 1
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة150ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
الدولية المعايير
صة الخا
واإلقليمية اإلنسان
بحقوق )الميثاق/المادة(
ت وجد
وإن هذه الحقوق،
ث إن حي
ا* صا لها في القوانين، أال أنها لم ترتق
صون
ت األردن الدولية.إلى التزاما
ض الحقوق ثانيا: أما بالنسبة لـ )ال(:- فإن بع
لم تزل تراوح مكانها، ولم ترق إلى المعايير الدولية مثل ذلك:-
ضح.ف اإلعاقة بشكل وا
1- عدم تعريس
على أساعدم تجريم التمييز القائم
-2اإلعاقة.
ص ذوي ألشخا
عدم المساواة الفعلية -3
اإلعاقة.4- عدم وجود عقوبة في حال انتهاك حقوق
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
ص ذوي 5- عدم وجود قانون يحمي األشخا
ف؛ والعن
ب؛ ض للتعذي
من التعراإلعاقة
واالستغالل. ويجرم القيام بذلك.6- عدم وجود قانون أو سياسة تحمي النساء
واألطفال ذوي اإلعاقة من االستغالل.
ف دوائر الحكومة ووزاراتها عمال منسقا ومتكامال بين مختل
القانون يكرسها
التي الحكومية
ت السياسا
وإداراتها.من المعوق
بطاقة صدار
وإت
اإلعاقاف
صنيت
2000/2204 من
3 و ب المادتين
حسصاء بالتسجيل
صية )اإلحالشخ
القانون ، وفقا لما يتبين من اإلجابة عن السؤال 41(، ومرسوم ص ذوي اإلعاقة،
قانون المهن الحرة لتسهيل العمل لألشخاض بطالة للمعوقين
ص على دفع تعويومرسوم البطالة الذي ين
وظائفهم )يرجى عن العمل بفعل تسريحهم من
المتعطلين ت
مراجعة إجابة السؤال 34(، وسياسة الرعاية وتقديم الخدماصحية )يرجى مراجعة إجابة السؤال 32(، وتوفير الدعم من
البرنامج تأمين حقوق المعوقين ووزارتي الشؤون االجتماعية مراجعة
وإعادة التأهيل )يرجى ت التأهيل
صحة لخدماوال
ت المتاخمة للمساعدة في إجابة السؤال 33(، وبرنامج الخدما
ص على األشخا
وتسهيل الحياة والمعيشة تأمين االستقاللية
وتأمين ،)35
ذوي اإلعاقة )يرجى مراجعة إجابة السؤال مراجعة إجابة السؤال
واالقتراع )يرجى ت
صويالحق بالت
وكذلك ،)31
مراجعة إجابة السؤال والتعليم)يرجى
،)36ص ذوي
ت المختلفة على تسهيل مشاركة األشخاتعمل السياسا
اإلعاقة في الحياة االجتماعية )يرجى مراجعة إجابة السؤال ضة )يرجى مراجعة إجابة
37(، وتأمين الحق في ممارسة الرياالسؤال 38(، علما أن السياسة المتبعة في برنامج تأمين حقوق ث تؤدي دورا في
ت وجود وحدة أبحاص المعوقين سهل
األشخا
151 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
الدولية المعايير
صة الخا
واإلقليمية اإلنسان
بحقوق )الميثاق/المادة(
ف بمبدأ ص أو قانون يعتر
7- عدم وجود نالمساواة الفعلية.
* وهنا نجد أنه لم يتم اعتماد قوانين أو األردن
ت التزاما
مع تتماشى
ت سياسا
ضمن تحقيق المبادئ والحقوق الدولية، وت
ت األساسية الواردة في اتفاقية حقوق والحريا
صادق عليها ص ذوي اإلعاقة التي
األشخات في
صور في التشريعااألردن؛ لتالفي الق
ما يتعلق بهذه الحقوق.
ص ذوي اإلعاقة )يرجى مراجعة ضايا وحقوق األشخا
معالجة قإجابة السؤال 11(. كما يمكن اعتبار أن تطبيق أحكام القسم ص بالحق في السكن يفعل سياسة الدولة
س من القانون الخاالساد
ص ذوي اإلعاقة )يرجى مراجعة ش المستقل لألشخا
لتأمين العيت محددة
صاءاإجابة السؤال 26(، ونحن ال نورد في إجاباتنا إح
ب غير مقطوعة الحسا
ت الحكومية في لبنان ألن الموازنا
؛ بشكل ناجز اعتبارا من العام 2005 وحتى اليوم، األمر الذي ت من قيمتها الفعلية لجهة
ت الحكومية قد خسريعني أن الموازنا
ت المختلفة القوة الشرائية ، ولجهة األرقام الدقيقة لبنود الموازنا
. من جهة أخرى ال يمكننا اإلشارة إلى أية قوانين تتناول التعامل ص ذوي اإلعاقة، إن سلبا أو إيجابا؛ ألن القانون
مع األشخاصراحة بإبطالها . والدستور اللبناني ال يكفل سوى
ضى 220 ق
المساواة بشكل عام لجميع المواطنين أمام القانون، وهو في هذا صادر في
ص أي فئة بعينها. وهذا الدستور ص
السياق ال يخصدور اإلعالن الدولي
العام 1926 ؛ أي قبل 22 عاما من لحقوق اإلنسان.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة152ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
الدولية المعايير
صة الخا
واإلقليمية اإلنسان
بحقوق )الميثاق/المادة(
ص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.* قانون حقوق األشخا
المادة )2(صور كلي أو
ب بقصا
ص مشخ
ص المعوق: كل الشخ
جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية ت
ث ال يستطيع تلبية متطلباالتعليم أو التأهيل أو العمل بحي
ف أمثاله من غير المعوقين.حياته العادية في ظرو
ت البناء ت البناء الوطني األردني/كودة متطلبا
2- كوداص بالمعوقين .
الخاب األول المادة 1/4/1
الباصور كلي أو جزئي
ب بقصا
ص مالمعوق: هو كل شخ
في أي من حواسه أو قدرته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعليم أو التأهيل أو العمل ف
ت حياته العادية في ظروث ال يستطيع تلبية متطلبا
بحيأمثاله من غير المعوقين.
مادته الثانية 2000/220 في
ضمن القانون يت
ص ذي اإلعاقة: ’المعوق ف التالي للشخ
التعريت قدرته على :
ت أو انعدمص الذي تدن
هو الشخممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر ، أو تأمين صية بمفرده . أو المشاركة
ت حياته الشخمستلزما
على قدم المساواة مع ت االجتماعية
في النشاطاصية أو اجتماعية
شخحياة
ضمان اآلخرين ، أو
ب ب معايير مجتمعه السائدة ، وذلك بسب
طبيعية بحسصير وظيفي بدني أو حسي أو ذهني،
فقدان أو تقعن اعتالل
ت ناتج جزئي، دائم أو مؤق
كلي أو ت أكثر
ضية دامب أو عن حالة مر
بالوالدة أو مكتسمما ينبغي لها طبيا أن تدوم‘.
ف اإلعاقة، صني
ت3 إلى
في المادة ويتطرق
صره وهذا تخت
عليه، ت التي قد تطرأ
والتعديالف في مادتها األولى.
االتفاقية الدولية في التعري
ص القانون 83 في ين
على مادته األولى،
ص أنه سيكون لألشخا
س نف
اإلعاقة ذوي
على التقدم
ص فر
مع المساواة
قدم والحق
اآلخرين، بالحماية من التمييز، ومع ذلك، فال يوجد صريح
تشريع ضد التمييز،
ضح ووا
أي يوجد
ال كما
منع ضمان
أنظمة لالتمييز.
1.هل هنالك ثمة قانون أو ف
سياسة تشتمل على تعرياإلعاقة؟
ب التي ت والجوان
التعريفايشتمل عليها التحليل
ف وتوثيق ما له ص
)3( وت،
عالقة من القوانين/السياساالتي تم االعتماد عليها في
التحليلصادر األخرى
المالمستخدمة في التحليل مثل: ت
ت، والموازناصاءا
)اإلحت من
الوطنية، والمعلوماف األساسية(
األطرا
ف اإلعاقةتعري
حقوق اتفاقية
ذوي ص
األشخااإلعاقة، المادة 1
153 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ب حاسة النظر أو حاسة صي
2/4/1: اإلعاقة الحسية التي تالسمع أو كلتيهما.
صر في عينيه االثنتين.ف: هو فاقد حاسة الب
3/4/1: الكفيصم: هو فاقد حاسة السمع في أذنيه االثنتين.
5/4/1: األحركة اليدين أو
عجز هي
6/4/1: اإلعاقة الحركية: الرجلين بشكل كلي أو جزئي.
7/4/1: المقعد: هو فاقد الحركة في رجليه االثنتين.10/4/1: إعاقة اليدين: هي فقد حركة اليدين االثنتين أو
إحداهما.على
11/4/1: اإلعاقة العقلية: هي اإلعاقة التي تؤثر ف
وظائجزئي في
خلل كلي أو ب في
وتتسبالدماغ
ف ث السيطرة على حركة األطرا
الدماغ المختلفة من حيواإلدراك والتركيز وغير ذلك.
صندوق المعونة الوطنية/ - وزارة التنمية االجتماعية /
1/لسنة رقم
ألسر المعوقين القانون ت المالية
المعونا2011
صور )كلي أو ب بق
صاص م
المادة )2( المعوق: كل شخجزئي( بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم ت حياته
ث ال يستطيع تلبية متطلباأو التأهيل أو العمل بحي
ف أمثاله من غير المعوقين ويقيم بشكل العادية في ظرو
دائم في المملكة ويحمل رقم وطني.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة154ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
الدولية المعايير
صة الخا
واإلقليمية اإلنسان
بحقوق )الميثاق/المادة(
صل الثاني / المادة )6( الدستور / الف
1- األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق ت وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
والواجبااالستراتيجية الوطنية لألعوام 2010 – 2015
ثانيا: مبادئ اآلستراتيجية:ص ذوي اإلعاقة وعلى
على مواطنة الشخ1- التأكيد
ص ذوي ضد األشخا
ضرورة مكافحة كل أشكال التمييز اإلعاقة.
ضايا اإلعاقة والذي 2- التأكيد على النموذج الحقوقي لق
ص ذوي ضد فئة األشخا
يعتمد إزالة كل أشكال التمييز اإلعاقة بما في ذلك إزالة العوائق البيئية حق من حقوق
اإلنسان المكفولة في كافة المواثيق الدولية.ف:
ثالثا: األهداف
ت التي قد تلحق العنالحد من مواجهة كافة الممارسا
وتقليل ص ذوي اإلعاقة
واالستغالل باألشخاواإلساءة
نسبها وفق خطط منهجية محكمة.ص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
قانون حقوق األشخاس
ص على أساص وعدم التمييز بين األشخا
ج- تكافؤ الفراإلعاقة.
د- المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين في الحقوق ت.
والواجباضمان حقوق األطفال المعوقين وبناء قدراتهم وتنمية
هـ- مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
مفهوم التمييز غير مطروح في القانون 2000/220 الذي هو المادة التشريعية الوحيدة المعنية بحقوق ت الهيئة الوطنية
ص ذوي االعاقة. وقد استنداالشخا
لشؤون المعوقين إلى المادة 97 من القانون نفسه ث إقامة دعاوى لرفع
ب تنبيهية، ولبحلتوجيه كت
ضد المعوقين. ب اإلعاقة
الغبن نتيجة التمييز بسبضائية
ص على : »تعفى من الرسوم القوالمادة 97 تن
المتوجبة على تقديم اية دعوى أو شكوى أو التدخل ف أنواعها ودرجاتها،
فيها أمام المحاكم على اختالص معوقون أو ممثلوهم القانونيون
التي يقيمها أشخاب مخالفة أي
أو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبمن أحكام هذا القانون أو تأسيسا عليه أو لعدم تطبيق صا بالمعوقين.
س حقا خاص قانوني آخر يكر
أي نت المحاكمة
على كافة درجاوتطبق هذه المادة
جزائية، إدارية، ف أنواعها: مدنية،
وعلى اختالوغيرها«.
صية شخ
مذهبية، أحوال عسكرية،
غير مباشرة ولتسهيل صورة
ولمكافحة التمييز بص المادة 69 من
ص ذوي اإلعاقة، تنعمل األشخا
القانون على ما يلي: »ال تشكل اإلعاقة بحد ذاتها ألي عمل أو وظيفة. ويعتبر
حائال دون الترشيح ص يشترط ألي عمل أو وظيفة
بحكم الملغى كل نصابة بإعاقة أو
سالمة البنية أو الجسد أو عدم اإلعاهة أو علة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ، مما
ب المعوق.....«يؤدي إلى الحؤول دون قبول طل
إن المادة 3 من النظام صادر
رقم 1467، المايو
30 أيار/ في
على ص
2005، تنتعتبر
المباني أن
صول إذا ممكنة الو
ص ذوو تمكن األشخا
من التحرك اإلعاقة
بداخلها بحرية كاملة.
2. هل تمتلك الحكومة دستورا رسميا أو تشريعا عاما يجرم
التمييز القائم على اإلعاقة؟
عدم التمييز
اتفاقية حقوق ص ذوي
األشخاب،
اإلعاقة، المادة 3والمادة 5
155 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
المعايير الدولية واإلقليمية اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
ص المعوقين رقم 31/لسنة2007.- قانون حقوق األشخا
المادة )2(ف
ت الالزمة لمواءمة الظروت المعقولة: التجهيزا
التجهيزات
ت واألدواث المكان والزمان وتوفير المعدا
البيئية من حيضمان ممارسة
والوسائل المساعدة حيثما كان ذلك الزما لص المعوقين لحقوقهم على قدم المساواة مع اآلخرين
األشخاضررا جسيما بالجهة المعنية.
ب ذلك على أن ال يترت
المادة )3(ص المعاق من
ت المعقولة لتمكين الشختوفير التجهيزا
التمتع بحق أو حرية أو لتمكينه من االستفادة من خدمة معينة.
ت البيئية.المادة )4( هـ/التسهيال
صراحة ص
ال يوجد في القانون 220 ما ينضمن التطبيق يتم العمل
على التمكين، بل على تأمين الحد األدنى- أو ربما أكثر من التمكين. وسياسة الحكومة في توفير الدعم ت التأهيلية توفر
ت تقديم الخدمالمؤسسا
أحد الشروط األساسية لتأمين الحد األنى صدور القانون
سابقة لمن التمكين، وهي
ت. كما تقدم الحكومة دعما ت السنوا
بعشراض برامج التأهيل والتمكين التي
محدودا لبعص ذوي اإلعاقة.
ت األشخاتديرها جمعيا
ال يوجد3.هل هنالك ثمة قانون أو حق
ضمن حكومية ت
سياسة ص ذوي اإلعاقة بـ
األشخا»الحد األدنى من التمكين«؟
الحد األدنى من التمكين
ص األشخا
حقوق اتفاقية
2المادة
اإلعاقة، ذوي
والمادة 5، والمادة 13,1، و 14,2, و 24,2ج, و 24,5
و 27,1ي.
ص ت البناء الوطني الرسمي الخا
1- تطبيق كودة متطلبات العالقة
عن الجهة ذاصادرة
ص المعوقين الباألشخا
ص والمتاحة جميع األبنية في القطاعين العام والخا
في للجمهور ويطبق ذلك على األبنية القائمة ما أمكن.
س 2010-2015/ المجل
االستراتيجية الوطنية لألعوام ص المعوقين:
األعلى للشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم في
* توسيع مشاركة األشخاالحياة العامة بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية
ضة.والثقافية وأنشطة الترفيه والريا
ص ت األساسية المقدمة لألشخا
* تحسين مستوى الخدماذوي اإلعاقة بما يحقق مبدأ الدمج واالستقاللية وتمكين صحيا من خالل بناء
صاديا واألسرة اجتماعيا ونفسيا واقت
ص صول إلى مجتمع أمن دامج لألشخا
ت األسرة للوقدرا
ذوي اإلعاقة.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة156ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
ص المعوقين / المادة * حقوق األشخا
.)3(ص المعوقين
أ- احترام حقوق األشخاوكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام
صة.حياتهم الخا
1- االستراتيجية الوطنية المادة )2( مبادئ االستراتيجية:-
ص ذوي 1- التأكيد على مواطنة الشخ
ضرورة مكافحة كل أشكال اإلعاقة وعلى
ص ذوي اإلعاقة.ضد األشخا
التمييز ص ذوي اإلعاقة بما
2- استقاللية األشخاصيرهم وتحديد
في ذلك الحق في تقرير مخياراتهم.
ص ذوي اإلعاقة 220 المتعلق بحقوق األشخا
إن القانون ت مسألة اإلعاقة. ولم
هو المادة القانونية الوحيدة التي تناولصريح ومباشر يتعلق بمسألتي
ص ضمن هذا القانون أي ن
يتت
الكرامة واالستقاللية، بل اكتفى القانون بالتعاطي مع المجاالص المعوق ولم يتطرق مباشرة إلى
الخدماتية والحقوقية للشخالمجال المعنوي.
القانون 83 في مادتيه األولى والرابعة
يوفر ركائز للدمج االجتماعي والتربوي.
4.هل هنالك قانون أو سياسة حكومية
ف باحترام الكرامة تعتر
صيلة و/أو استقاللية األ
ص ذوي األشخا
اإلعاقة؟
الكرامة
ص األشخا
حقوق اتفاقية
3أ، ذوي اإلعاقة، المادة
والمادة 19القوانين المعتمدة- الديباجة
157 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ص المعوقين رقم * قانون حقوق األشخا
31 لسنة2007 المادة )3( :-)ح( الدمج في شتى مناحي الحياة
صعد بما في ف ال
ت وعلى مختلوالمجاال
ضاياهم ص المعوقين وق
ذلك شمول األشخابالخطط التنموية الشاملة.
ب/التعليم والتعليم العالي.* المادة )4(
ص التعليم العام والتعليم المهني 1- فر
ب ص المعوقين حس
والتعليم العالي لألشخاب الدمج.
ت اإلعاقة من خالل أسلوفئا
2- اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين وأقرانهم من غير المعوقين
ت التعليمية.وتنفيذها في إطار المؤسسا
* المادة )4( د/الحياة االجتماعية والرعاية المؤسسية.
1- دمج الطفل المعوق ورعايته التأهيلية داخل أسرته، وفي حال تعذر ذلك تقدم له
الرعاية التأهيلية البديلة.* االستراتيجية الوطنية المادة )2( مبادئ:
ص ذوي 1- توسيع مشاركة األشخا
اإلعاقة ودمجهم في الحياة العامة بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية والثقافية
ضة .وأنشطة الترفيه والريا
س / التربية والتعليم * المحور الخام
الدمج:ص ذوي اإلعاقة على
صول األشخاح
حقهم في التعليم العالي من خالل إيجاد ص ذوي
بيئة تعليمية دامجة لألشخات
اإلعاقة ذكورا وإناثا وفي كافة المحافظابشكل متكافئ.
ضحة في القانون 220 المتعلق صريحة ووا
ال توجد أي مواد ص ذوي اإلعاقة، وهو القانون الوحيد الذي
بحقوق األشخاضوع دمج
ضوع اإلعاقة، باستثناء ما ورد حول مويتناول مو
ب س العادية، وذلك في البا
ب ذوي اإلعاقة في المدارالطال
ضوع التربية والتعليم. والقانون يتطرق إلى السابع المتعلق بمو
ضوع الدمج الكامل بطريقة غير مباشرة في المادتين 59 مو
و60 . ص معوق الحق بالتعليم،
المادة 59 »مدى الحقوق: لكل شخوالتعليم
متكافئة للتربية صا
ضمن فربمعنى أن القانون ي
ضمن جميع ص المعوقين من أطفال وراشدين
لجميع األشخات، وذلك في
ت التربوية أو التعليمية من أي نوع كانالمؤسسا
صة إذا استدعى األمر«.ف خا
صفوصفوفها النظامية وفي
ت التربوية: أ. ال تشكل ب إلى المؤسسا
»االنتسا المادة 60
ب أو الدخول إلى ب االنتسا
طلاإلعاقة بحد ذاتها عائقا دون
صة، من أي نوع أية مؤسسة تربوية أو تعليمية، رسمية أو خا
ب ب انتسا
ص يشترط ألي طلت. ويعتبر بحكم الملغى كل ن
كانصة من
أو دخول ألية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصابة بإعاقة
ت، سالمة البنية أو الجسد أو عدم اإلأي نوع كان
ب. تعتبر أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من التعابير واأللفاظ.
ت المتعلقة بالكفاءة المعمول ت العادية، مثل االمتحانا
اإلجراءات الدخول أو االنتقال من
طلبابها وغيرها، والمعتمدة لقبول
ب أو الدخول ب االنتسا
ض طلف إلى آخر، كافية لقبول أو رف
صصة من أي
إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاب حامل لبطاقة المعوق
ب انتسات. ج. يعطى كل طال
نوع كانصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية
صية فرالشخ
ضلى، التي أو التعليمية التي يختار، وذلك بتأمين الشروط الف
ت خالل ت الدخول، وسائر االمتحانا
تسمح له إجراء امتحاناالعام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، س الوزراء«.
وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلص المادتين
ضاءة على مسألة الحق في التعليم ون)للمزيد من اإل
الواردتين هنا، يرجى مراجعة إجابة السؤال 31(
5. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية تؤكد على مبدأ المشاركة
صورة كاملة والدمج ب
وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع ص
اآلخرين لألشخاذوي اإلعاقة؟
المشاركة والدمج
ص األشخا
حقوق اتفاقية
ذوي اإلعاقة، المادة 3ج.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة158ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
المعايير الدولية واإلقليمية صة بحقوق اإلنسان
الخا)الميثاق/المادة(
ص المعوقين رقم 31 قانون حقوق األشخا
لسنة2007 المادة )3( ص المعوقين باعتبارهم
ز- قبول األشخاجزءا من طبيعة التنوع البشري.
ص وعدم التمييز بين ج- تكافؤ الفر
س اإلعاقة.ص على أسا
األشخا* االستراتيجية الوطنية المادة )2(
مبادىء:6- قبول اإلعاقة كجزء من التنوع
اإلنساني والطبيعة البشرية.)7( المساواة:-
ص المعوقين رقم 31 قانون حقوق األشخا
لسنة2007 المادة )3(
ص من ص لكن القانون 220 ين
صوال يوجد قانون بهذا الخ
ف. ضمنا بوجود االختال
ف ف اإلعافة، و يعتر
خالل تعريضح أو
بحال التعديل يمكن توسيع المفاهيم المعتمدة بشكل أوص عليه.
زيادة قانون ين
ال يوجد6. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية
ضرورة ص على
تنف
احترام االختالصفها
وقبول اإلعاقة بوشكال من أشكال التنوع
اإلنساني؟
فاحترام االختال
ص األشخا
حقوق اتفاقية
ذوي اإلعاقة، المادة 3 د
159 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ص المعوقين رقم 31 قانون حقوق األشخا
لسنة 2007المادة )3(:-)ج( المساواة بين الرجل والمرأة المعوقين
ت.في الحقوق والواجبا
* االستراتيجية الوطنية المادة)2( مبادئ االستراتيجية:
ص ذوي 1- التأكيد على مواطنة الشخ
ضرورة مكافحة كل أشكال اإلعاقة وعلى
ص ذوي اإلعاقة.ضد األشخا
التمييز ص وعدم التمييز بين
ج- تكافؤ الفرس اإلعاقة.
ص على أسااألشخا
ب المهني والعمل المادة )4( )ج(:- التدري
ص المعوقين على صول األشخا
د- حف
ص متكافئة في مجال العمل والتوظيفر
ت العلمية.ب والمؤهال
بما يتناس* االستراتيجية الوطنية المادة )3(
ف:-األهدا
ص ذوي اإلعاقة 6- تعزيز حق األشخا
صة مهنية صول على فر
في العمل والحمتكافئة أسوة بأقرانهم من غير المعوقين.
صريحة إلى مبدأ 2000/220 إشارة
ضمن القانون ال يت
ص ذوي اإلعاقة إال في ص أمام األشخا
المساواة في الفرصة في حق المعوق في التعليم
ث عن مدى الحقوق الخاالحدي
صريحة تأمين حق ب يطريقة
ضة والعمل. والقانون يوجوالريا
ضائية والبيئة المؤهلة صول على المساعدة الق
المعوق في الحت
صة والخدمات الخا
ف السياراوالسكن الالئق والتنقل ومواق
ت . لكنه ت المساعدة والمشاركة في االنتخابا
صحية والخدماال
ص بشكل عام ومطلق.ث عن مبدأ تكافؤ الفر
ال يتحدص ذوي
ص القانون 2000/220 على إبطال منع األشخاين
ف وأعمال القطاع الحكومي .وهو اإلعاقة من االلتحاق بوظائ
ص ف في القطاعين العام والخا
يحدد »كوتا«)3%( من الوظائللمعوقين. والحكومة تعلن عن اعتماد سياسة تشجيعية لتطبيق صلحة
طريق التمييز اإليجابي لمعن
مبدأ المساواة الفعلية ص ذي اإلعاقة
ص ذوي اإلعاقة، بمعنى منح الشخاألشخا
صول ضلية الح
ف أفت الوظائ
الناجح بمرتبة متأخرة في امتحاناعلى الوظيفة تطبيقا لمبدأ »الكوتا«.
القانون 83 في مادته ص على
األولى ينص ذوي
أن لألشخاصة
اإلعاقة الفربالتقدم على قدم
المساواة مع اآلخرين.
7.هل هنالك قانون أو سياسة حكومية
ف بمبدأ المساواة تعتر
ص ص لألشخا
في الفرذوي اإلعاقة؟
المساواة
ص اتفاقية حقوق األشخا
ذوي اإلعاقة، الديباجة- هـ، المادة 3 هـ
القوانين المعتمدة- المقدمة.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة160ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ص المعوقين رقم 31 قانون حقوق األشخا
لسنة2007 المادة)7(:-ت العالقة
ت ذاد- اقتراح تعديل التشريعا
ت ص المعوقين واألنظمة والتعليما
باألشخاالالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
ص المعوقين 2007/31()األشخا
و- المشاركة في الجهود الرامية إلى ت الدولية
ف المواثيق واالتفاقياتحقيق أهدا
ص المعوقين التي المتعلقة بشؤون األشخات عليها المملكة.
صادق* االستراتيجية الوطنية المادة )3(
ف:-األهدا
ت الوطنية من خالل 1- تفعيل التشريعا
ت القائمة التوعية وتعديل التشريعا
ت الالزمة لها صدار األنظمة والتعليما
وإصة
بما يتالءم مع المعايير الدولية الخاص ذوي اإلعاقة.
بحقوق األشخات االستراتيجية الوطنية.
* األولويات الوطنية بما يتالءم
مراجعة التشريعاص المعوقين
مع قانون حقوق األشخاص ذوي
واالتفاقية الدولية لحقوق األشخااإلعاقة.
ضايا 4- التأكيد على النموذج الحقوقي لق
اإلعاقة والذي يعتبر إزالة كل أشكال ص ذوي اإلعاقة
ضد فئة األشخاالتمييز
بما في ذلك العوائق البيئية حق من حقوق اإلنسان المكفولة في كافة المواثيق
الدولية.
ث المبدأ. وفي القانون 220 كل القوانين قابلة للتعديل من حي
ص المادة 69 على إبطال أحكام لمراسيم قانونية سابقة، تن
عدة أخرى في القانون )المواد وكذلك هي الحال مع مواد
76،77، 78، 80، 88، 98،و90 من القسمين 8 و 9 من ص
2000/220 ( تبطل أحكام قوانين إدارية تخالقانون
ب وغيرها. وفي القسم ضرائ
ضمان االجتماعي والصندوق ال
ضة تعديل والريا
ص بحق المعوق في التعليم السابع الخا
ص ذوي اإلعاقة، حال األشخا
للسياسة التعليمية المتبعة في وتوسيع لبرامج الدمج المدرسي من خالل اعتبار الدمج هو
الطريقة األساسية لتعليم ذوي اإلعاقة. ب المادتين 59 و 60، يرجى مراجعة إجابة السؤال 5(
) حس
ال يوجد9. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية
تلزم الحكومة باتخاذ ت من أجل
اإلجراءاتغيير القوانين واألنظمة
ت الحالية والممارسا
ص منها إن أو التخل
كان ينشأ عنها تمييز ص ذوي
ضد األشخااإلعاقة؟
ت العامةااللتزاما
ص األشخا
حقوق اتفاقية
ذوي اإلعاقة، المادةب
4،1 أ
161 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ص المعوقين رقم 31 قانون حقوق األشخا
لسنة2007 المادة)7(:-ت العالقة
ت ذاد- اقتراح تعديل التشريعا
ت ص المعوقين واألنظمة والتعليما
باألشخاالالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
ص المعوقين 2007/31()األشخا
و- المشاركة في الجهود الرامية إلى ت الدولية
ف المواثيق واالتفاقياتحقيق أهدا
ص المعوقين التي المتعلقة بشؤون األشخات عليها المملكة.
صادق* االستراتيجية الوطنية المادة )3(
ف:-األهدا
ت الوطنية من خالل 1- تفعيل التشريعا
ت القائمة التوعية وتعديل التشريعا
ت الالزمة لها صدار األنظمة والتعليما
وإصة
بما يتالءم مع المعايير الدولية الخاص ذوي اإلعاقة.
بحقوق األشخات االستراتيجية الوطنية.
* األولويات الوطنية بما يتالءم
مراجعة التشريعاص المعوقين
مع قانون حقوق األشخاص ذوي
واالتفاقية الدولية لحقوق األشخااإلعاقة.
ضايا 4- التأكيد على النموذج الحقوقي لق
اإلعاقة والذي يعتبر إزالة كل أشكال ص ذوي اإلعاقة
ضد فئة األشخاالتمييز
بما في ذلك العوائق البيئية حق من حقوق اإلنسان المكفولة في كافة المواثيق
الدولية.
ث المبدأ. وفي القانون 220 كل القوانين قابلة للتعديل من حي
ص المادة 69 على إبطال أحكام لمراسيم قانونية سابقة، تن
عدة أخرى في القانون )المواد وكذلك هي الحال مع مواد
76،77، 78، 80، 88، 98،و90 من القسمين 8 و 9 من ص
2000/220 ( تبطل أحكام قوانين إدارية تخالقانون
ب وغيرها. وفي القسم ضرائ
ضمان االجتماعي والصندوق ال
ضة تعديل والريا
ص بحق المعوق في التعليم السابع الخا
ص ذوي اإلعاقة، حال األشخا
للسياسة التعليمية المتبعة في وتوسيع لبرامج الدمج المدرسي من خالل اعتبار الدمج هو
الطريقة األساسية لتعليم ذوي اإلعاقة. ب المادتين 59 و 60، يرجى مراجعة إجابة السؤال 5(
) حس
ال يوجد9. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية
تلزم الحكومة باتخاذ ت من أجل
اإلجراءاتغيير القوانين واألنظمة
ت الحالية والممارسا
ص منها إن أو التخل
كان ينشأ عنها تمييز ص ذوي
ضد األشخااإلعاقة؟
ت العامةااللتزاما
ص األشخا
حقوق اتفاقية
ذوي اإلعاقة، المادةب
4،1 أ
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
المعايير الدولية واإلقليمية صة بحقوق اإلنسان
الخا)الميثاق/المادة(
االستراتيجية الوطنية المادة )3( ف:-
األهدات الوطنية من
* تفعيل التشريعات
خالل التوعية وتعديل التشريعاصدار األنظمة
القائمة وإت الالزمة لها بما يتالءم
والتعليماصة
مع المعايير الدولية الخاص ذوي اإلعاقة.
بحقوق األشخاضمن:
وذلك ت الوطنية بما
* مراجعة التشريعاص
يتالءم مع قانون حقوق األشخاالمعوقين واالتفاقية الدولية لحقوق
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
ت * استكمال األنظمة والتعليما
ص المعوقين لتفعيل قانون األشخا
رقم 31 / لسنة 2007.
ص ذوي االعاقة ص القانون 2000/220 على حقوق معينة لالشخا
ينحق
، 2000/220مثل: تأهيل البيئة ) القسم الرابع من القانون
ضمنا(، وتأمين ص المعوق في بيئة مؤهلة المواد: 34 إلى 43
الشخص المعوق بالتنقل
حق الشخس الذي يتناول
ف )القسم الخامالمواق
ضمنا( ، والرعاية ص السوق، المواد 44 إلى 54
ف ورخوالمواق
صول ص المعوق بالح
ث الذي يعالج حق الشخصحية ) القسم الثال
الت الدعم، المواد: 27 إلى
صحية وإعادة التأهيل وخدمات ال
على الخدماص
ت الالزمة لألشخات المتاخمة )المعينا
ضمنا( ( وتوفير الخدما 33
ب المادة 27 من القانون 2000/220( والسكنذوي اإلعاقة حس
ص المعوق بالسكن في المواد: 55 إلى 58 ) الذي يتناول حق الشخ
ص المعوق ضة ) القسم السابع في حق الشخ
ضمنا( والتعليم والرياضمنا( والعمل) القسم الثامن
ضة ، المواد: 59 إلى 69 بالتعليم والريا
ت االجتماعية ، ف وبالتقديما
ص المعوق بالتوظيالذي يتناول حق الشخ
ضريبية) المواد87، ت ال
ض اإلعفاءاضمنا( ، وبع
المواد: 68 إلى 82 ض في حال التطبيق الكامل
88، 89، و90 على سبيل المثال( والمفترت
ضمن النطاق العام لعمل اإلداراصبح اإلعاقة
والناجع للقانون أن تت والبرامج.
ولألنظمة والسياسا
ال يوجد10. هل هنالك قانون أو
ب سياسة حكومية تتطلضمن
جعل اإلعاقة النطاق العام في القوانين
ت والبرامج؟والسياسا
ت العامةااللتزاما
ص اتفاقية حقوق األشخا
ذوي اإلعاقة، 1،4 ج
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة162ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ص المعوقين قانون حقوق األشخا
رقم 31 لسنة2007 المادة )3(:-ث العلمي
ط- تشجيع البحت في
وتغريزه وتبادل المعلومات
مجال اإلعاقة وجمع البيانات
صاءات واإلح
والمعلوماب ما
صة باإلعاقة التي تواكالخا
يستجد في هذا المجال.ف حول
ي- نشر الوعي والتثقيص المعوقين
ضايا األشخاق
وحقوقهم.* االستراتيجية الوطنية المادة)3(
ف:-األهدا
10- نشر الوعي بحقوق ص ذوي اإلعاقة بما يعزز
األشخاعملية دمجهم بالمجتمع.
2000/220ص القانون
ضمنية في نصريحة أو
ال ترد إشارة س في برامج مراكز
ث والتطوير، وليص دعم أعمال البح
صوبخ
صة باإلعاقة، وإن كان من ث المدعومة من الحكومة أجزاء خا
البحوث االجتماعية .
ب في برامج األبحاالمحتمل أن يتم إدراج هذا الجان
ث الطبية والدوائية ألننا ال نجد ث عن مجال األبحا
ضا الحديوال يمكننا أي
لها ميدانا واسعا في لبنان وربما في غيره من البلدان العربية. مع ذلك، ث،
ص المعوقين وحدة للبحضمن برنامج تأمين حقوق األشخا
ت أنشئ
ضويتي صية من جراء ع
ب معرفتي الشخ– وحس
مهمتها األساسية ب أعمال
في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لمدة أربعة أعوام، وحسص ذوي
ت المقدمة لألشخاث واقع الخدما
الوحدة المعروفة- هي بحاإلعاقة وتطويرها. ويمكن االستشهاد هنا بكالم مدير مؤسسة آرك ان ث بالتعاون
ت وحدة األبحاس، عمل
س جورج كسانتوبولسيال المهند
ب انترناشيونال فرنسا و آرك ان سيال ومجموعة األطباء مع هنديكا
ص المعوقين على تطوير المتعاقدين مع برنامج تأمين حقوق األشخا
المقعد الحراري وإنتاجه في لبنان في مشاغل أرك ان سيال . كما ض
ت في لبنان لتطوير بعتعمل الوحدة بالتعاون مع عدد من الجامعا
صادر صة باستعمال المعوقين . وتشير م
ت الخات والخدما
المنتجاب
طالالوحدة في هذا المجال إلى الدور المهم الذي أدته في تطوير
س مستعمله . ومن الجامعة اللبنانية لكرسي متنقل يعمل بحركة تنف
ث المشاركة الفعالة للوفد اللبناني ضا على نشاط وحدة األبحا
األمثلة أيس
ت أساضع
ت لجنة الخبراء التي والممثل للدول العربية في اجتماعا
ص ذوي اإلعاقة في اجتماعاتها في مقر األمم اتفاقية حقوق األشخا
المتحدة في نيويورك في كانون الثاني/يناير 2004، وفي عدد من ضا
ت الوحدة أيصة باالتفاقية . ومن مساهما
ت اللجنة الخااجتماعا
ب أحد المعاهد الفنية العليا في شمال لبنان على إنتاج جهاز مساعدة طال
س سالمة الكراسي المتنقلة ومتانتها، وهو قيد االستعمال حاليا في لقيا
البالد.تجدر اإلشارة إلى أن لبرنامج تأمين حقوق المعوقين سبعة فروع صلة عن مراكز التنمية
ف مناطق لبنان ، وهذه المراكز منففي مختل
االجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون االجتماعية ، علما أن مراكز ص ذوي اإلعاقة تماما كما
ت لألشخاض الخدما
التنمية قد تقدم بعتؤمنها للمواطنين اآلخرين من غير ذوي اإلعاقة.
ال يوجد، ومع ذلك، فإن النظام 3029 س يقوم
س لمجلأس
ث بإجراء األبحا
ت وإعداد والدراسا
ت برامج التنمية ذاالعالقة باإلعاقة.
11. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية من أجل ث والتطوير
القيام بالبحالمتعلق باإلعاقة أو
تعزيز الجهود في هذا المجال؟
ت العامةااللتزاما
ص حقوق األشخا
اتفاقية ذوي اإلعاقة، المادة 4،1،
و، ز، ح
163 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
المعايير الدولية واإلقليمية صة بحقوق اإلنسان
الخا)الميثاق/المادة(
ص قانونيال يوجد ن
ضمن ضح ي
صريح وواص
ال يوجد في لبنان أي قانون أو سياسة أو نض
ص ذوي اإلعاقة أو فرصة باألشخا
عدم انتهاك حقوق اإلنسان الخا 220
حال انتهاك هذه الحقوق. وحتى في القانون عقوبة في
أية صريح في
ص ص ذوي اإلعاقة ال يوجد أي ن
المتعلق بحقوق األشخاث عن : » تعفى من الرسوم
هذا المجال. إال أنه في المادة 97 يتحدشكوى أو التدخل فيها
على تقديم أية دعوى أو ضائية المتوجبة
القص
ف أنواعها ودرجاتها ، التي يقيمها أشخاأمام المحاكم على اختال
معوقون أو ممثلوهم القانونيون أو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ب مخالفة أي من أحكام هذا القانون تأسيسا عليه أو لعدم تطبيق
بسبصا بالمعوقين«. من هنا يمكن
س حقا خاص قانوني آخر يكر
أي نحقوق
على انتهاك ض
االستنتاج أن القانون يتيح للمعوقين االعتراب الوحيد المذكور في هذا القانون يتعلق
صة بهم. والبااإلنسان الخا
ب القطاعين صراحة على أن من واج
ص بمجال العمل. فالقانون ين
ص ذوي اإلعاقة. وفي ص تشغيل نسبة 3 بالمئة من األشخا
العام والخاص، يجري
ب العمل في القطاع الخاحال عدم االلتزام من قبل أحد أربا
ب العمل وال يتم إعطاؤه براءة ذمة لمؤسسته. ض غرامة على ر
فرولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن القانون 220 ما يزال غير مطبق حتى اآلن. وهذا هو المجال الوحيد الذي يتطرق إليه القانون ويلمح إلى
نوع من العقوبة.
ال يوجدضمن قوانين
12. هل تالدولة أن تكون هنالك عقوبة في حال انتهاك
حقوق اإلنسان ألي ص أو مجموعة من
شخص ذوي اإلعاقة؟
األشخا
ت العامةااللتزاما
ص حقوق األشخا
اتفاقية ذوي اإلعاقة، 4،1، د، هـ
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة164ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ب * االستراتيجية الوطنية/ كس
التأييد:-* بناء الوعي لدى أسر األطفال
ذوي اإلعاقة بأن يدركوا أن ب حقوق،
صحاأطفالهم هم أ
وأنه على مقدمي الخدمة االلتزام ضمان إمكانية ممارسة هذه
بالحقوق.
ص ذوي اإلعاقة، صدق لبنان على االتفاقية الدولية لحقوق األشخا
لم يص المواد
ما يجعل الكالم على تطبيق أحكامها سابقا لألوان. غير أن نضمن تطابقا بنسبة عالية بين
59 إلى 61 من القانون 2000/220 يتفكرة الدمج المطروحة في القانون اللبناني وتلك األكثر تطورا نسبيا ضاءة على المعالجة
ص لإلفي االتفاقية الدولية. ونحن هنا نورد الن
ص على: لكل القانونية والتطبيقية التي التزم بها المشرع. فالمادة 59 تن
صا متكافئة ضمن فر
ص معوق الحق بالتعليم، بمعنى أن القانون يشخ
ضمن ص المعوقين من أطفال وراشدين
للتربية والتعليم لجميع األشخات، وذلك في
ت التربوية أو التعليمية من أي نوع كانجميع المؤسسا
صة إذا استدعى األمر«. وفي المادة ف خا
صفوصفوفها النظامية وفي
»ال تشكل ص التالي:
»يختارها« في الن60 ينبغي التنبه إلى كلمة
ب أو الدخول إلى أية مؤسسة ب االنتسا
اإلعاقة بحد ذاتها عائقا دون طلت. ويعتبر بحكم
صة، من أي نوع كانتربوية أو تعليمية، رسمية أو خا
ب أو دخول إلى أية مؤسسة ب انتسا
ص يشترط ألي طلالملغى كل ن
ت، سالمة البنية صة من أي نوع كان
تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصابة بإعاقة أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من
أو الجسد أو عدم اإلت المتعلقة
ت العادية، مثل االمتحاناالتعابير واأللفاظ. تعتبر اإلجراءا
ت الدخول أو طلبا
بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول ب أو
ب االنتساض طل
ف إلى آخر، كافية لقبول أو رفص
االنتقال من صة من أي
الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصية
ب حامل لبطاقة المعوق الشخب انتسا
ت. يعطى كل طالنوع كان
صة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية أو التعليمية فر
ضلى، التي تسمح له بإجراء التي يختار، وذلك بتأمين الشروط الف
ت خالل العام الدراسي في جميع ت الدخول، وسائر االمتحانا
امتحاناعلى
61 تدل المراحل المدرسية والمهنية والجامعية....« والمادة
ص ذوي اإلعاقة وذلك صال لتعليم األشخا
ضافية المتبعة أالطريقة اإل
ت ص على : »تغطي وزارا
باعتبارها جزءا من عملية الدمج، إذ تنت التعليم
والتقني نفقاوالتعليم المهني
ضة والريا
ب والشبا
التربية ص
ص لكل شخص
صة والتعليم أو التأهيل المهني المتخوالتربية الخا
ص من وزارة الشؤون خا
ب صية وبطل
مزود ببطاقة المعوق الشخت المعنية....«
االجتماعية، وذلك من خالل عقود تنفذها مع المؤسسا
ال يوجدضمن قوانين
13. هل تص
الدولة أن األشخاذوي اإلعاقة، والسيما
األطفال، تتم استشارتهم وأنهم يدمجون بشكل
فاعل في تطبيق االتفاقية صة باإلعاقة؟
الخا
ت العامةااللتزاما
ص حقوق األشخا
اتفاقية ذوي اإلعاقة، المادة 4،2
165 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(االستراتيجية الوطنية المحور األول:
تالتشريعا
ص ذوي اإلعاقة - تغريز حق األشخا
ضاء وذلك عن في اللجوء إلى الق
ضائي مؤهل طريق إيجاد جهاز ق
ت المناسبة وكفالة حق ومهيأ للتجهيزا
ص ذوي اإلعاقة على ضي لألشخا
التقاصة من
س المساواة مع اآلخرين وخاأسا
منظور الجندر.وذلك عن طريق:ضاة.
ب الق* تدري
ب مترجمي لغة اإلشارة في المحاكم.* تدري
ص ذوي اإلعاقة ت األشخا
* متابعة حاالالذين يراجعون المحاكم.
ب العاملين.* تدري
ت البيئية.* توفير التسهيال
يعتبر اللبناني
الدستور ألحكام
وفقا جميع المواطنين متساوين أمام القانون. للمالحقين
تقدم ضائية
القوالمساعدة
في جاء
220والقانون
والمتهمين. 97 منه ليطور قليال الممارسة،
المادة ضائية لرفع
ويتيح اإلعفاء من الرسوم القالدعاوى بحق اإلدارة الحكومية أو أي صة او أهلية تنتهك أحكام القانون
جهة خا220 والحقوق التي يمنحها للمعوقين.
القانون 83 في مادته األولى صول
ب حص على وجو
ينص ذوي اإلعاقة على
األشخاص على قدم المساواة مع
الفراآلخرين.
ف دستور الدولة، 14. هل يعتر
أو أي قانون أو سياسة فيها بأن ص ذوي اإلعاقة
جميع األشخات القانون
متساوون أمام وتحوأنهم مخولون للحماية والمنافع أمام القانون على قدم المساواة
مع اآلخرين؟
المساواة وعدم التمييزص ذوي
اتفاقية حقوق األشخااإلعاقة، المادة 1،5
ال يوجدوهو الوحيد
، 220ص القانون
ال ينص ذوي اإلعاقة،
المعني بحقوق األشخاص
خاعلى اعتبار أي إجراء
صراحة والمساواة أمام
ص ضمان تكافؤ الفر
لضمن
ال يتوهو
هؤالء األفراد تمييزا. ص. لكن
صوصيلية بهذا الخ
تدابير تفف المعوق
ص توظيصو
تطبيق أحكامه بخف الحكومية ،
الناجح في امتحان الوظائت مرتبته متأخرة، احتراما لـ
حتى لو أتعليها القانون هو
ص »الكوتا« التي ين
صفه بالتمييز اإليجابي. أول تدبير يمكن و
وعلينا انتظار تطبيق هذه السياسة فعليا للحكم عليها أو معها.
القانون 83 في مادته الخامسة يشرح تبني الحكومة التونسية
لسياسة التمييز اإليجابي من خالل نظام »الكوتا«،
صول إلى وذلك في سبيل الو
المساواة.
15. هل يقر دستور الدولة أو أي قانون أو سياسة فيها بأن أيا صة بتحقيق
ت الخامن اإلجراءا
ص ذوي المساواة لألشخا
اإلعاقة ال تعد تمييزا؟
المساواة وعدم التمييز
ص ذوي اتفاقية حقوق األشخااإلعاقة، المادة 5،4
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة166ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(
ص المعوقين رقم قانون حقوق األشخا
)3( لسنة 2007 المادة )3(:-ضايا
ف حول ق)ي( نشر الوعي والتثقي
ص المعوقين وحقوقهم.األشخا
االستراتيجية الوطنية المادة)3( ف:-
األهداص ذوي
10- نشر الوعي بحقوق األشخااإلعاقة بما يعزز عملية دمجهم بالمجتمع
وذلك عن طريق:ضايا
صرة ق* حشد قادة الرأي لمنا
ص ذوي اإلعاقة.وحقوق األشخا
ت الحكومية * وتحفيز المؤسسا
ت غير الحكومية ألداء دورها والمنظما
ص ذوي اإلعاقة.تجاه حقوق األشخا
ت ت والمؤسسا
* تقرير دور الوزاراالمعنية بتنفيذ بنود االستراتيجية واالتفاقية
ص ذوي اإلعاقة.الدولية لحقوق األشخا
صريحا صا
220 نضمن القانون
ال يتتعزيز
أجل من
التوعية ص
صوبخ
ص ذوي اإلعاقة االحترام لحقوق األشخا
وكرامتهم ، لكن العمل الجاد لتطبيق أحكام القانون ، ومراقبة مدى احترامه مستوى الوعي
من األمور التي ترفع ضية. وما دام
ت الدولة بهذه القفي إدارا
صادق على االتفاقية الدولية؛ لبنان غير م
ص قانوني بشأن التوعية فإن اعتماد أي ن
مستبعدا. صعيد يبدو أمرا
هذا العلى
ت الجهة ومراكزالتنمية االجتماعية ليس
صالحية في أمور التوعية ، وإن ت ال
ذاض
بعاستعمال
أحيانا باإلمكان
كان األنشطة فيها لطرح أفكار تتعلق بالتوعية، صورة جانبية. لكن برنامج تأمين
وذلك بمع الهيئة الوطنية
وبالتعاون الحقوق
ض األنشطة لشؤون المعوقين قد ينفذ بع
ت للتوعية من حين إلى ت والحمال
والندوات ظرفية.
آخر، وهذه تتم في مناسبا
ت وزارة التعليم، وفي ظل قام
القانون 80، بالبدء باإلدخال إلى المنهاج التعليمي المواد
األساسية المتعلقة بمفاهيم حقوق اإلنسان والحرية وقبول
اآلخر، كجزء من الحركة صالحية الشاملة للنظام
اإلالتربوي.
16. هل هنالك قانون أو ب من الحكومة أن
سياسة تتطلترفع من مستوى الوعي في
الدولة من أجل تعزيز االحترام ص ذوي
لحقوق وكرامة األشخااإلعاقة؟
تعزيز الوعي العامص ذوي
اتفاقية حقوق األشخااإلعاقة، المادة 8
167 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اإلستراتيجية الوطنية/ المحور العاشر / ف والتوعية:-
اإلعالم والتثقيصحفيين
ب اإلعالميين وال* استقطا
ص ذوي اإلعاقة ضايا األشخا
صرة قلمنا
ف وتدريبهم وتطوير قدراتهم للتعري
ص ذوي اإلعاقة والتوعية بحقوق األشخا
ب صميم وسائل إعالمية تخاط
بها وتت المجتمع.
ف فئامختل
* عن طريق:صحفيين
- تطوير شبكة من الضايا اإلعاقة من
واإلعالميين المعنيين بقصل.
خالل التوات
- مع رؤساء تحرير المؤسساب األعمدة.
اإلعالمية وكتاب التأييد.
ت كست استراتيجيا
اقتراحات مع اإلعالم لزيادة
* تطوير تحالفاصانعي
وعي الجمهور بمقدمي الخدمة وص ذوي
ت حول حقوق األشخاالقرارا
اإلعاقة واحتياجاتهم وقدراتهم من خالل منظور الجندر.
بهذا معتمد
قانوني ص
نمن
س لي
وسائل ت
ص . مع ذلك اعتمدصو
الخت
اإلعالم الحكومية منذ بداية الثمانينياعاما دوليا
1981، ومع إعالن العام
ص برنامج إذاعي، صي
لإلعاقة ، سياسة تخت
والقنوات
المحطافي
تلفزيوني ثم
الحكومية ، يظهر ذوي اإلعاقة على أنهم ص منتجون في
ت وأشخاب قدرا
صحاأ
صة المجتمع. إال أن وسائل اإلعالم الخا
ال تتقيد بهذه السياسة الحكومية ، ولو أنها ث بكثير من المبالغة
تعمد أحيانا إلى الحديض المعوقين المميزين .
ت بععن قدرا
غير مذكور، ولكن اإلعالم ب قد أدى دورا مهما في
المكتورفع مستوى الوعي االجتماعي
ص ذوي ت األشخا
حول قدرااإلعاقة، من خالل الترويج
صورة اإليجابية لهؤالء لل
ص، والمطالبة الحثيثة األشخا
ضمن إطار باحترام حقوقهم. و
ب النمطي مكافحة األسلو
والتمييز وسوء المعاملة على س
س اإلعاقة وعلى أساأسا
س ت تون
س والعمر، قامالجن
بتنظيم حملة توعية حول اإلعاقة، وذلك من خالل اإلذاعة والتلفاز واإلعالم
ب.المكتو
17. هل هنالك قانون أو سياسة حكومية تشجع اإلعالم على
ص ذوي اإلعاقة إظهار األشخا
ب صحا
ص أعلى أنهم أشخا
ص ت وأنهم أشخا
إمكانيامنتجون في المجتمع؟
تعزيز الوعي العام
ص ذوي اتفاقية حقوق األشخا
اإلعاقة، المادة 8،2 ج
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة168ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(ص المعوقين رقم 31
قانون حقوق األشخالسنة 2007/ المادة )4(
ت البيئية:هـ- التسهيال
ت البناء الوطني 1- تطبيق كودة متطلبا
صادرة عن ص المعوقين ال
ص باألشخاالخا
ت العالقة في جميع األبنية في الجهة ذا
ص والمتاحة للجمهور القطاعين العام والخا
ويطبق ذلك على األبنية القائمة ما أمكن.ص البناء ألية جهة إال
2- عدم منح تراخيبعد التأكد من االلتزام باألحكام الواردة في
البند رقم )1( من هذه الفقرة.ت النقل العام
3- تأمين كل من شركات
ب تأجير السياراب السياحية ومكات
والمكاتت
صفاواسطة نقل واحدة على األقل بموا
ص المعوقين استخدامها أو تكفل لألشخا
االنتقال بها بيسر وسهولة.ص المعوقين إلى
صول األشخا4- و
ت بما في ذلك تكنولوجيا ونظام المعلوما
ت ووسائل اإلعالم المختلفة شبكة اإلنترن
ت الطوارئ بما في ذلك والمسموعة وخدما
تأمين مترجمي لغة اإلشارة.
ص حق األشخا
2000/220يكفل القانون
صول إلى البيئة المادية ذوي اإلعاقة في الو
صال، ت ووسائل االت
ووسائل النقل والمعلوماس اللذين
وذلك في القسمين الرابع والخامضمنا . وهو
يشمالن المواد 33 إلى 54 ث عن مدى الحقوق ، فيؤكد أن » لكل
يتحدص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى أن من
شخصول إلى أي مكان
ص معوق الوحق كل شخ
ص غير المعوق« صول اليه الشخ
يستطيع الوت الهندسية لكافة
صفاشرط أن تكون الموا
صة ت والمرافق العامة والخا
المباني والمنشآالمعدة لالستعمال العام ، منطبقة مع المعايير ص عليها
صوصول المن
ووفق الشروط واألفي هذا القانون،)المادة 33(.
وفي هذا المجال يركز القانون على معايير ص
ضافية، والرخالحد األدنى والمعايير اإلت المطابقة، واألبنية
وإفاداواألبنية
العامة، والمرافق
ت والمنشآ
صة المعدة لالستعمال العام ، ت الخا
والمنشآب التاهيل،
ت االستثنائية من موجواإلعفاءا
الستعمال صة المعدة
وتأهيل األماكن الخاالمعوقين ، ونشر المعايير الدنيا وتعليمها ، ت ، والشعار العالمي
ت واإلعفاءاوالغراما
س ص القانون قسمه الخام
صللمعوقين.ويخ
ص السوق، ف ورخ
للحق في التنقل والمواقالعامة
النقل وسائل
صيل بالتف
فيتناول المؤهلة وغير المؤهلة الستعمال المعوقين،
ص على أن المباني المادة 23 تن
ب أن تكون ت الطابع العام يج
ذاص
صول األشخامجهزة لو
ذوي اإلعاقة إليها. والقانون صادر في العام 2005
83 الص المادتين 10
صالذي خ
ضوع إمكانية و13 لمعالجة مو
ص ذوي صول لألشخا
الوب
اإلعاقة. والمادة 15 تتطلص يقوم ببناء البنية
من أي شخضية
التحتية للمرافق الرياب أو برك السباحة، أن
كالمالعضمن بأن يكون هذا المرفق
يصالحا
ومن خالل منشآته، صة
ضة الخالممارسة الريا
ص ذوي اإلعاقة. باألشخا
صادر والمرسوم رقم 1467 وال
في 30 أيار/ مايو من العام ،2006
ضمن القوانين أو 18. هل ت
صل ت الحكومية أن يح
السياساص ذوو اإلعاقة على
األشخاصول إلى البيئة المادية،
حق الوت
ووسائل النقل، وإلى المعلوماصال، في المناطق
ووسائل االتضرية؟
الريفية والح
صولالو
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية والمادة
،9،1اإلعاقة، المادة
ب، ج، د، هـ9،2 أ،
* قانون البناء الوطني األردني رقم 1993صة
ت البناء الخا المادة )32( كوده متطلبا
بالمعوقين:-ت الدنيا
ضع المتطلباتعني هذه الكوده بو
ب توافرها في المباني العامة والسكنية الواج
والمرافق العامة حتى يتمكن المعوقون من استخدامها بيسر وسهولة وذلك من خالل صميم المباني
ت العامة لتضع المتطلبا
وت التي يتعين توفيرها في
الجديدة والمتطلباصر الخارجية لتيسير
األبنية القائمة والعنااستعمالها من قبل المعوقين.
ت التقنية صفا
والمتعلق بالمواص
صول األشخالتسهيل و
ذوي اإلعاقة إلى المباني العامة ت والمرافق المشتركة
والفسحات الطابع
صة ذاوالمباني الخا
صادر العام. والمرسوم 1477 ال
في 30 أيار/ مايو من العام 2006 والمتعلق بتسهيل إمكانية ص ذوي اإلعاقة
استخدام األشخات.
صااللوسائل النقل واالت
169 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ف:-االستراتيجية الوطنية المادة )3( األهدا
ص ذوي صول األشخا
8- كفالة إمكانية واإلعاقة بشكل متكافئ إلى البيئة المادية
ت المحيطة ووسائل النقل والمعلوما
ت العامة ت والمرافق والخدما
صاالواالت
ت وإزالة كل العوائق في كافة محافظا
المملكة.وذلك بـ:
ت * تعديل مرافق وأبنية كافة الوزاراوالمراكز الخدمية العامة في كافة
ت )القائمة منها(.المحافظا
* تيسير كافة وسائط النقل العامة لتالئم ص ذوي اإلعاقة.
ت األشخااحتياجا
صد تنفيذ تطبيق كودة البناء * متابعة ور
ص في المرافق العامة والتوعية بها.الخا
ص ت البناء الخا
* تعديل كوده متطلباص ذوي اإلعاقة رقم 1993/32
باألشخاص ذوي
صة باألشخاكودة بناء معدلة خا
اإلعاقة.
وعقوبة المالية،
ت والحسوما
والمنافع ف العامة
ص معوق، والمواقض نقل شخ
رفصة
ف الخاوالمواق
صة للمعوقين، ص
المخف
المواقحقوق
ت ومخالفا
بالمعوقين، السوق،
ص ورخ
ب والتدري
صة، الخا
صا ت المجهزة تجهيزا خا
ضمان السياراو
ب المعوقين على القيادة.مع تدري
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة170ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(ص بالحقوق
)1( العهد الدولي الخاالمدنية والسياسية:-
صادق األردن علية دون تحفظ بتاريخ: 1975/5/28 ونشر في الجريدة الرسمية
العدد)4764( بتاريخ: 2006/6/15م.ص المادة)2(:-
تنف في هذا العهد
1- تتعهد كل دولة طرف بها فيه،
باحترام الحقوق المعتروبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد
الموجودين في إقليمها والداخلين في ب العرق أو اللون
واليتها دون تمييز بسبس أو اللغة أو الدين أو الرأي
أو الجنصل القومي أو االجتماعي
السياسي أو األب أو
أو الثروة أو النسب(.
) غير ذلك من األسبا* المادة )6(:-
1- الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وال
يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.2- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:-
3- المادة)3(:- لكل فرد الحق في الحياة صة.
والحرية وسالمة شخ
ص االتفاقية الدولية ما تن
س عك
على ذوي اإلعاقة بشأن
ص لحقوق األشخا
الحق في الحياة ، ال توجد في القوانين اللبنانية أي مواد ص ذوي اإلعاقة تكفل
صة باألشخاخا
لهم الحق في الحياة، وال يتعدى التطرق ض الجمل العامة التي تعني
إلى ذلك ببعص
صيكل المواطنين من دون أي تخ
مواد ض
ص ذوي اإلعاقة. )بعلألشخا
ت ت، عدا اتفاقيا
الدستور، وقانون العقوباعليها الدولة
ت حقوق اإلنسان التي وقع
اللبنانية(.
المادة 10 تعيد التأكيد على ص ذوي
صل لألشخاالحق المتأ
اإلعاقة بالحياة. والقانون 83 صادر في العام 2005 يكفل
الص الحق بأعلى
لهؤالء األشخامستوى ممكن من العناية ت الطبية
صحية والخدماال
ت إعادة التأهيل.وخدما
19. هل هنالك قانون أو ضمن أن يكون
اتفاقية دولية تص ذوي اإلعاقة الحق
لألشخافي الحياة على قدم المساواة مع
اآلخرين؟
الحق في الحياة
ص ذوي اتفاقية حقوق األشخااإلعاقة، المادة 10
171 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(* االستراتيجية الوطنية المادة )2(
المبادئ:-ضايا
3-التأكيد على النموذج الحقوقي لقاإلعاقة والذي يعتبر إزالة كل أشكال
ص ذوي اإلعاقة ضد فئة األشخا
التمييز بما في ذلك إزالة العوائق البيئية حق من حقوق اإلنسان المكفولة في كافة المواثيق
الدولية.
صة بحقوق المادة التشريعية الوحيدة الخا
هي القانون في لبنان
ذوي اإلعاقة ال يتطرق مباشرة إلى هذا
220 الذي ألحكامه
ضوع . لكن التنفيذ الجدي المو
ص على االحترام الكامل والدقيق التي تن
صورة غير ضمن ب
لحقوق المعوقين، قد يمباشرة تأمين حقهم في الحرية والسالمة صادقة على
صية . وإلى أن تتم المالشخ
في وإدخال أحكامها
االتفاقية الدولية ب القوانين اللبنانية، يظل هذا الحق
صلضع
هو موغير محترم بالكامل ، أو
اجتهاد الحقوقيين ورجال القانون استنادا ت حقوق اإلنسان الدوالية غير
إلى اتفاقيات الدولة اللبنانية عليها
الملزمة التي وقع
تم تعديل المادة 13 من ص تحديدا على أن
الدستور لتنص الذين حرموا
هؤالء األشخاب أن يعاملوا
من حريتهم، يجبإنسانية واحترام لكراماتهم.
القانون 83 للعام 2005، في المادة 18 من التشريع التونسي ص ذوي
يشدد على أن األشخاب أن يتمكنوا من
اإلعاقة يجضمن بيئتهم البيتية من
البقاء دون حرمانهم من حريتهم
ب إعاقتهم.بسب
20. هل هنالك قانون أو سياسة ضمن أن يتمتع
حكومية تص ذوو اإلعاقة بالحق
األشخاصية
في الحرية والسالمة الشخعلى قدم المساواة مع اآلخرين؟
والسالمة الحق في الحرية
صيةالشخ
بحقوق صة
الخااالتفاقية
اإلعاقة، ذوي
ص األشخا
المادة 14
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية المعايير الدولية
اإلنسان بحقوق
صة الخا
)الميثاق/المادة(ت على
صل الثاني : جاء* الدستور / الف
العموم.المادة )5( الجنسية األردنية تحدد بقانون.
صونة.صية م
المادة )7( الحرية الشخالمادة )9(:-
1-ال يجوز إبعاد أردني عن ديار المملكة.
2-ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما وال أن يلزم باإلقامة في مكان
معين إال في األحوال المبينة في القانون
ص لألشخا
2000/220القانون
يكفل ث
ذوي اإلعاقة حقهم في التنقل والسكن حيكما يرد في األقسام الرابع
ما يناسبهم، ضاءة
س )للمزيد من اإلوالساد
س والخام
على هذه األقسام ، يمكن إلقاء نظرة على على
185 و
عدد من األسئلة، ت
إجاباسبيل المثال(. والدستور في مادته السابعة صول جميع اللبنانيين على جنسيتهم
يكفل حضمن الموانع.
دون تمييز وال يذكر اإلعاقة ضي
لكن منح الجنسية للمولودين على األراب
غير متاح قانونا، واألسبااللبنانية أمر
وراء ذلك سياسية واجتماعية ، وال سيما أن صر البشرية
صدرة للعنالبنان من الدول الم
س على حماية حرية ت تون
لقد عملالتنقل والجنسية. فكل المواطنين، ص ذوو اإلعاقة،
بمن فيهم األشخاعند
وجنسية باسم
الحق لهم
حيثما الوالدة، وفي كل األحوال
يتوافر الحق بالجنسية التونسية. مع
مكتسبا يكون
وهذا الحق عليه
ص ما تن
ب الوالدة بحس
األنظمة الوطنية، المادة 7. وتبعا عليه دستورها، المادة
ص لما ين
س لكل مواطن الحق 10، تكفل تون
مناطقها، داخل
بحرية بالتنقل
ضيها، وحق اإلقامة ومغادرة أرا
ضمن المجال الذي تسمح به القوانين الوطنية.
21. هل هنالك قانون أو ضمن أن
سياسة حكومية تص ذوو اإلعاقة
يتمتع األشخابحقهم في حرية التنقل والحق ب
في الجنسية دون تمييز بسباإلعاقة؟
في والحق
التنقل حرية
الجنسية
ص ذوي اتفاقية حقوق األشخااإلعاقة، المادة 18
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة172ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
)1(ال يوجد
صة خا
ت أو قوانين سياسا
ال توجد أي خالل
ذوي اإلعاقة ص
بحماية األشخات الخطر. وقد تجلى ذلك
ب وحاالالحرو
ب خالل عدوان تموز 2006 وكافة الحرو
ت أنه وخالل شهدها لبنان. وما يلف
التي ص ذوو اإلعاقة،
ت الخطر كان األشخاحاال
مستخدمو الكراسي المتحركة، صة
وبخاضمن مناطق القتال لتعذر نقلهم مع
يتركون ت
كراسيهم. ولوال الجهود الجبارة التي قامت من
ضى العشرات األهلية لق
بها الجمعياض.
ت األنقاص تح
هؤالء األشخا
الخطر ت
حاال ،،11
للمادة وفقا
ت صراعا
التشمل
التي ت
كالحاالث
المسلحة والطوارئ اإلنسانية والكوار 2
صادر في 11 ال
الطبيعية. القانون وفي
،2009س من العام
آذار/ مارص
24، ينمن المادة
الفقرة األولى ص بالمباني
على أن نظام األمان الخاب أن يشمل كل
ت الطابع العام، يجذا
كافة تغطي
ت العامة التي المتطلبا
صة ت الخا
والمتطلباأنواع المباني،
بأنواع محددة من المباني، وذلك على صميم
والتوالحجم
الوظيفة س
أساب
ب،، بما فيه استيعاوقدرة االستيعا
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
هل تعمد الحكومة من .22
خالل قانون أو سياسة حكومية ت
على اتخاذ اإلجراءامعينة
الالزمة من أجل حماية سالمة ص ذوي اإلعاقة في
األشخات الخطر؟
حاال
ت والحاال
الخطرة ف
الظرواإلنسانية الطارئة
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 11
173 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص المعوقين قانون حقوق األشخا
2007 المادة رقم )31( لسنة
ضي:-)4( التقا
المساعدة ت
التقنياتوفير
*ص المعوقين بما في ذلك
لألشخاترجمة لغة اإلشارة.
وزارة العدل * استراتيجية /
-:2012 – 2008القانونية
المساعدة تقرير
*ت
والفئاالدولة
ت لمؤسسا
ضعفة.المست
لشؤون الوطنية
االستراتيجية ص المعوقين:
األشخاالمحور
الوطنية االستراتيجية
تاألول: التشريعا
ص ذوي حق األشخا
- تغريز ضاء،
اإلعاقة في اللجوء إلى القجهاز
طريق إيجاد عن
وذلك ت
ضائي مؤهل ومهيأ للتجهيزاق
ضي حق التقا
وكفالة المناسبة
على ذوي اإلعاقة
ص لألشخا
اآلخرين مع
المساواة س
أساصة من منظور الجندر.
وخاوذلك عن طريق:ضاة.
ب الق* تدري
ب مترجمي لغة اإلشارة * تدري
في المحاكم.ص ذوي
ت األشخا* متابعة حاال
اإلعاقة الذين يراجعون المحاكم.ب العاملين.
* تدريت البيئية.
* توفير التسهيالص ذوي
حق األشخا* تقرير
ضاء:اإلعاقة في اللجوء إلى الق
ب المحامين.- تدري
ب ضائي في لبنان متاح بموج
النظام القاإلدارية
والممارسة والقوانين
الدستور ب
جميع المواطنين دون تمييز بسبأمام
صحيح من الناحية المبدئية. اإلعاقة. هذا
ص في مادته إال أن القانون 2000/220 ن
97 على: ضائية المتوجبة
» تعفى من الرسوم القعلى تقديم أية دعوى أو شكوى أو التدخل ف أنواعها
على اختالفيها امام المحاكم
ص معوقون ودرجاتها ، التي يقيمها أشخا
أو ممثلوهم القانونيون أو الهيئة الوطنية ب مخالفة أي من أحكام
لشؤون المعوقين بسبعليه أو لعدم تطبيق
هذا القانون تأسيسا صا
خاحقا
س ص قانوني آخر يكر
أي نعلى كافة
بالمعوقين. وتطبق هذه المادة ف أنواعها :
ت المحاكمة وعلى اختالدرجا
جزائية، مدنية، إدارية، عسكرية، مذهبية، يرفع
وهذا وغيره«.
صية شخ
أحوال ص
مستوى التعاطي القانوني مع األشخاعلى
صول ذوي اإلعاقة لتمكينهم من الح
الدعم لممارسة أهليتهم القانونية، واحترام حقوقهم وقراراتهم ورغباتهم.
صادر في العام 2005، القانون 83 ال
صا ص ذوي اإلعاقة فر
يكفل لألشخاعلى قدم المساواة
متساوية ومعاملتهم مع اآلخرين.
دستور ضمن
يهل
.23من
ذلك غير
الحكومة أو األنظمة التشريعية فيها أن ص ذوي اإلعاقة
يكون لألشخاصول
أهلية قانونية وإمكانية وضائي على قدم
فعالة للنظام للقالمساواة مع اآلخرين؟
في والحق
القانونية األهلية
ضاءصول إلى الق
الو
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 12 والمادة 13
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة174ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
االستراتيجية الوطنية المادة)3( ف:-
األهداكافة
مواجهة من
الحد -11
ف ت التي قد تلحق العن
الممارساص
واإلساءة واالستغالل باألشخاذوي اإلعاقة وتقليل نسبها وفق
خطط منهجية محكمة وذلك بـ:*رفع مستوى الوعي المجتمعي ص
ف األشخاتعري
عدم حيال
ت التي ذوي اإلعاقة للممارسا
ف أو إساءة عن
على تنطوي
ف عنها.واستغالل وأهمية الكش
وسرعة استجابة كفاءة
*زيادة ت الحكومية
والمؤسساالمجتمع
الحكومية وغير
والوطنية ت التي
كافة الممارسالمواجهة
ف واإلساءة واستغالل ب العن
تسبص ذوي اإلعاقة.
األشخات العاملة
كفاءة المؤسسا*رفع
ص ذوي في مجال وقاية األشخا
حيال أدوارها
لتقوية اإلعاقة
ب تسب
التي ت
الممارسامنع
واالستغالل واإلساءة
ف العن
ص ذوي اإلعاقة وكفاءة لألشخا
المجتمع استجابة
وسرعة ت الحكومية والوطنية
والمؤسساكافة
وغير الحكومية لمواجهة ف
ب العنت التي تسب
الممارساص
واإلساءة واالستغالل لألشخاذوي اإلعاقة
سياسة صريح، أو
ص قانوني س من ن
ليص ذوي
حكومية محددة، ، لحماية األشخاف أو
ب أو العنض للتعذي
اإلعاقة من التعراالستغالل. مع ذلك ، باإلمكان التوسع في تفسير المادة 97 من القانون 220 الوارد عن أسئلة
ضمونها في اإلجابة ذكرها وم
ضون هؤالء االستمارة ، لمالحقة من يعر
واالستغالل ب
والتعذيف
ص للعناألشخا
سعي شريطة
ولكن ضائية،
للمالحقة القالمحامين إلى االستعانة بالمواد القانونية ت أو غيره
المناسبة في أحكام قانون العقوبامن القوانين النافذة المفعول في البالد.
القانون 83 من العام 2005، وفي مادته ص
حماية األشخاعلى
ص الثالثة، ين
صادي ذوي اإلعاقة من االستغالل االقت
وكل والهجران،
والتشريد والجنسي،
ما يعتبر من أشكال المعاملة المهينة والالإنسانية.
قانون أو هنالك
هل .24
تحمي حكومية
سياسة ص ذوي اإلعاقة من
األشخاف
ب أو العنض للتعذي
التعرواالستغالل؟
ب التعذي
عدم في
الحق واالستغالل واإليذاء
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 15 والمادة 16
القوانين المعتمدة 9
175 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ال يوجدص القانون 220
ب شىء يرد في نإن أقر
ص ص السالمة الجسدية لألشخا
صوبخ
االستشفاء بتوفير
يتعلق اإلعاقة
ذوي ب وج
ت العقلية كما يرد في الفقرتين للحاال
ص ال يتناول مسألة من المادة 29. لكن الن
صريح. وبما أن الموافقة واالختيار بشكل
17 من االتفاقية ص الوارد في المادة
النومبهم ، فإن تأويله يتحمل
عام الدولية
وجوها عدة ، وقد ال يؤخذ بتفسيره اإليجابي صادقة
الكامل المشار إليه هنا حتى بعد المعلى االتفاقية.
والجسدية النفسية
السالمة احترام
حماية سبيل المثال،
على بما يشمل
ت ص ذوي اإلعاقة من المعالجا
األشخاالطبية وغيرها التي تتم من دون الموافقة المعني،
ص للشخ
والمعلنة الحرة
والنساء ت
حماية الفتياضافة إلى
باإلض
ت اإلعاقة من التعقيم واإلجهاذوا
على أن ص
17، تناإلجباري. المادة
ص ذوي اإلعاقة الحق لجميع األشخا
باحترام سالمتهم الفكرية والجسدية على قدم المساواة مع اآلخرين.
25. هل هنالك قانون أو سياسة ضمن أن يتمتع كل
حكومية تص ذوي
ص من األشخاشخ
لكرامته باالحترام
اإلعاقة قدم
على والعقلية
الجسدية المساواة مع اآلخرين؟
صكرامة الشخ
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 17
المتساوية بالحقوق
ف تعتر
س تون
ليعيشوا اإلعاقة
ذوي ص
لألشخات مساوية
خياراضمن المجتمع، مع
ت الكثير ت اآلخرين، وقد اتخذ
لخيارات لتسهيل التمتع الكامل
من اإلجراءاص بهذا الحق
من قبل هؤالء األشخاضافة إلى االندماج الكلي والمشاركة
باإلص
الكاملة في المجتمع. ويمكن لألشخاذوي اإلعاقة أن يعيشوا في بيئة عائلية وأن يختاروا مكان إقامتهم، وهم غير ضمن
ملزمين أن يعيشوا في مؤسسة أو 83 للعام
والقانون صل.
منفمجتمع
ب من 2005، وفي مادته ال13، يطل
ضمن ت السكنية العامة أن تت
المجمعاص ذوي اإلعاقة.
مساكن مجهزة لألشخا
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة176ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص المعوقين قانون حقوق األشخا
رقم 31 لسنة 2007 المادة )4( / ت البيئية:-
التسهيالت المعقولة
و- توفير التجهيزاص المعوق من التمتع
لتمكين الشخبحق أو حرية ما أو لتمكينه من
االستفادة من خدمة معينة.ت
* المادة )4( و / اإلعفاءاضريبية.
الجمركية والت المعقولة
1- إعفاء التجهيزاص المعوقين بما في ذلك
لألشخاضية
المواد التعليمية والطبية والريات
والوسائل المساعدة واألدوات وإعفائها من الرسوم
واآلالضريبية العامة على
الجمركية والت
ت ورسوم طوابع الوارداالمبيعا
ب أخرى ضرائ
وأية رسوم أو صدر لهذه الغاية.
ص نظام يصي
تخ2-إعفاء واسطة نقل واحدة ص المعاق
الستخدام الشخولمرة واحدة والرسوم الجمركية ت
ضريبية العامة على المبيعاوال
ت وأي ورسوم طوابع الواردا
رسوم أخرى.* هيئة تنظيم النقل العام / المادة ت
صة بحافال)20( الشروط الخا
ص المعوقين.األشخا
ص م/هـ وم 5/ج ))استنادا إلى ن
ب قرار من قانون النقل العام للركا
رقم 2006/39 العدد 5020 صفحة
تاريخ 2010/3/16 ))1667/1659
صادق لبنان حتى اآلن على االتفاقية الدولية لم ي
ص ذوي اإلعاقة، ومن ثم فهو لحقوق األشخا
حتى غير ملزم بتطبيق أي بند من بنودها
220 المتعلق بحقوق اآلن. أما في القانون
ضمن مواد ص ذوي اإلعاقة؛ فإنه يت
األشخاصبح
ث تتركز على تجهيز وسائل النقل بحي
ذوي اإلعاقة ص
الستخدام األشخامؤهلة
صولهم إلى المرافق العامة، ولكنه لتسهل و
ص ذوي صيل تنقل األشخا
ال يتناول بدقة تفاس من القانون يشرح
ب الخاماإلعاقة. فالبا
ب نسبة وسائل النقل المجهزة وكيفية بإسها
ضافة إلى وجود المساعدين، تجهيزها، باإل
ص ذوي صة باألشخا
ص المقاعد الخاصي
وتخضح أن القانون اللبناني
وهكذا يتاإلعاقة.
ص ذوي اإلعاقة لم يتطرق المتعلق باألشخا
ص المعوق، ت الفردية لتنقل الشخ
إلى الحاجات العامة
بل اكتفى بتحديد ومعالجة الحاجات،
ف السياراومواق
المتمثلة بوسائل النقل صول
على تذاكر السفر، والحت
والحسوماعلى دفاتر السوق.
قد تم ت المالئمة
من التعديالالعديد
ت ضمن األبنية المدنية، والمقرا
إجراؤها النقل
ووسائل الحكومية،
والمرافق ضافة إلى تأمين
العامة وغير ذلك. وباإلت وتكنولوجيا
اإلعاقة، يتم توفير المعلوماعلى
صول بالح
والسماح ت،
صاالاالت
صادي ت التي تروج لالندماج االقت
الخدماواالجتماعي.
27. هل هنالك قانون أو سياسة ت
اإلجراءالتعزيز
حكومية ضمن حق الحركة والتنقل
التي تذوي
ص لألشخا
صي الشخ
اإلعاقة؟
حرية الحركة والتنقل
ذوي ص
حقوق األشخااتفاقية
اإلعاقة، المادة 20
177 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص المعوقين حقوق األشخا
قانون رقم 31 لسنة 2007 المادة )4( هـ
ت البيئية:-التسهيال
ص المعوقين صول األشخا
و -4
ت بما إلى تكنولوجيا ونظم المعلوما
ووسائل ت
شبكة اإلنترنفي ذلك
اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة ت الطوارئ بما في
والمقرؤة وخدماذلك تأمين مترجمي للغة اإلشارة.
والتعليم ب / التعليم
المادة )4( العالي
ت المعقولة التي تساعد 3- التجهيزا
على التعلم ص المعوقين
األشخاب والحركة بما
صل والتدريوالتوا
في ذلك طريقة برايل ولغة اإلشارة ت
التجهيزامن
وغيرها صم
للالالزمة.
نعم بالنسبة الى الحق في التعليم المعتبر جزءا حرية التعبير والرأي والحق
ال يتجزأ من ت . لكن القانون
صول إلى المعلومافي الو
ت الرسمية عن تقديم المعلوما
ث ال يتحد
ص ذوي اإلعاقة عند حاجتهم إليها ، لألشخا
وال يعنى بتشجيع اإلعالم على تقديم خدماته ص ذوي اإلعاقة
بالطرق التي يمكن لألشخامنها. لعل الدوافع
واإلفادة صول اليها
الوس هذا
التجارية تساعد بادى األمر في تكريب القوانين بعد
صلالحق على أمل إدخاله في
صادقة على االتفاقية الدولية.الم
مواءمة على أن
ص المادة األولى تن
ص ت األشخا
ت لحاجاصاال
اإلعالم واالتاإلعالم
مواءمة يعني
اإلعاقة ذوي
وتسهيل ب،
والمكتووالمسموع
المرئي ص،
هؤالء األشخامن قبل
استخدامه صول إلى
هؤالء من الووبذلك يتمكن
ت. المادة الثانية من واستخدام المعلوما
ت مؤسسا
على أن تقوم ص
النظام تنص بتوفير لغة اإلشارة
اإلعالم العام والخاعلى الشاشة، وذلك
والعناوين المكتوبة ص ذوي
ضمان إمكانية متابعة األشخال
والمسموعة، المرئية
للبرامج اإلعاقة
وتحديدا األخبار العاجلة.
28. هل هنالك قانون أو سياسة ص
لألشخاضمن
تحكومية
التعبير حرية
اإلعاقة ذوي
صول إلى والرأي والحق في الو
ت؟المعلوما
والحق في الحرية في التعبير
تصول إلى المعلوما
الو
ذوي ص
حقوق األشخااتفاقية
والمادة ،21
المادة اإلعاقة،
ب، ج، و 24،224،3 أ،
صم من خالل صل لل
1- وسائل التواتوفير أشكال من المساعدة بما في
ذلك تأمين مترجمي لغة اإلشارة.صول على
ضمان حق الح* قانون
ت رقم 47 لسنة 2007.المعلوما
صول 1- لكل أردني الحق في الح
ت التي يطلبها إذا على المعلوما
ب صلحة مشروعة أو سب
ت له مكان
مشروع وفقا ألحكام هذا القانون / وزارة العدل.
* االستراتيجية الوطنية المادة )3( ف:-
األهداص ذوي اإلعاقة
صول األشخا4- ح
خالل حقهم في التعليم من
على ص
إيجاد بيئة تعليمية دامجة لألشخاذوي اإلعاقة ذكورا وإناثا وفي كافة
ت بشكل متكافئ.المحافظا
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة178ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
* وذلك عن طريق:ت التربوية بما
1- تعديل التشريعاص
يتالءم مع اتفاقية حقوق األشخاحقوق
وقانون اإلعاقة
ذوي ص المعوقين.
األشخات
برامج الدمج لفئاتعزيز
-2وإيجاد الكوادر
اإلعاقة المتنوعة المؤهلة في وزارة التربية والتعليم.
ذوي ص
األشخاصول
ح -5
اإلعاقة على حقهم في التعليم العالي من خالل إيجاد بيئة تعليمية دامجة ذكورا
ذوي اإلعاقة ص
لألشخات بشكل
وإناثا وفي كافة المحافظامتكافئ.
وذلك :-ص
صول لألشخا* تيسير سبل الو
ت ذوي اإلعاقة في كافة الجامعا
ت الخدما
توفير ذلك
في بما
المساندة وإعادة تأهيل البيئة وتوفير متفرغين
إشارة لغة
مترجمي لخدمة الطلبة وتوفير مناهج بطريقة
بريل وتوفير برامج ناطقة.
179 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(ص المعوقين رقم 31
قانون حقوق األشخالسنة 2007 المادة)3(:-
ص المعوقين حقوق األشخا
1- احترام وكرامتهم وحرية اختيارهم واحترام حياتهم
صة.الخا
* االستراتيجية الوطنية المادة)3( المبادئ:- ص ذوي اإلعاقة بما
2- استقاللية األشخاصيرهم وتحديد
في ذلك الحق في تقرير مخياراتهم.
ت 11- الحد من ومواجهة كافة الممارسا
واستغالل وإساءة
ف التي قد تلحق العن
ص ذوي اإلعاقة وتقليل نسبها وفق باألشخا
خطط منهجية محكمة.
ص س الحقوق التي ين
ض بتكريمن المفتر
ضمنا وتأمينها صراحة و
عليها القانون 220 ضمن احترام
والتام أن يب
بالشكل المناسحد
ص ذوي اإلعاقة إلى صية األشخا
صوخ
ضروري وعي هذه الحقيقة والعمل بعيد. من ال
ضعها حيز التنفيذ ، وذلك طالما ضمان و
على وحتى بعد
على االتفاقية. صادق لبنان
لم يصادقة، ال ينبغي االستكانة عن متابعة هذا
المال تعني إدخال أحكام
صادقة ألن الم
األمر؛ صادقة
ب القوانين ما لم تتم المصل
االتفاقية في ضا.
على البروتوكول االختياري أيوالحقوق التي يكرسها القانون 2000/220، صيال في أكثر من
ت اإلشارة إليها تفالتي سبق
ضمنا على نهج فكري وقانوني ب تؤكد
جواص ذوي
صية األشخاصو
خضمن احترام
ياإلعاقة.
المادة السابعة من الدستور التونسي تكفل للمواطنين
التمتع الكامل بحقوقهم بما يتواءم مع األنظمة والشروط المحددة في
القانون.
29. هل هنالك قانون أو ضمن
تحكومية
سياسة صية
صولخ
االحترام ص ذوي اإلعاقة؟
األشخا
صيةصو
احترام الخ
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 22
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة180ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخابحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة(
)1(ص المعوقين رقم 31
قانون حقوق األشخالسنة2007 المادة )3(
ص المعوقين حقوق األشخا
أ- احترام واحترام
اختيارهم وحرية
وكرامتهم صة.
حياتهم الخاصحة
المادة )4( 4/ الصحية األولية للمرأة المعوقة
الرعاية الخالل فترة الحمل والوالدة وما بعد الوالدة.
المادة )4( د/الحياة االجتماعيةالمعوقين
ص األشخا
أسر ب
تدري -1
ص المعوق على التعامل السليم مع الشخ
س كرامته أو إنسانيته.صورة ال تم
ب2- دمج الطفل المعوق ورعايته التأهيلية داخل أسرته. وفي حال تعذر ذلك تقدم له
الرعاية التأهيلية البديلة.
220 المتعلق بحقوق ال يتطرق القانون
ص ذوي اإلعاقة إلى هذا النوع من األشخا
الحقوق، لكنه اكتفى بالتطرق إلى النواحي والتعلم
والعمل؛ صحة؛
مثل: الالخدماتية،
ت من المعلوم أن لبنان لم إلى آخره، وقد با
صادق حتى اآلن على االتفاقية الدولية لحقوق ي
ص ذوي اإلعاقة، ومن ثم فهذه الحقوق األشخا
ص عليها فيها غير ملزمة للبنان بعد.صو
المن
ال يوجد30. هل هنالك قانون أو ضمن
تحكومية
سياسة والعائلة
المنزل احترام
ذوي ص
األشخالجميع
اإلعاقة؟
احترام المنزل والعائلة
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 23
181 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(ص المعوقين رقم
* قانون حقوق األشخاب/التعليم
31 لسنة2007 المادة )4( والتعليم العالي:
ص التعليم والتعليم المهني والتعليم 1- فر
ت ب فئا
ص المعوقين حسالعالي لألشخا
ب الدمج.اإلعاقة من خالل أسلو
2- اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين وأقرانهم من غير المعوقين
ت التعليمية.وتنفيذها في إطار المؤسسا
3- إيجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين.
4- برامج في مجال اإلرشاد والتوعية ف للطلبة المعوقين وأسرهم.
والتثقي5- قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا
امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق س
س ومجلشروط يتفق عليها بين المجل
ت الرسمية.التعليم العالي للقبول بالجامعا
صم من خالل صل لل
6- وسائل التواتوفير أشكال من المساعدة بما في ذلك
تأمين مترجمي لغة اإلشارة.س التعليم العالي رقم 320
* )قرار مجلتاريخ 2007/9/19(.الجلسة رقم
ص 2007/16.المتعلق بتمكين األشخا
ت صول إلى مؤسسا
المعوقين من الوت البيئية.
التعليم العالي وتوفير التسهيال*االستراتيجية الوطنية المادة)3(
ف:- األهدا
ص ذوي اإلعاقة على صول األشخا
7- ححقهم في التعليم من خالل إيجاد بيئة
ص ذوي اإلعاقة تعليمية دامجة لألشخا
ت بشكل ذكورا وإناثا وفي كافة المحافظا
متكافئ.وذلك عن طريق:
ضمون الحق في التعليم في القانون ب م
يتقارضمون
220 )المواد 59 إلى 65 ( كثيرا مع مض
المادة 24 من االتفاقية الدولية ، ما يجعل بعص القانون اللبناني
ت البسيطة إلى نضافا
اإلصا محدودا في التزاماته بعد
تكمل ما يعد نقعلى االتفاقية الدولية. للمزيد من
صادقة الم
ص المادتين 59 و ضاءة ، يرجى مراجعة ن
اإلس.
ب الخام60 المدونتين في الجوا
القانون 80 للعام 2002، ت مراجعته
الذي تمواستكماله من خالل
القانونين 9 و10 للعام 2008، وفي مادته
ص على أن الرابعة، ين
ب أن تسعى الدولة يج
ف المناسبة إليجاد الظرو
لتمتع األطفال ذوي صة بهذا
ت الخاالحاجا
ص المادة الثانية الحق. وتن
من القانون نفسه على أن ب أن يتم على
التعليم يجس المساواة ومن دون
أساأي تمييز. القانون 83
للعام 2005، وفي مادته ،19
ص على أن الدولة ين
ب أن تكفل أن لألطفال يج
ذوي اإلعاقة، الحق باإلرشاد والتعليم والتأهيل
ضمن نظام ب
والتدريب تمتعهم
اعتيادي، ويجس
بهذه الحقوق على أساالمساواة مع اآلخرين. والمواد 21 إلى 25
من القانون تكفل التعليم ب، بما
والتأهيل والتدريت
ب مع الحاجايتناس
صة لألطفال ذوي الخا
اإلعاقة غير القادرين على ضمن النظام
االنخراط التعليمي والتدريبي العام. ومع ذلك، فإن القانون 80
31. هل هنالك قانون أو ضمن أن
سياسة حكومية تص
جميع األشخاصل
يحذوي اإلعاقة على التعليم؟
التعليم
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 24
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة182ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ت اإلعاقة - تعزيز برامج الدمج لفئا
في وإيجاد الكوادر المؤهلة
المتنوعة وزارة التربية والتعليم.
ت وتوفير التسهيال
مراجعة المناهج -
خالل / دعم توفير المرافق وذلك من
ووسائل نقل مسهلة ت التعليمية
والمعداص ذوي اإلعاقة.
ت األشخاب احتياجا
حست التربوية بما يتالءم
- تفعيل التشريعاص ذوي اإلعاقة
مع اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين
وقانون حقوق األشخا*التعليم العالي وذلك عن طريق:
ص ذوي صول األشخا
- تيسير السبل لوت بما في ذلك
اإلعاقة في كافة الجامعاوإعادة تأهيل
ت المساندة توفير الخدما
البيئة وتوفير مترجمي لغة إشارة متفرغين لخدمة الطلبة وتوفير مناهج بطريقة بريل
وتوفير برامج ناطقة.ص ذوي اإلعاقة على
صول األشخا8- ح
حقهم في التعليم العالي من خالل إيجاد بيئة ص ذوي اإلعاقة
تعليمية دامجة لألشخات بشكل
ذكورا وإناثا في كافة المحافظامتكافئ.
للعام 2002 حول التربية ضمن أي بند
والتعليم، ال يتس
لمنع التمييز على أسااإلعاقة، بينما يمنع القانون س
تحديدا التمييز على أسس والطبقة االجتماعية
الجنوالعرق والدين.
183 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(
ص المعوقين رقم حقوق األشخا
* قانون صحة:-
31لسنة2007 المادة )4(/أ/الصحي بما
ف ال1- البرامج الوقائية والتثقي
ف ت الالزمة للكش
في ذلك إجراء المسوحات.
المبكر عن اإلعاقاصدار
ف العلمي وإص والتثقي
2- التشخيص المعوقين.
التقارير الطبية لألشخاوالنفسي
الطبي التأهيل
ت خدما
-3ت العالجية بمستوياتها المختلفة
والخدماصول عليها بكل يسر.
والحصحية األولية للمرأة المعوقة
4- الرعاية الخالل فترة الحمل والوالدة وما بعد الوالدة.ص
صحي مجانا لألشخا5- منح التأمين ال
صدر لهذه الغاية.ضى نظام ي
المعوقين بمقت83/لسنة
رقم صحي
* نظام التأمين ال2004
بحقوق المتعلق
220القانون
ضمن يت
صا يتعلق خا
ص ذوي اإلعاقة بابا األشخا
صحة، وهو قانون متقدم، يشتمل بالحق في ال
صحية كافة، على النواحي ال
ث في بابه الثال
ت التي جميع الخدما
صيل ض بالتف
ويستعرعليها.
صول ص المعوق الح
يستطيع الشخجميع أنواع
على صول
ضافة إلى الحفباإل
مثل: ت الطبية المطلوبة،
والعالجااألدوية
العالج الفيزيائي؛ واالنشغالي؛ والنفسي إلى ص ذوي اإلعاقة
آخره، يوفر القانون لألشخات االستشفائية
والخدمات الجراحية
العمليااألجهزة
جميع يؤمن
فإنه كذلك،
كافة. ضية والوسائل الطبية المساعدة، ويوفر
التعويب المتمثل بالتأهيل وإعادة التأهيل.
التدري
القانون 83 للعام 2005، وفي مواده 13_15
ص ص على أنه لألشخا
ينذوي اإلعاقة الحق
بالتمتع بالعالج المجاني ضمن
ب والدواء والتدري
المرافق العامة، مع وجود ف
ص باألطرابند خا
ف تقوم صناعية. وسو
الالدولة بتحمل كلفة هذه
ت للفقراء من الخدما
ص ذوي اإلعاقة، األشخا
صندوق وكذلك يفعل ال
االجتماعي مع األفراد وأولياء أمورهم. وقد
ت إلى ت هذه السياسا
أدت التالية: الحد
التغيراض
من الكثير من األمراواألوبئة، توافر الرعاية صحية الوقائية لجميع
الضافة
ت االجتماعية، إالفئا
ت جديدة لبرنامج لقاحا
التلقيح الوطني للعام 2005، دعم الجهود
ضمن القوانين 32. هل ت
ت الحكومية أن والسياسا
ص جميع األشخا
صل يح
على أعلى ذوي اإلعاقة
من الممكنة
ت المستويا
دون صحية
الالرعاية
س أسا
على التمييز
اإلعاقة؟
صحةال
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 25
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة184ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المادة )15(س
صدرها مجلت ي
ضى تعليماتحدد بمقت
س ب الوزير، أس
الوزراء، بناء على تنسيوشروط عدم استيفاء أجور المعالجة في ص أو
المستشفى والمراكز ألي من األشخات التالية:
الحاالض النفسية والعقلية
صابين باألمراأ- الم
وفقا للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.صحي المادة )26(:-
* نظام التأمين الدون
األردنيين األطفال
معالجة يتم
في المراكز في العمر
سن السادسة صحة مجانا
ت التابعة لوزارة الوالمستشفيا
صحي شمولهم بأي تأمين
عدم شريطة
آخر. )3(
المادة الوطنية
االستراتيجية *
ف:- األهدا
ص ذوي اإلعاقة على صول األشخا
2 - حت
صحية بما في ذلك إيجاد آليات
خدماص
والتشخيف المبكر
أكثر فاعلية للكشوالتدخل المبكر واإلحالة.
* وذلك عن طريق:صول إلى
ث للو- تعزيز برامج البح
األطفال المتأخرين نمائيا وربطها ببرامج ف والتدخل المبكر.
الكش
ضوع الوقاية مو
س القانون اللبناني ولم ين
صا، صو
خوالتدخل المبكر، كما أنه اهتم ،
صحية. من هنا يتبين أن ت التوعية ال
بحمالصحة، إذا ما تم تطبيقه،
ب المتعلق بالالبا
ص صحية الشاملة لألشخا
سيؤمن التغطية الال يتطرق
من أنه ذوي اإلعاقة، بالرغم
مثل: ض األمور الدقيقة،
صيل إلى بعبالتف
ت الجنسية لهؤالء صحة اإلنجابية؛ والعالقا
الص.
األشخا
ب األطباء في مجال لتدري
علم الوراثة الجينية؛ تطوير األجهزة الطبية
صد صة بالر
والعلمية الخاوالعالج المبكر لإلعاقة، صحية
الترويج للعناية الالمدرسية والجامعية قبيل ف التحديد
ب؛ بهداالنتسا
المبكر لإلعاقة الحسية ف
والحركية، توظيصحية
ت الالمؤسسا
ص ت تحديد وتشخي
تقنيات
صاض، فحو
المرالحمل متوافرة اآلن
في أكثر من 96% من ت
البالد مع وجود عياداص،
صص المتخ
للتشخيضع برنامج وطني لمنع
وصرية للفترة
اإلعاقة البالممتدة من العام 2009 حتى العام 2014 وذلك ت مبادرة
ضمن توجهاالرؤية العالمية للعام
ت 2020، عقد مؤتمرا
ت علمية حول التأثيرا
ب، السلبية لزواج األقار
ص المبكر إدخال التشخي
ضمن برنامج متابعة األم والجنين خالل فترة ت
ب جمعياالحمل، تلع
اإلعاقة دورا في برنامج الوقاية ورفع مستوى
ضمان الوعي من خالل
ص مبكر إجراء تشخي
صمم األطفال وتنظيم ل
ت تدريبية حول دورا
ب صحة اإلنجابية للشبا
الذوي اإلعاقة.
ص وتعزيز جودة برامج التشخي
رفع -
ت الرقابة الوطنية بالتنسيق مع كافة آليا
ف المعنية. األطرا
وطنية ص بآلية
مراكز التشخيربط
-الوطني
وبالسجل واإلرشاد
لإلحالة ص المعوقين.
لألشخاص ذوي اإلعاقة
صول األشخا- تعزيز و
صحة اإلنجابية.ت ال
لخدماص ذوي اإلعاقة
صول األشخا- تعزيز و
وزارة /
اإلنجابية صحية
الت
للخدماصحة.
الصحي المدني رقم )10(
نظام التأمين اللسنة 1983:-
صحيا مجانيا.- منح المعوقين تأمينا
185 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(ص المعوقين رقم
حقوق األشخا* قانون
ب 4/ج/التدري
2007 المادة 31 لسنة
المهني والعمل:-ص
ب لألشخاب المهني المناس
1-التدريت
المعوقين وتطوير قدراتهم وفقا الحتياجاب المدربين
سوق العمل بما في ذلك تدريالعاملين في هذا المجال وتأهيلهم.
*المادة 4/د/ الحماية االجتماعية ؛-واالجتماعي
ت التأهيل المهني 3-خدما
ت المساندة بجميع وإعادة التأهيل والخدما
والمشاركة ص الدمج
وبما يخأنواعها
ص المعوقين وأسرهم.الفاعلة لألشخا
ت 6-برامج التأهيل المجتمعي وفق السياسا
س.التي يحددها المجل
*االستراتيجية الوطنية المادة)3( ف:-
األهدااإلعاقة
ذوي ص
األشخاصول
3-حجودة
ت ت ذا
خدماعلى
ف فئاتهم بمختل
عالية في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في ت.
كافة المحافظاوذلك عن طريق
ف رفع جودة ضع معايير وطنية بهد
1-والخدمة المقدمة من برامج التأهيل وإعادة التأهيل وبرامج التأهيل المجتمعي وفق آلية رقابية تنسيقية وطنية تتمثل في لجنة من
ت العالقة. ت ذا
كافة المؤسساوبرامج
ت المساندة كلفة الخدما
2-دعم ب والتعليم
التأهيل وإعادة التأهيل والتدريص األكثر فقرا
ت اإلعاقة لألشخالكافة فئا
وفي المناطق النائية.وإعادة
ت التأهيل خدما
3-زيادة توزيع ت
فئاوالتعليم لكافة
ب والتدري
التأهيل ص في المناطق األكثر فقرا
اإلعاقة وباألخوفي المناطق النائية.
220 الحق ث من القانون
يتناول القسم الثالصحية وإعادة
ت العلى الخدما
صول في الح
ت الدعم )المواد 27 إلى 32 التاهيل وخدما
س بشمولية الطروح الواردة ضمنا(، وهو لي
26 من االتفاقية الدولية. إال أن في المادة
ص ذوي اإلعاقة معظم شروط الدعم لألشخا
بعد تأهيلهم أو إعادة تأهيلهم ملحوظة في مدى الحقوق في المادة 27 من القانون 220 في أي ت
ضافات واإل
ض التعديالحال ، ال بد من بع
صادقة على االتفاقيةعلى هذا القسم عند الم
- القانون 83 للعام 2005، وفي مادته الثالثة ص
ص على أن األشخاين
ذوي اإلعاقة هم شركاء ضع برنامج التأهيل
في ووإعادة التأهيل. والمادة
ص 20 من القانون نفسه تن
ب أن على أن الدولة يج
ت ضيرا
توفر التأهيل وتحما قبل المدرسة بما يتواءم
صة ت الخا
واالحتياجالألطفال ذوي اإلعاقة. والمادة 15 من النظام ت
الذي يحكم مؤسساصة
صالتربية المتخ
ب المهني والتأهيل والتدري
ص ذوي اإلعاقة، لألشخا
مع اإلشارة إلى أنه ت أن
على هذه المؤسساتتبنى مشاريع تتوافق مع
ت كل المستفيدين، احتياجا
كما يمكن ألولياء األمور ضع
أن يشاركوا في وهذه المشاريع وتنفيذها ومتابعتها. والمادة 29 ص على
من اللوائح تنب أن يكون
أنه يجب
موظفو التأهيل والتدريت
مسؤولين عن بناء قدراص ذوي اإلعاقة
األشخاضمن مدى من
وتدريبهم ت من خالل برامج
المجاالب.
ب الطلبحس
33. هل هنالك قانون أو لتعزيز
حكومية سياسة
ت والبرامج الشاملة الخدما
وإعادة المتعلقة بالتأهيل
ذوي ص
التأهيل لألشخااإلعاقة؟
التأهيل وإعادة التأهيل
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 26
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة186ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(المعوقين
ص األشخا
حقوق قانون
*المادة)4(/ج:-
على ص المعوقين
صول األشخاح
-2ف
ص متكافئة في مجال العمل والتوظيفر
ت العلمية.ب والمؤهال
بما يناسص
ت القطاع العام والخا3- إلزام مؤسسا
ال يقل عدد العاملين في ت التي
والشركاأي منها عن 25 عامال وال يزيد عن 50 ص
عامال في تشغيل عامل واحد لألشخاعدد العاملين في أي
المعوقين وإذا زاد ص ما ال تقل
صمنها على 50 عامال تخ
عدد العاملين فيها من
%4عن
نسبته شريطة أال تسمح
ص المعوقين لألشخا
طبيعة العمل في المؤسسة بذلك.جهة
من قبل ت المعقولة
4- التجهيزاالعمل.
المعوقين ص
األشخاحقوق
قانون *
رقم31 لسنة 2007 المادة )12( على كل مؤسسة في القطاع
ب أ- يترت
ت امتناعها عن تنفيذ أحكام بندص ثب
الخا
بحقوق المتعلق
220القانون
ضمن يت
صا بالحق في ص ذوي اإلعاقة بابا خا
األشخاص
صيب العمل بتخ
وهو يلزم أرباالعمل،
ص العمل 3 بالمئة من فر
»كوتا« نسبتها ص ذوي
ص لألشخافي القطاعين العام والخا
اإلعاقة، لكن الجدير بالذكر هنا أن هذا البند، غير مطبق.
شأن معظم بنود القانون، شأنه
220 في بابه الثامن إلى عمد القانون
وقد ص الواردة في قانون العمل
صوإلغاء جميع الن
سالمة البنية لدخول اللبناني التي تشترط
.)69مالك الدولة )المادة
ص إلى األشخا
سوق العمل ضع معايير الدخول إلى
كما وضافة
ت الكفاءة فقط. باإلصرها بامتحانا
وحض الحوافز
ص القانون بعص
خذلك
إلى ص
ف األشخاب العمل على توظي
لتشجيع أرباض
ذوي اإلعاقة، وفي المقابل حدد القانون بعضد الذين ال يلتزمون أو يتهربون
ت العقوبا
ص ذوي اإلعاقة )المواد ف األشخا
من توظيصة
ت الخا70، 72 إلى 75(. ومن السياسا
القانون 83 للعام 2005 ص ذوي
يكفل لألشخااإلعاقة الحق بالعمل. ص على
المادة 26 تنأنه ال يجوز أن يحرم
أي مواطن لديه الكفاءة ف
المناسبة من التوظيضمن القطاع العام أو
س ص على أسا
الخااإلعاقة، مع العلم أن ب أن تدعم
الدولة يجف هؤالء
وتروج لتوظيص. والمادة
األشخاص على أنه ال
27 تنب
ب حرمان أي طاليج
وظيفة من حقه بالمقابلة واالمتحان ألية وظيفة في
القطاع العام على خلفية أن لديه إعاقة. المواد
،35-28
ضمن القوانين 34. هل ت
الحكومية ت
السياساأو
ص ذوي أن يكون لألشخا
صول اإلعاقة إمكانية الح
قدم على
العمل على
المساواة مع اآلخرين؟
فالعمل والتوظي
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 27
187 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
)3( من الفقرة )ج( من المادة )4( من هذا صل مقدارها
القانون دفع غرامة مالية ال يف األجرة الشهرية للحد األدنى
ضععن
عليها ب
ص المعوقين المترتلعدد األشخا
حال تكرار وفي
خالل السنة تشغيلهم
ف الغرامة.ضاع
المخالفة تص عليها في
صوت المن
ب- تؤول الغراماس.
الفقرة )أ( من هذه المادة للمجل8 لسنة
رقم * قانون العمل األردني
1173/ الجريدة الرسمية صفحة
/1996المادة
...1996/4/16تاريخ
4113-:)13(
ب العمل الذي يستخدم عامال صاح
- على عمله باستخدام
طبيعة وتسمح
أو أكثر العمال المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا ت ومعاهد التأهيل
بواسطة برامج وتدريباالمهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة أو ت الرسمية أو
أنشأتها بالتعاون مع المؤسساصة أن يستخدم من أولئك العمال عددا
الخاال يقل عن 2% من مجموع العمالة وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يعدد فيه األعمال التي يشغلها المعوقين التي تم تأهيلهم مهنيا
وأجر كل منهم.المادة)3(
الوطنية *االستراتيجية
ف:-األهدا
ص ذوي اإلعاقة حق األشخا
6-تعزيز صة مهنية
على فرصول
في العمل والحمتكافئة أسوة بأقرانهم من غير المعوقين.
ف، مرسوم البطالة بالحق في العمل والتوظي
من ض للمسرحين
ضي بدفع تعويالذي يق
ص ذوي اإلعاقة، لكن أعمالهم من األشخا
ف عديدة. وفي ضع
المرسوم يشكو من نقاط ب أحكام هذا القسم )المواد 77 إلى 82(
صلضمان
من أحكام قانون الت للعديد
تعديالص
ضد األشخات تميز
االجتماعي التي كانذوي اإلعاقة.
ف ضع الشروط لتوظي
تص ذوي اإلعاقة
األشخافي القطاعين العام
ص والمشاريع والخا
صغرى، وتحدد ال
ت الممنوحة في هذا الميزا
المجال. وللمرة األولى، يقدم القانون نسبة مئوية
ص ذوي ف األشخا
لتوظياإلعاقة في القطاع العام: ص على أن
المادة 29 تنص األولوية
لهؤالء األشخافي 1% من المواقع
صة الوظيفية السنوية الخابالقطاع العام. المادة
ص على أن %1 30 تن
ف على األقل من وظائ
ت التي يزيد عدد الشركا
ب موظفيها على المائة، يجص
ص لألشخاص
أن يخذوي اإلعاقة. المادة 31 ض، وللمرة األولى،
تعرف،
ألشكال بديلة للتوظيف
عندما يكون التوظيالمباشر متعذرا. وهذه
ضمن: إمكانية البدائل تت
ص ذوي السماح لألشخا
اإلعاقة بالعمل بعيدا عن
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة188ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وذلك عن طريق:ص
* تفعيل االلتزام بقانون حقوق األشخااإلشكالية
حل طريق
عن المعوقين
صدار األنظمة ت وإ
القانونية بين التشريعاالالزمة لذلك.
ص * دعم إيجاد برامج تدريبية لألشخا
ت سوق ذوي اإلعاقة متساوية مع احتياجا
ب العمل في ذلك.صحا
العمل وإشراك أب النسبة
حس* تشغيل فئة ذوي اإلعاقة
طريق إقناع عن
المقررة في القانون ب العمل وتهيئة البيئة المناسبة لهم
صحاأ
ضاياهم.ومتابعة ق
ص شاملة لألشخا
ت - إعداد قاعدة بيانا
ذوي اإلعاقة الراغبين في االلتحاق بسوق العمل.
بالقطاع صة
ت الخاتعديل التشريعا
-حقوق
صادي بما يتالءم مع قانون االقت
ص المعوقين رقم 31 لسنة 2007. األشخا
ص ذوي اإلعاقة في ص األشخا
- زيادة فرض
ض إنتاجية )اإلقراصول على قرو
الحصندوق التنمية والتشغيل(.
الزراعي – ذوي
ص -المساهمة في تأهيل األشخا
اإلعاقة لسوق العمل.
موقع العمل، أو إمكانية السماح لهم بالعمل من
خالل عقود فرعية. شراء ص
صنعها األشخات
منتجاذوو اإلعاقة أنفسهم،
ت صنع
ت وشراء منتجا
ت في مراكز تابعة لجمعيا
تتعلق باإلعاقة.
189 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
صة المعايير الدولية واإلقليمية الخا
بحقوق اإلنسان )الميثاق/المادة( )1(ص رقم 31 لسنة
* قانون حقوق األشخا2007 المادة رقم )3(:-
ت المعقولة لتمكين و- توفير التجهيزا
ص المعوق من التمتع بحق أو حرية الشخ
خدمة ما / أو لتمكينه من االستفادة من
معينة.المادة )4(/د:-
ص المعوقين من ت سرية لألشخا
5- معوناألحكام
على اإلنتاج وفقا غير المقتدرين
صندوق المعونة الوطنية النافذ قانون
المفعول.ت:-
المادة )4( و/ اإلعفاءاص
إعفاء واسطة نقل واحدة الستخدام الشخالمعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية ت ورسوم
على المبيعاضريبة العامة
والت وأي رسوم أخرى.
طوابع الواردا
220 المتعلق بحقوق ال يتطرق القانون
الحق هذا
إلى اإلعاقة
ذوي ص
األشخات التي يقدمها
بالتحديد، لكن مجموع الخدماوالحق
العمل؛ في
الحق مثل:
القانون، والحق في
صحة؛ والحق في ال
في التعلم؛ ضمن
ت تطبق
بيئة مؤهلة إلى آخره، إذا ما صول
ص ذوي اإلعاقة الحق في الحلألشخا
ش الكريم.على حد معقول من العي
ف إلى ذلك عدم إلزامية االتفاقية في لبنان ض
أضمن
صديق عليها. يتب عدم الت
بسب
ت الدولة التونسية حق كفل
ص ذوي اإلعاقة األشخا
بمستوى معيشي الئق وحماية اجتماعية وذلك من خالل تبني مبادئ المعاملة الحرة التي تم
ضعها في القانون 83 و
للعام 2005، والمادتين 14 و15 المتعلقتين
ب وإعادة التأهيل. بالتدري
ضافة إلى ذلك، فإن وباإل
صناعية تقدم ف ال
األطرابشكل مجاني ومن دون
أية تكلفة. وبما يتوافق مع القانون المذكور أعاله،ت
س التقديماوعلى أسا
ت األساسية لتغطية الحاجا
ص ذوي اإلعاقة لألشخا
المحتاجين، فإن أكثر من 23000 منحة قد ص
تم تقديمها ألشخاكهؤالء يعيشون في
صل ما منازلهم، من أ
مجموعه 132000 ت
صة للعائالص
منحة مخالفقيرة.
35. هل هنالك قانون أو ضمن
تحكومية
سياسة ص
األشخاصل
يحأن
ذوو اإلعاقة على مستوى مقبول من المعيشة؟
والحماية للحياة
المقبول المستوى
االجتماعية
ص ذوي اإلعاقة، اتفاقية حقوق األشخا
المادة 28
شديدي اإلعاقة من ص
2-إعفاء األشخاصريح العمل لعامل واحد غير
دفع رسوم تف خدمتهم في منازلهم.
أردني بهد* االستراتيجية الوطنية المادة )3(:-
ت المؤسسية 7- تحسين مستوى الخدما
ص ذوي اإلعاقة بما يحقق المقدمة لألشخا
وتمكين األسرة واالستقاللية
مبدأ الدمج خالل بناء
صحيا من اجتماعيا ونفسيا و
صول إلى مجتمع أمن ت األسرة للو
قدراص ذوي اإلعاقة.
دامج لألشخاص ذوي اإلعاقة في
- تقديم الدعم لألشخات وغيره.
مجال السكن واإلعفاءاص ذوي اإلعاقة في تأمين
- دعم األشخاحقهم في السكن.
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة190ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ت - تقديم المعونة المالية المناسبة الحتياجا
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
ت العالقة ت ذا
- تعديل حزمة من التشريعاباألمن االجتماعي.
ت األكثر تهميشا.- تقديم الدعم للفئا
صندوق المعونة الوطنية رقم 36 * قانون
لسنة 1986.ألسر
المتكررة ت
المعونات
تعليما -
المعوقين رقم )1( لسنة 2009:ضه
المادة )3(: للمدير العام أو من يفوالمعوقين
ألسر متكررة
مالية معونة
لمواجهة وذلك
طبية تقارير
ب بموج
إعالتهم على
المترتبة المالية
األعباء عن
ورعايتهم أو تلك األعباء الناجمة صة التابعة
إلحاقهم بمراكز التربية الخاغير
صة المخت
ت والمؤسسا
ت للهيئا
ت المبينة صيال
ب التفالحكومية وذلك حس
ت التالية:في الجدول المبين تاليا في الحاال
ف العقلي الشديد.أ- التخل
ب إلعاقة.صاح
ب- الشلل الدماغي المت.
ج- تعدد اإلعاقاد- اإلعاقة الحركية المعقدة التي ال يستطيع
معها خدمة نفسه.ال
والنفسي الذي ض العقلي
هـ- المريستطيع معه خدمة نفسه.
191 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص حقوق األشخا
* قانون لسنة
31رقم
المعوقين 2007 / المادة )4(/ز/الحياة
العامة والسياسيةص المعوقين
1-حق األشخاالترشيح
ممارسة في
ت المجاال
في ب
واالنتخاأماكن
وتهيئة المختلفة
وسهلة مناسبة
ومرافق من
تمكنهم االستعمال
ت صوي
التحق
ممارسة في
السري باالقتراع
ت.االنتخابا
2-البيئة المناسبة للمشاركة جميع
في فاعلة
صورة ب
الشؤون العامة دون تحيز بما في ذلك المشاركة في غير
ت والهيئا
ت المنظما
الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية.
*االستراتيجية الوطنية المادة ف:-
)3( األهداص
9-توسيع مشاركة األشخاودمجهم في
ذوي اإلعاقة الحياة العامة بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية الترفيه
وأنشطة والثقافية
ضية.الريا
ص ذوي اإلعاقة في المشاركة يلحظ القانون 220 حق األشخا
على قدم المساواة مع اآلخرين. في الحياة السياسية والعامة
حق »من
وهو يشير إلى الحياة العامة تلميحا في المادة 33 صول
صول إلى أي مكان يستطيع الوص معوق الو
شخكل
ت صفا
شرط أن تكون المواغير المعوق«
ص اليه الشخ
صة ت والمرافق العامة والخا
الهندسية لجميع المباني والمنشآالمعدة لالستعمال العام ، منطبقة مع المعايير، ووفق الشروط صراحة
ص عليها في هذا القانون . وهو يشير صو
صول المنواأل
صة صول خا
إلى المشاركة في الحياة السياسية في المادة 98 ، )أت
ص: » تؤخذ بعين االعتبار حاجات االنتخابية(، التي تن
بالعمليات االنتخابية من
عند تنظيم كافة العملياص المعوقين
األشخات بمرسوم يتخذ في
صدر تلك اإلجراءانيابية وبلدية وغيرها وت
س الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة مجل
صد ضح أن المشرع يق
وزارة الشؤون االجتماعية«. الوات واعتماد االقتراع
صويت الت
في هذه المادة تسهيل إجراءاص من
ص أو أشخاصة، ووجود شخ
السري، وتوفير المواد الخاض
ت. ولم يعترصوي
ت التاختيار المعوقين للمساعدة في عمليا
ب ص
ت للمناالمشرع على ترشيح المعوقين أنفسهم في االنتخابا
س ضاء مجل
صدور القانون كان أحد أعالمختلفة، وحتى قبل
علما أنه لم يدخل الندوة صرية،
ب من ذوي اإلعاقة البالنوا
البرلمانية باعتباره معوقا ، وإنما لكونه من البارزين في الطبقة ص
ب عدد من األشخاف لبنان انتخا
السياسية اللبنانية. كما عرس المحلية والبلدية، األمر الذي
ضوية المجالذوي اإلعاقة لع
ف لبنان في العام 2005 ت محلية. كما عر
يتكرر مع كل انتخابات النيابية، مع طرح برنامج
ترشيح 3 معوقين أنفسهم لالنتخاباتفعيل حقوق المعوقين، ورعاية حقوق اإلنسان وربطها بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة. واستطاع 1 واحد منهم على األقل ف
أن يكمل ترشيحه، ويدخل في قائمة منافسة لقائمة االئتالالحكومي، ولم يحالفه الحظ هو وجميع أفراد الالئحة، علما أنهم
ت الناخبين. صوا
صلوا في المعدل على حوالي 46% من أح
وفي سبيل أن كل المواطنين يتمتعون
السواء على
التي األساسية
بالحقوق صا
صويكفلها الدستور، وخ
في المشاركة
في الحق
والعامة، السياسية
الحياة ،2005
83 للعام فالقانون
ص ين
األولى مادته
وفي ص لهؤالء
على تساوي الفرص.
األشخامن
وغيرهم يكفل
التونسي فالتشريع
اإلعاقة ذوي
ص لألشخا
في بالمشاركة
الحق كمرشحين
الحياة السياسية ال
فاإلعاقة ومقترعين:
طريق عثرة في
حجر تعد
ال الحق،
هذا ممارسة
قبل النظام االنتخابي من
ناحية من
وال التونسي
الدستور. والتشريع التونسي ص ذوي
ضا، يمنح األشخاأي
حرية االنتماء إلى اإلعاقة
ب السياسية، والتعبير األحزا
نظرهم، ت
وجهاعن
ت وتشكيل الجمعيا
وتنظيم بما يتطابق مع بنود القانون 154 للعام 1959، المتعلق ت، الذي تم تعديله
بالجمعياواستكماله من خالل القانون 2 نيسان/
صادر في 25 ال
أبريل من العام 1992.
ضمن القوانين 36. هل ت
الحكومية ت
والسياساص
األشخايتمكن
أن من
اإلعاقة ذوو
في الكاملة
المشاركة الحياة السياسية والعامة مع
على قدم المساواة اآلخرين؟
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 29
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة192ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص حقوق األشخا
* قانون لسنة
31رقم
المعوقين 4/ح/
2007/المادة والثقافة
ضة الريا
والترويح:-ضية
ت الريا1-إنشاء الهيئا
ف فتح والثقافية ودعمها بهد
ص المعوقين المجال لألشخا
ممارسة أنشطتم المختلفة ويطور
حاجاتهم بما يلبي قدراتهم.
2-دعم مشاركة المتميزين المعوقين
ص األشخا
من ضيا وثقافيا في األنشطة
رياالوطنية
ت والمؤتمراوالدولية.
ص ذوي اإلعاقة في ضمنا مشاركة األشخا
يشترط المشرع ص المعوق ببيئة
ضمانه حق الشخالحياة االجتماعية من خالل
مؤهلة، في القسم الرابع من القانون 220 )المواد 33 إلى 43( ضمني
ضح التركيز الث مدى الحقوق في المادة 33 يت
وفي بحص غير المعوقين في ارتياد كل
على مجاراة المعوق لألشخاأجزاء البيئة العمرانية لممارسة حياة اجتماعية وثقافية ناشطة. ص معوق الحق ببيئة
ص المادة 33 على ما يلي: »لكل شخوتن
صول إلى أي ص معوق الو
مؤهلة، بمعنى أن من حق كل شخص غير المعوق. على كافة
صول إليه الشخمكان يستطيع الو
صة المعدة لالستعمال ت والمرافق العامة والخا
األبنية والمنشآمع المعايير
منطبقة صفاتها الهندسية
مواالعام، أن تكون
ص عليها في هذا القانون«. صو
صول المنووفق الشروط واأل
ت والمرافق العامة ب تأهيل األبنية والمنشآ
ويتناول القانون وجو»تؤهل األبنية والدوائر الرسمية
ص: 36 التي تن
في المادة واألماكن األثرية
والحدائق العامة ت
والطرقاصفة
واألروالسياحية وغيرها.....« وكذلك في المادة 37 المتعلقة باألبنية ب تأهيلها وفقا
صة المعدة لالستعمال العام الواجت الخا
والمنشآص عليها القانون. إال أن القانون ال يتناول
لمعايير محددة ينصراحة أشكال الحياة الثقافية واالجتماعية التي ترد في المادة ت
30 من االتفاقية الدولية، التي يعد قسم منها جزءا من الحرياالسياسية والثقافية واالجتماعية األساسية للمواطنين كافة.
ضا يوفر التشريع التونسي أي
ت الدعم والتشجيع والتسهيالص ذوي
لتمكين األشخااإلعاقة من االنخراط في
ت كهذه: القانون 83 نشاطا
للعام 2005، وفي المادة ص على أنه يمكن
37 ينص ذوي اإلعاقة
لألشخاف والمواقع
دخول المتاحب
التاريخية والمالعضية وأماكن التسلية،
الريامجانا ومن دون أية كلفة.
37. هل هنالك قانون أو ضمن
تحكومية
سياسة ص
األشخامشاركة
ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية والثقافية؟
المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 30
193 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص قانون حقوق األشخا
المعوقين رقم 31 لسنة ضة
2007/المادة4/ح/الرياوالثقافة والترويح؛-
2- دعم مشاركة المتميزين ص المعوقين
من األشخاضيا وثقافيا في األنشطة
ريات الوطنية
والمؤتمراوالدولية.
3-إدخال البرامج واألنشطة ضية والترويحية والثقافية
الريات
ضمن برامج المؤسساس العاملة
والمراكز والمدارفي مجال اإلعاقة وتوفير
صة ص
الكوادر المتخت المعقولة بذلك.
والتجهيزات
4-استخدام المكتباوالحدائق العامة والمرافق ص
ضية أمام األشخاالريا
ت المعوقين وتوفير التجهيزا
المعقولة.* االستراتيجية الوطنية / ضة
المحور التاسع: الرياوالترفيه والثقافة والحياة
العامة:-ب العبين
- دعم استقطاضة
ب جديدة لرياجدد وألعا
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
ص - توسيع مشاركة األشخا
ذوي اإلعاقة ودمجهم في ضية.
الحياة الريا
في قانون 220صة بالمعوقين :
ضة الخا المادة 66: الريا
ضة إنشاء ب والريا
أ – »تدعم وزارة التربية الوطنية والشباصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها ماديا
ضية خافرق ريا
ت المحلية والعربية ومعنويا للمشاركة في كافة المباريا
والعالمية .ت الالزمة كي يتمكن المعوقون التابعون
ب – تتخذ اإلجراءاضية
ت تربوية وتعليمية عادية ممارسة تمارين ريالمؤسسا
ضة في هذه صة للريا
صت المخ
تالئمهم ، أثناء الفترات .
المؤسساضة
صين : رياص
ضة المعوقين بشقيها المتخج – تدخل ريا
ب صل
ضة المعوقين حركيا وحسيا في المعوقين عقليا وريا
صة«ص
البرامج التعليمية المتخصة بالمعوقين :
ضة الخا المادة 67 : دعم وتنظيم الريا
س الوزراء لجنة مشتركة أ – »تشكل بمرسوم يتخذ في مجل
صة والعامة ت الخا
ت والهيئات والمؤسسا
بين كافة اإلداراضة المعوقين ، تدعى
المعنية بشؤون رياضة المعوقين « وتكون برئاسة مدير
صة برياص
»اللجنة المتخضة .
ب والريا عام الشبا
ضع هذه اللجنة النظام الداخلي الجتماعاتها . ت
ب– تتولى هذه اللجنة المهام آالتية :
ضة كافة التي ب الريا
1ـ النظر في جميع المعايير لأللعاص المعوقون .
يمارسها األشخاب
صميم وتأهيل المالعت والمساعدة في ت
2ـ تقديم االستشاراضة المعوقين .
صة بريا الخا
صة بالمعوقين. ضية الخا
ت الريات واالتحادا
3ـ تنظيم المبارياضة
صة برياف؛ عدم تشكيل اللجنة الخا
المالحظ مع األسضة
ب والرياض أن يعينها وزير الشبا
المعوقين التي من المفترضم ممثال عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
وت
ال يوجد38. هل هنالك قانون
أو سياسة حكومية تمكن ص ذوي اإلعاقة
األشخامن المشاركة في األنشطة
ضية لالستجمام الريا
والترفيه على قدم المساواة مع اآلخرين؟
ضية المشاركة في األنشطة الريا
لالستجمام والمتعة
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 30,5
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة194ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
*االستراتيجية الوطنية المادة )2( المبادئ:- 7-التأكيد من أن كافة
ت والخطط السياسا
والبرامج تراعي الجذرية والمساواة بين الرجل
والمرأة انطالقا من أن ت اإلعاقة هي
المرأة ذات
األكثر تهميشا بين فئاص ذوي اإلعاقة
األشخاض إلى تمييز
وتتعرمزدوج.
* االستراتيجية الوطنية ف:-
المادة )3( األهدا11-الحد من ومواجهة
ت التي قد كافة الممارسا
ف واإلساءة تلحق العن
ص واالستغالل باألشخا
ذوي اإلعاقة وتقليل نسبها وفق خطط منهجية محكمة.ص
* قانون حقوق األشخاالمعوقين رقم 31 لسنة
2007 / المادة )3(:-ج-المساواة بين الرجل
والمرأة المعوقين في ت.
الحقوق والواجبا
ب وال ال من قري
س هناك أي قانون يتطرق إلى اإلعاقة لي
ت اإلعاقة من بعيد. والقانون 220 ال يتطرق إلى النساء ذوا
ضدهن، لكنه يكتفي بالتطرق صياتهن وال إلى التمييز
صووخ
عام دون أية إشارة إلى ص ذوي اإلعاقة بشكل
إلى األشخات اإلعاقة بالتحديد.
النساء ذوا
صادر في 74، ال
القانون 12 تموز/ يوليو من العام 1993، الذي عدل واستكمل األحوال
نظام خالل
من للنساء
ليسمح صية،
الشخبالمشاركة في تولي األمور المتعلقة بأطفالهن، يعد خطوة س في الطريق
أخرى لتونالجنسانية
المساواة نحو
ف كافة أنواع التمييز واجتفا
ضمن هذا ضد المرأة. كما ي
ت، بما القانون للنساء المطلقا
ت اإلعاقة، فيهن النساء ذوا
من مالية
الحق بتلقي نفقة عدم قدرة
حالة الدولة في
الطليق تأمين مستوى معيشي مقبول. وقد كان القانون 46، 29 أيار/ مايو
صادر في ال
من العام 1981، أول قانون ص
صل يشرع تقدم األشخامف
ذوي اإلعاقة وحمايتهم. وقد تم تعديله واستكماله بالقانون 14 آذار/
صادر في 52، ال
س من العام 1989.مار
قانون هنالك
هل .39
حكومية يقر سياسة
أو ت
والفتياالنساء
بأن ضن
يتعرت اإلعاقة
ذواللعديد من أشكال التمييز، حقوقهن
ويسعى لحماية وحرياتهن؟
ت اإلعاقةالنساء ذوا
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 6
195 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
ير المعاياإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
)1(ص
حقوق األشخا* قانون
لسنة 31
رقم المعوقين
2007 / المادة )3(:-حقوق األطفال
ضمان هـ-
قدراتهم وبناء
المعوقين وتعزيز
مهاراتهم وتنمية
دمجهم في المجتمع.*المادة )4( / د:-
المعوق الطفل
دمج -1
داخل التأهيلية
ورعايته أسرته وفي حال تعذر ذلك تقدم له الرعاية التأهيلية
البديلة.
صراحة . ال يتناول القانون 220 حق األطفال ذوي اإلعاقة ب
ص بالحق في التعليم، وال سيما المادة 60 لكنه في قسمه الخا
س ، يتيح لهم حرية اختيار ب الخام
صها في الجواالتي يرد ن
ضمن المواد ص
س التي يريدون االلتحاق بها . وهو يحرالمدار
ب ) المواد: ضرائ
ضمان االجتماعي والالتي تتناول شؤون ال
77، 78 ، 80، 81، 82( على مراعاة حقوق هؤالء األطفال . ب إلى الحد الذي بلغته المادة السابعة من االتفاقية
لكنه قد ال يذهالدولية.
للعام 83
القانون كان
جوهرية خطوة
،2005الحقوق
تطبيق باتجاه
ذوي لألطفال
الممنوحة اإلعاقة من قبل القانون في ت األساسية،
عدد من المجاالبما يشمل الوقاية من اإلعاقة ب.
صحة والتعليم والتدريوال
40. هل تعمل القوانين أو على
ت الحكومية السياسا
ت المناسبة اتخاذ اإلجراءا
األطفال حقوق
لحماية وحرياتهم بشكل متساو مع
األطفال اآلخرين؟
األطفال ذوو اإلعاقة
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 7
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة196ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
)1(
ص المعوقين * قانون حقوق األشخا
رقم 31 لسنة 2007 / المادة )3(:-ث العلمي وتعزيزه
ط- تشجيع البحت في مجال
وتبادل المعلومات
ت والمعلومااإلعاقة وجمع البيانا
صة باإلعاقة التي ت الخا
صاءاواإلح
ب ما يستجد في هذا المجال.تواك
ص المعوقين * قانون حقوق األشخا
المادة )7(:-ط- إيجاد مراكز وطنية ريادية
ت ث والدراسا
ب وإجراء البحوللتدري
ت المتعلقة بشؤون وإنشاء قواعد البيانا
ص المعوقين.األشخا
ص ذي صول الشخ
بما أن القانون يشترط حصية لكي
على بطاقة المعوق الشخاإلعاقة
صاء ضمن الفئة ، فإن عملية اإلح
صنيفه يتم ت
ت تكون مؤمنة باستمرار ، علما وجمع البيانا
ص ذي اإلعاقة تجديد بطاقته كل أن على الشخ
5 أعوام. فإذا لم تكن إعاقته دائمة ، فإن من صار إلى تجديد هذه البطاقة. لقد
المتوقع أال يصاء بالتسجيل،
اختار لبنان العمل بسياسة اإلحوبناء على أحكام القانون 2000/220 وعلى ت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين،
قراراصية للذين ينطبق
تعطى بطاقة المعوق الشخف اإلعاقة الوارد في المادة 2 من
عليهم تعريالقانون. وحتى اليوم يبلغ مجموع حملة بطاقة 75000 الفا ،
صية في لبنان المعوق الشخ
يشكل ذوو اإلعاقة الحركية حوالي 50% منهم، ال
30%، بينما وذوو اإلعاقة العقلية/الذهنية
صرية ت الحسية من ب
تزيد نسبة ذوي اإلعاقات المتاحة من
وسمعية على 20%، وفق البياناصلحة شؤون
برنامج تأمين حقوق المعوقين وموزارة الشؤون االجتماعية.
في المعوقين
ف تؤدي إلى سو
ضح أن هذه السياسة والوا
صية كلما ازدياد عدد حملة بطاقة المعوق الشخ
صورة صار إلى تطبيق القانون واحترامه ب
أوسع وأكبر.
ال يوجد41. هل هنالك قانون أو ب
حكومية تتطلسياسة
ت صاءا
اإلحإعداد
ت البحثية وجمع البيانا
صة ضايا الخا
حول القباإلعاقة؟
تت وجمع البيانا
صاءااإلح
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 31
197 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
)1(ص المعوقين
* قانون حقوق األشخارقم 31 لسنة 2007 المادة )7( :-
و- المشاركة في الجهود الرامية إلى ت
ف المواثيق واالتفاقياتحقيق أهدا
ص الدولية المتعلقة بشؤون األشخا
ت عليها المملكة.صادق
المعوقين التي ت
ت والجهاح- التعاون مع المؤسسا
ت العالقة الوطنية واإلقليمية والدولية ذا
س.ف المجل
بأهدا*المركز الوطني لحقوق اإلنسان 51
لسنة 2006 المادة )4(:-ضمام المملكة إلى
ج- السعي النت العربية والدولية
المواثيق واالتفاقياصة بحقوق اإلنسان.
الخا* االستراتيجية الوطنية المادة)3(
ف:- األهدا
ت الوطنية من 1- تفعيل التشريعا
ت خالل التوعية وتعديل التشريعا
ت صدار األنظمة والتعليما
القائمة وإالالزمة لها بما يتالءم مع المعايير
ص ذوي صة بحقوق األشخا
الدولية الخااإلعاقة.
على اتفاقية صادقة
س من الدول الملبنان لي
ث ص ذوي اإلعاقة، لذلك ال يمكن الحدي
األشخاصال في المادة 32
ب الوارد أعن هذا الجان
عالقاته من منها. إال أن لبنان يستفيد في
برامج المعونة االجتماعية ، التي قد تتناول ضايا اإلعاقة وحقوق ذويها. من ذلك
أحيانا قمثال؛ أن وزارة الشؤون االجتماعية باالتفاق ت اإلفادة من منحة
حاولمع وزارة التربية
للدمج نموذجية
برامج صميم
لتإيطالية
ث يجري حاليا عن االستفادة التربوي . والحدي
ض جديدة تتناول بع
مساعدة أوروبية من
ب المسألة التربوية والدمج اإلجتماعي جوان
ضح أن برنامج ص ذوي اإلعاقة. والوا
لألشخات
ص المعوقين قد أثبتأمين الحقوق لألشخا
ض نجاحه العملي والميداني، ما قد يدعو بع
الدول الشقيقة إلى محاكاة تجربته.
ص ذوي ت األشخا
س أشركتون
ت الممثلة لهم في اإلعاقة والجمعيا
البرامج المتنوعة للتعاون الدولي. ت
وقد تم توقيع عدد من االتفاقيات إقليمية من هذا النوع،
مع منظمات
مثل: االتحاد األوروبي؛ ومنظمامعينة تابعة للجامعة العربية.
ت المتنوعة لبرامج ف المكونا
وتهدالتعاون الدولي إلى دعم عملية
ص ذوو اإلعاقة تقدم األشخا
ت الحياة ودمجهم في نشاطا
س اليومية، وذلك من خالل التأسي
ب وإعادة ضمن التدري
لمشاريع تتضمن برامج
التأهيل والدمج. وص
التعاون الدولي، يشترك األشخاذوو اإلعاقة في برامج التبادل مع
الشركاء، ويستفيدون من برامج ت. وفي
ب وتبادل الخبراالتدري
ضمن برنامج العام 2010، و
س وإيطاليا، التعاون بين تون
س تدريبية حول تم إعطاء درو
س المشاريع وإدارتها. وحاليا، تأسي
ص تستخدم اتفاقية حقوق األشخا
صفها أساسا ذوي اإلعاقة، بو
ت تعاون متنوعة لبروتوكوال
صوال إلى المادة تتعلق باإلعاقة، و
دة 32، وقد تم الدمج مع مسوالبروتوكول المتعلق ببرنامج
س وإيطاليا لألعوام من تعاون تون
.2011-2009
ث الحكومة 42. هل تبح
عن التعاون الدولي الذي يدعم جهودها ضمان الحقوق
في صادية واالجتماعية
االقتص
والثقافية لألشخاذوي اإلعاقة؟
التعاون الدولي
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 32، 4،2
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة198ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة( )1(
ص المعوقين رقم * قانون حقوق األشخا
31 لسنة 2007 المادة )7(:-و- المشاركة في الجهود الرامية إلى ت
واالتفاقياالمواثيق
ف أهدا
تحقيق ص
األشخابشؤون
المتعلقة الدولية
ت عليها المملكة.صادق
المعوقين التي ص ذوي
* االستراتيجية الوطنية لألشخااإلعاقة.
–خطط العمل للمرحلة الثانية 2010
2015ت.
* المحور األول – التشريعاصد تنفيذ بنود االتفاقية الدولية
ر -
ص المعوقين، حقوق األشخا
وقانون والشركاء
األعلى س
المجلوتنفيذ
ت المجتمع المدني .ومؤسسا
صادق بعد على االتفاقية ، فإن بما أن لبنان لم ي
ث عن هذا األمر سابق ألوانه من منظور الحدي
ص على االتفاقية نفسها . إال أن القانون 220 ين
تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي ص تأمين
صويناط بها رسم سياسة الدولة بخ
ص ذوي اإلعاقة، والعمل على حقوق األشخا
ت تطبيق أحكام القانون ومراقبة هذه العمليا
صة، ص
عن طريق المشاركة في اللجان المتخوتلقي الشكاوى الفردية والجماعية، ومتابعة ضايا المتعلقة بتطبيق القانون، وجعله من
القت
وإدارات العامة للحكومة
س السياساأسا
الدولة.
ضع آلية مستقلة وبالنسبة لو
للترويج ودعم تطبيق االتفاقية صدها ،
الدولية وحمايتها ورس األعلى لحقوق اإلنسان
فالمجلت األساسية قد وافق على
والحرياضمن إمكانياته،
تولي هذا الدور صا
صصفه جهازا مستقال متخ
بوبالحقوق.
ت الحكومة 43. هل عمل
على على إنشاء آلية
من الوطني
المستوى تطبيق
مراقبة أجل
ص اتفاقية حقوق األشخا
ذوي اإلعاقة؟
التطبيق والمراقبة على المستوى الوطني
199 دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقةومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ت انتهاك وحاال
متابعة الشكاوي د-
ت فيها وإعالم حقوق اإلنسان لحين الب
ت ب العالقة بما انته
صاحالمشتكي أو
ضمينها في التقرير إليه، وتوزيعها وت
السنوي للمركز.ف وسائل
هـ- إرشاد المواطنين بمختلصال إلى حقوقهم التي كفلها الدستور
االتوالعهود
والمواثيق والقوانين المرعية
ت الدولية ومساعدتهم في اتخاذ اإلجراءا
صيانة هذه الحقوق في التي من شأنها
عليها بما في ذلك حال وقوع اعتداء
ب العالقة إلى صاح
توعية المشتكي أو سبل الطعن والمراجعة القانونية.
/11رقم
قانون المظالم
ديوان *
المهام )11(
المادة 2008
لسنة ت:-
صالحياوال
1-النظر في الشكاوي المتعلقة بأي من ت
ت أو الممارسات أو اإلجراءا
القراراعن
صادرة أو أفعال االمتناع منها ال
اإلدارة العامة أو موظفيها وال تقبل أي ضد اإلدارة العامة إذا كان مجال
شكوى جهة
الطعن بها قائما قانونا أمام أي ضوعها
ضائية إذا كان موإدارية أو ق
ضائية أو تم جهة ق
منظورا أمام أي ضائي به
صدور حكم ق
دراسة حول وضع السياسات املتعلقة باإلعاقة200ومدى االلتـزام بتنفـيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األردنلبنان
ستون
السؤال)2(
واإلقليمية الدولية
المعايير اإلنسان
بحقوق صة
الخا)الميثاق/المادة(
)1(2000/220 الهيئة الوطنية
ف القانون يكل
ت سياسا
رسم على
لشؤون المعوقين السهر وبتطبيق
صة بحقوق المعوقين الدولة الخا
أحكام القانون 2000/220 . وهي في عملها ت من ذوي
شكاوى األفراد والجماعاتتلقى
اإلعاقة. كما أنها ملزمة بالمثول أمام الهيئة ث تجري مساءلتها،
العامة مرة في العام، حيضور
ت شفويا أو خطيا إليها بحوتقديم االقتراحا
ت الدولة المعنية بتطبيق أحكام مديري إدارا
ث القانون المختلفة، وال سيما في أقسامه الثال
إلى العاشر. هكذا تكون آلية المراقبة ورسم »التغذية المرتجعة
ت الوطنية تتلقى السياسا
ص ذوي اإلعاقة«. المقدمة من األشخا
وأبعد من المادة الواردة سابقا، صوال إلى النظام رقم 029،
وصادر في 21 تشرين الثاني/
الس
نوفمبر من العام 2005، فتونس األعلى لالهتمام
ت المجلأوجد
ص ذوي اإلعاقة، وليكون باألشخا
جهازا تنسيقيا داخل الدولة، يكون مسؤوال عن تطبيق اتفاقية حقوق
ص ذوي اإلعاقة.األشخا
آلية تشتمل
هل .44
المراقبة الوطنية التي تم إنشاؤها في الدولة على التغذية الراجعة المقدمة ذوي
ص األشخا
من اإلعاقة؟
التطبيق والمراقبة على المستوى الوطني
ص ذوي حقوق األشخا
اتفاقية اإلعاقة، المادة 33












































































































































































































![CSc 553 [0.5cm] Principles of Compilation [0.5cm] 0 ...](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/6240d7bf98c21206554191e4/csc-553-05cm-principles-of-compilation-05cm-0-.jpg)